بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
شعرت الولايات المتحدة في بدايات الثورات العربية وانتفاضات التغيير بالكثير من القلق والارتباك، في ضوء احتمال خسارتها لحلفائها التقليديين، ولاحتمال تغيُّر خريطة المنطقة بما يتعارض مع إستراتيجياتها ومصالحها. غير أنها سعت بسرعة للتكيف مع حالة التغيير وحاولت ركوب الموجة وتوجيهها في مسارات تخدم مصالحها، أو على الأقل تخفف من الأضرار المحتملة قدر الإمكان.
وتتميز السياسة الأميركية بميزتين رئيسيتين:
أ- الدينامية العالية في اتخاذ القرار، وخصوصاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، حيث تتمتع مؤسسة الرئاسة الأميركية بصلاحيات واسعة في ذلك، وتستفيد في عملية صناعة القرار من قدرات هائلة في جمع المعلومات، ومن وجود عشرات من مراكز الدراسات وخزانات التفكير، ومئات المستشارين، ومن مؤسسة وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي… وغيرها.
ب- الإمكانات الأميركية الهائلة، السياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية وحتى العسكرية، التي يمكن توظيفها بما يخدم المصالح الأميركية.
الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط
تتلخص الإستراتيجية الأميركية في الشرق الوسط في:
1- “إسرائيل” هي حَجَر الزاوية في السياسة الأميركية الشرق أوسطية، والحفاظ على أمن “إسرائيل” وهيمنتها كقوة إقليمية هو جوهر السياسة الأميركية.
2- الهيمنة على مناطق البترول في المنطقة لتأمين احتياجات أميركا، وكأداة ضغط أميركية في الإستراتيجية الدولية.
3- دعم الأنظمة السياسية الموالية أو ذات العلاقة الجيدة معها، وإعادة بناء النظم السياسية الأخرى بما يخدم الأهداف والمصالح الأميركية.
4- تأمين خطوط الملاحة وخطوط التجارة الدولية في المنطقة (مضيق هرمز، قناة السويس، باب المندب…) بما يضمن تدفق النفط والبضائع، من المنطقة وإليها، بشكل آمن وبأسعار “معقولة” وبما يخدم الاحتياجات والمتطلبات التجارية والاقتصادية للمنظومة الغربية وشركائها.
5- الاستفراد بالهيمنة على المنطقة، ومنع أية قوة كبرى أخرى من المنافسة على النفوذ فيها.
هذه السياسة الأميركية استعْدَت شعوب المنطقة، بسب دعمها لـ”إسرائيل”، وبسبب دعمها لأنظمة سياسية فاسدة ومستبدة. وهو ما رسخ في عقلية الإنسان العربي أن أميركا تعاني من إشكالية أخلاقية، ومن أزمة في المعايير، ومن عقلية الكيل بمكيالين، ومن تناقض بين ما تقول أنه مُثُلها وقيمها وبين تطبيقاتها المعاكسة لذلك، بشكل مقيت يقف مع القهر والاحتلال والظلم والاستبداد.
السلوك الأميركي.. لا تغيير
بالرغم من الزلزال الهائل الذي شهدته المنطقة العربية خلال سنة 2011، وبالرغم من تأثير ذلك (في المديين المتوسط والبعيد على الأقل) على القضية الفلسطينية، وعلى تغيير معادلة الصراع مع الكيان الإسرائيلي؛ فإن سنة 2011 عكست استمرار السياسة الأميركية الداعمة لـ”إسرائيل”، وتراخِي الضغط باتجاه مسار التسوية، وعدم استشعار حقيقي لضرورة تحقيق اختراق فيما يُسمى “عملية السلام”. وهذا يعني أن الإدارة الأميركية:
– لم تستوعب بعد بشكل جاد، أو لا تريد أن تستوعب، ما تعنيه حركات التغيير ولا جماهيرها.
– أو أنها ما زالت تراهن على حرف عملية التغيير عن مسارها، وإغراقها في همومها القُطرية والمحلية ومشاكلها العرقية والطائفية. – أو أن الموضوع الإسرائيلي ما زال بالنسبة لها في منطقة “التابو” الذي لا يجوز مسُه، لخلفيات دينية وثقافية وسياسية وجيوإستراتيجية. – أو أن النفوذ الصهيوني بلغ حداً يمنع الإدارة الأميركية من رؤية مصالحها وأولوياتها الإستراتيجية في المنطقة.
فقد تابعت أميركا سياساتها الداعمة لـ”إسرائيل”، وكررت مرات عديدة التزامها بأمن “إسرائيل” وتفوقها العسكري، كما تابعت تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية سنوية بنحو ثلاثة مليارات دولار، بالرغم من أن دخل الفرد الإسرائيلي يُعدُّ من أفضل الدخول العالمية، ويصل إلى نحو 29 ألف دولار سنوياً.
وعبَّرت الإدارة الأميركية عن حالة عجز حقيقي فيما يتعلق بالضغط على “إسرائيل”، حتى في تنفيذ قناعاتها المعلنة والمسبقة المتعلقة بضرورة وقف الاستيطان في الضفة الغربية، وتوقفت عن بذل أية جهود في هذا الإطار، بعد أن كانت قد نجحت في تحقيق نجاح جزئي في تجميد الاستيطان بشكل مؤقت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010.
واكتفت الإدارة الأميركية بالتعبير عن أن سياسة “إسرائيل” الاستيطانية “مخيبة للآمال”!! وقد دافع ديفيد هيل (نائب المبعوث الأميركي جورج ميتشيل والذي حلَّ مكانه بعد استقالته) عن سبب عدم الضغط على “إسرائيل” فيما يتعلق بالاستيطان قائلاً إن أميركا “لا تستطيع إجبار حكومة ذات سيادة على فعل شيء”، و”إننا نستطيع استخدام أسلوب الإقناع والمفاوضات والمصالح المشتركة”!! وكأن أميركا لا تمارس كافة أشكال الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على البلدان الأخرى، وكأنها لم تقم باحتلال العراق وأفغانستان، ومارست بشكل مكشوف ضغوطا مباشرة في ليبيا وسوريا وإيران… وغيرها!!
وكان أوباما قد قال إن حركات التغيير في العالم العربي زادت الحاجة إلحاحاً، أكثر من أي وقت مضى، لإحياء جهود التسوية السلمية، غير أن إدارته لم تقم بأية جهود حقيقية لتفعيل مشروع التسوية، وساد الإحباط وسطها من إمكانية إحراز تقدم حقيقي، فقدم جورج ميتشيل استقالته في 13/5/2011، كما قدم دينيس روس استقالته أيضاً، في وقت لاحق، من موقعه كمستشار في مجلس الأمن القومي لشؤون ما يسمى إقليم الوسط (الشرق الأوسط، وغرب آسيا، وجنوب آسيا).
ولم يتغير موقف الولايات المتحدة من التسوية السلمية، ففي خطاب أوباما في 19/5/2011، تحدث عن الرؤية الأميركية لقيام دولتين لشعبين، وأن “إسرائيل” يجب أن تكون دولة يهودية، وأن تكون الأساس الذي تُبنى عليه حدود الدولة الفلسطينية هو حدود 1967، وأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح. غير أن أوباما جعل القضايا الجوهرية كلها قضايا مؤجلة، ودونما سقف زمني لحلها، بما في ذلك مستقبل القدس واللاجئين والمستوطنات… وغيرها.
ولم يتجاوز استشعارُ الإدارة الأميركية للمخاطر المحتملة التي تواجهها “إسرائيل” نتيجة التغيرات في العالم العربي، تحذيرَ وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في 3/10/2011 “إسرائيل” من ازدياد عزلتها، ودعوتها للقيام بخطوات جريئة للخروج من هذه العزلة، ونصحها بإصلاح علاقتها مع تركيا، وتحسين علاقتها بالأردن ومصر.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة ساندت كل مقترحات حماية المدنيين في العالم العربي في مناطق الثورات والانتفاضات، كما في ليبيا وسوريا واليمن؛ إلاّ أنها تابعت رفضها المتكرر لطلبات السلطة الفلسطينية لحماية المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما واصلت اعتراضها على التقارب بين فتح وحماس، ومتطلبات المصالحة الفلسطينية. وتحدث ديفيد فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى مع أبي مازن قائلاً “نحن نتفهم تطلعكم إلى الوحدة، إلا أنكم لن تحصلوا على دولة إذا تشاركتم مع منظمة إرهابية؛ وحماس في نظرنا منظمة إرهابية”.
وكما هو معروف فقد عارضت الولايات المتحدة تقديم القيادة الفلسطينية بطلب “العضوية الكاملة” لفلسطين في الأمم المتحدة، وهددت باستخدام الفيتو في حال تقديمه إلى مجلس الأمن، الذي هو البوابة الوحيدة الممكنة للحصول عل “العضوية الكاملة”. وقد تمكنت الجهود الأميركية من تعطيل الطلب الفلسطيني، الذي لم يحصل ابتداء على الأغلبية الكافية في مجلس الأمن، وما يزال الطلب عالقاً في دهاليز الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض “الفيتو” في 18/2/2011 ضدّ مشروع قرار عربي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويؤكد على حقّ تقرير المصير. وهو الفيتو رقم 43 الذي يستخدمه الأميركان في الشأن الفلسطيني من بين نحو 85 فيتو استخدمتها أميركا طوال تاريخها.
وعلقت الولايات المتحدة دفع نصيبها في موازنة منظمة اليونسكو، لأن اليونسكو قررت قبول دولة فلسطين عضواً فيها في 31/10/2011، كما علَّق مجلس النواب الأميركي في 5/10/2011 تقديم مساعدة بقيمة 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بسبب سعي القيادة الفلسطينية للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، قرر مجلس النواب الأميركي منح أكثر من 200 مليون دولار مساعدة للكيان الإسرائيلي لنشر نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ!! وفوق ذلك، تقدم 42 نائباً جمهورياً أميركياً في 8/9/2011 بمشروع قرار لمجلس النواب الأميركي يدعم ما قالوا إنه “حقّ إسرائيل في ضمّ الضفة الغربية”، في حال إصرار الفلسطينيين على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
السياسة الأميركية المحتملة خلال سنة 2012
حاولت الإدارة الأميركية أن تفصل ما بين التغيرات في العالم العربي وبين انعكاساتها الإيجابية المحتملة على الوضع الفلسطيني؛ وستستمر في هذه المحاولة، ساعية إلى إشغال أنظمة الحكم الجديدة بهمومها المحلية القُطرية، وببرامج الإصلاح والديمقراطية وفق المعايير الغربية.
ستحاول الإدارة الأميركية ألا تقوم الأنظمة (وخصوصاً تيارات الحكم ذات التوجهات الإسلامية) بأية إجراءات من شأنها تصعيد العداء مع “إسرائيل”، وإلغاء معاهدة كامب ديفيد، ووقف التطبيع، ووقف مسار التسوية أو دعم حركة حماس وقوى المقاومة وفتح المجال لها، وإنهاء الحصار عن قطاع غزة… وغيرها. وستعدُّ أميركا هكذا إجراءات خطوات عدائية، تستدعي بحسب درجتها إجراءات أميركية عقابية على الصُعُد المختلفة، وخصوصاً سياسياً واقتصادياً.
غير أن أميركا قد لا تستطيع التمادي في إجراءاتها إذا ما قابلت الجماهيرُ إجراءات أنظمتها بحالة تأييد والتفاف واسع، مصحوب بتصاعد العداء تجاه أميركا. ثم إنه لا يبدو أن الأنظمة العربية الجديدة تستعجل اتخاذ إجراءات حاسمة تستعدي الولايات المتحدة بشكل كبير؛ وربما تقوم باتخاذ إجراءات في إطار “الممكن السياسي” بانتظار تثبيت أركان مؤسسات هذه الدول الدستورية، والسياسية والحكومية.
إن 2012 هي سنة الانتخابات الأميركية، وعادة ما يضعف أو يتعطل مسار المبادرات السياسية الأميركية المتعلقة بفلسطين، إلا إذا كانت هناك فرص حقيقية لإحداث اختراق كبير، يساعد الرئيس الأميركي في حملته الانتخابية. وستكون الإدارة الأميركية في أضعف حالاتها بشأن الضغط على “إسرائيل”، حيث سيكون دور اللوبي الصهيوني كبيراً في انتخابات الرئاسة الأميركية. وإذا كان أوباما قد حصل في الانتخابات السابقة على 78% من أصوات اليهود، فإنه سيحرص بكل طاقته على كسب هذه الأصوات في الجولة القادمة.
وستتابع أميركا محاولة “تقطيع الوقت” سنة 2012 دون مبادرات تسوية جديدة، أو ضغوط على الطرف الإسرائيلي، بينما ستتابع توفير الغطاء لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. في الوقت الذي لا تملك فيه الإدارة الأميركية أية تصور حقيقي لتحريك مسار التسوية.
خاتمة
هناك مخاطر أن تدفع الإدارة الأميركية، بتنسيق إسرائيلي، باتجاه إثارة المشاكل والفتن في البلدان التي تشهد انتفاضات وثورات وحركات تغيير، لتحقيق مزيد من التفكيك والتفتيت في العالم العربي على أسس طائفية وعرقية، وهو ما يعني انتكاسة للمشروع النهضوي الوحدوي العربي الإسلامي، ومحاولة لتثبيت الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في “بيئة طائفية وعرقية”.
إن سعي الشعوب العربية للتحرر، وإنشاء أنظمة حرة تعبر عن إرادتها وكرامتها، ينبغي أن يترافق مع وعي دقيق بخطورة المرحلة، وتفويت الفرصة على أية قوى معادية تستهدف إجهاض حركات التغيير، وإعادة إنتاج أنظمة فاسدة.
إن البوصلة نحو فلسطين يجب أن تبقى في قلب مشاريع حركات التغيير في عالمنا العربي. ولا بأس في التدرج في بعض اتخاذ الإجراءات، وفي عدم الاستعجال في استعداء القوى الكبرى. غير أن الالتصاق بالمشروع النهضوي وبالجماهير وتطلعاتها هو الضمانة الحقيقية لنجاح مشاريع التغيير، وليس الاستغراق في الخوف من الأميركان أو في استرضائهم.
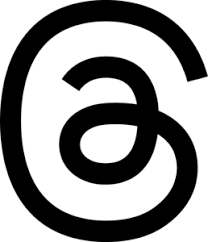

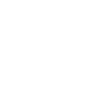
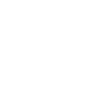
أضف ردا