قد يُصيب الإحباط من يتابع 18 عاماً من الحوار بين فتح وحماس، لم تتمكن فيها الحركتان -حتى الآن- من التوصل إلى “عقد” أو “ميثاق” وطني يشكل مرجعية ملزمة، كما لم تتمكنا من التوصل إلى آليات عمل تحترمانها ويمكن تطبيقها على الأرض.
لا يحتاج الطرفان لمن يعظهما حول أهمية الوحدة الوطنية وخطورة المشروع الصهيوني، فلديهما من القيادات من يستطيع المحاضرة في هذا الموضوع لعدة سنوات. ثم إن كلا الطرفين قدم من التضحيات والشهداء والقيادات والأسرى ما يثبت به إخلاصه للقضية وحبه لفلسطين، فأين المشكلة؟
إذا ما تم وضع التعصب الحزبي والجوانب الشخصية جانباً، فيبدو أن المشكلة مرتبطة بعدد من العوامل المتداخلة، أبرزها:
المرجعية الأيدولوجية
لا توجد مرجعية فكرية وأيدولوجية واحدة مشتركة تحدد ما هو ثابت مقدس لا يقبل المساومة، وما هو خاضع للتكتيك والمصلحة والتقدير السياسي وظروف الزمان والمكان وموازين القوى وبيئات العمل وغيرها.
وبالطبع، فإن ذلك ينعكس على البرنامج الوطني والسياسي لكلا الطرفين، وعلى تحديد الأولويات، وعلى ما يمكن تقديمه من تنازلات، وعلى رؤية الطرفين الإستراتيجية والتكتيكية لمشروعي المقاومة والتسوية.
وأحد أبرز النماذج على هذه الإشكالية موضوع الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وما ينبني على ذلك من تنازل عن الأرض المحتلة عام 1948 والتي تبلغ 77% من مجمل أرض فلسطين التاريخية.
فبالنسبة لحماس فإن فلسطين أرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عن أي جزء منها مهما طال الزمن أو اشتدت الضغوط، والمعركة معركة أجيال، كما لا يوجد ما يُبرر التنازل، حتى عندما يكون الفلسطينيون والعرب والمسلمون في أشد حالات ضعفهم.
وبالنسبة لفتح فإن الأمر مرتبط بتقدير المصلحة، ودراسة الواقع وموازين القوى، وتحصيل ما يمكن تحصيله وفق قرارات الشرعية الدولية، لأن الإصرار على كل فلسطين الآن قد يؤدي إلى خسارة كل فلسطين، كما لا يمكن المراهنة على عامل الزمن الذي لم يعمل لصالح القضية طوال السنوات المائة الماضية.
المرجعية المؤسسية
الإشكالية الثانية تتمثل في عدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إليها الطرفان، وتضبط آليات اتخاذ القرار الوطني، كما تضبط آليات التداول السلمي للسلطة، وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني. وتشكل منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح منذ نحو 40 عاماً، مظلة مقبولة للطرفين. غير أن هذه المنظمة واجهت مشكلتين حقيقيتين:
1- أنه خلال السنوات العشرين الماضية تراجع دورها وضعفت دوائرها، وانزوى تأثيرها في الواقع الشعبي الفلسطيني، وتكلّست مؤسساتها القيادية، فعمر لجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني الحالي بلغ 12 عاماً، ولم ينعقد المجلس الوطني في السنوات الـ17 الماضية سوى مرة واحدة سنة 1996. كما “تغوَّلت” السلطة الفلسطينية على المنظمة التي “ولدت ربَّتها”!
2- أن القوى الفلسطينية الصاعدة -وخصوصاً حماس- غير الممثلة في المنظمة، والتي أصبحت تمثل ثقلاً كبيراً في الساحة الفلسطينية، لم تكن لترضى بمجرد الدخول في المنظمة دونما إصلاحات جوهرية تعكس أولاً الحد الأدنى من رؤيتها الأيدولوجية وبرنامجها الوطني، وتعكس ثانياً الوزن الحقيقي والجماهيري لها في الشعب الفلسطيني، كما تصر على أن ينعكس دخولها ثالثاً على عملية إصلاحية حقيقية لبنية منظمة التحرير ومؤسساتها، بحيث تنهي احتكارها أو استخدامها كأداة من قبل فصيل معين.
وقد كان واضحاً من خلال السنوات الـ18 من الحوار بين فتح وحماس، أن القيادة المتنفذة في فتح -ومنظمة التحرير- لم تكن جادة في اتخاذ أي خطوات عملية لإجراء إصلاحات هيكلية على منظمة التحرير، بحيث تفسح المجال لمشاركة فاعلة وعادلة للفصائل الأخرى.
بناء الثقة
وتتمثل الإشكالية الثالثة في افتقاد عنصر الثقة بين الطرفين، خصوصاً أن الحوارات والاتفاقات العديدة السابقة أضفت في مآلاتها جوّاً من الإحباط والشك وانعدام الثقة.
ولا يثق الكثير من عناصر حماس بقيادة فتح للمسار السياسي الفلسطيني، خصوصاً بعد مسلسل التنازلات والاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني معها ومع الأميركان، وبعد التجربة المريرة لأوسلو وما تلاها، وكذلك بعد اتهام العديد من العناصر القيادية المحسوبة على فتح بالفساد، فضلاً عن إصابة فتح نفسها بالتشرذم والترهل، مما يُصعّب على فتح ضبط عناصرها في حال أي اتفاق مع حماس. كما يرى الكثير من عناصر حماس أن فتح ما زالت محكومة بعقلية الهيمنة واحتكار السلطة، وأنها بالتالي لا توفر أي فرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
وفي المقابل، لا يثق الكثير من عناصر فتح بقيادة حماس للمسار السياسي الفلسطيني، إذ يتهمونها بعدم الواقعية والتسبب في حصار الشعب وبعدم تقديم أية آفاق عملية لحل مشكلاته وهمومه.
كما يرى هؤلاء في طريقة المقاومة التي تقوم بها حماس تعطيلاً لمسار التسوية وحلم الدولة الفلسطينية، وتوفيراً للفرصة لإسرائيل كي تتحجج بالذرائع الأمنية للهروب من استحقاقات السلام، واستمرار قمع الشعب الفلسطيني وبناء الجدار العازل والمستوطنات.
العامل الخارجي
ويشكل العامل الخارجي عاملاً رابعاً مؤثراًَ في عملية الحوار الفلسطيني، إذ تظهر التجربة أن سبباً رئيسياً لاندفاع فتح للحوار مع حماس في عدد من المراحل، كان استكمال دائرة شرعية التمثيل الفلسطيني حتى تتمكن من التعامل مع إسرائيل وأميركا والمجتمع الدولي ومع ما تفرضه التسوية من استحقاقات.
ومن جهة أخرى فإن الأجواء التي صاحبت إضعاف حماس ومحاولات تهميشها في تسعينيات القرن العشرين، كانت تتمّ بمباركة وضغط دولي. وكان التدخل الإسرائيلي والأميركي فظّاً ومكشوفاً طوال الانتفاضة، وفي المرحلة التي تلت فوز حماس، في محاولة للتأثير على صناعة القرار الفلسطيني وتقوية طرف ضد آخر ولدعم الانفلات الأمني وإسقاط حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، ثم بتهديد الرئيس عباس بوقف المفاوضات وحصار الضفة إن هو عاد للحوار مع حماس والاتفاق معها.
قراءة في تجربة الحوار
يرى عدد من المراقبين أن التجربة التاريخية للحوار بين فتح وحماس تشير إلى أن قيادة فتح لا تلجأ عادة إلى الحوار إلا عندما تكون مضطرة لذلك، إما للظهور أمام إسرائيل والمجتمع الدولي بأنها تمثل كل الفلسطينيين، أو لتوفير الغطاء لتمرير صفقات سياسية، أو لتهدئة الأوضاع بانتظار اجتياز مرحلة أو استحقاق معين.
ففي عام 1988 رفضت حماس عرضاً من قيادة منظمة التحرير (قيادة فتح تحديداً) بالحصول على خمسة مقاعد من أصل 450 من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر. وكان ياسر عرفات يواجه حينها استحقاق إعلان الدولة الفلسطينية، وإعلان الموافقة على قرار تقسيم فلسطين، وعلى قرار 242، والاستجابة للشروط الأميركية في نبذ الإرهاب، تمهيداً للدخول في حوار مع أميركا.
في أغسطس/ آب 1991 عُقد لقاء بين فتح وحماس في الخرطوم، وكان عرفات يرغب في انضمام حماس إلى المنظمة والمجلس الوطني المرتقب في الشهر التالي والذي كان بصدد اتخاذ قرار المشاركة في مؤتمر التسوية في مدريد. ومنذ أن تشكلت السلطة الفلسطينية عام 1994 سعت إلى احتكار القوة وتثبيت سلطتها حيث تعاملت مع حماس من خلال ثلاثة محاور-بحسب ما تقتضيه الحاجة- وهي: الحوار، والاحتواء، والقمع والاعتقال ومحاولات التهميش والتشويه.
وفي الفترة 18-21 ديسمبر/ كانون الأول 1995 عقد حوار بين السلطة الفلسطينية وبين حماس، حاولت من خلال السلطة/فتح إقناع حماس بالمشاركة في انتخابات الحكم الذاتي، أو على الأقل الحصول على ضمانات بعدم سعي حماس لإفشال الانتخابات. وبالفعل فقد قاطعت حماس الانتخابات، لكنها التزمت بعدم إفشالها.
ومنذ 1996 وحتى انتفاضة الأقصى عام 2000، لم تعد السلطة/فتح تشعر بضرورة الحوار مع حماس وقوى المعارضة، بعدما تمكنت من بسط سيطرتها على مناطقها، وبعدما تمكنت من توجيه ضربة قاسية لحماس في ربيع 1996.
وكانت “اللغة الأمنية” هي اللغة التي استخدمتها السلطة معظم الوقت للتعامل مع حماس، وهي لغة تتبع خطاً تعامل مع حركة حماس كحركة “مشاغبة” ولكن “تحت السيطرة”.
استطاعت حماس في إثر انتفاضة الأقصى أن تفرض نفسها من جديد وأن تستعيد دورها الريادي المقاوم، وأن توسع شعبيتها. وكان واضحاً أنه لم يعد من الممكن تجاوز حماس سياسياً، أو إيقاف الانتفاضة دون موافقتها، ولذلك نشطت الدعوة إلى الحوار من جديد.
وفي الوقت الذي كانت فيه حماس والجهاد وباقي الفصائل توافق على الحوار سعياً لإيجاد برنامج وطني فلسطيني مشترك، كانت كذلك تدرك أن الهدف التالي لوقف الانتفاضة ودفع استحقاقات مسار التسوية هو ضرب البنية التحتية للمقاومة ونزع أسلحتها.
وهكذا، عُقدت مفاوضات القاهرة في الفترة 10-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 بين فتح وحماس، ثم في يناير/ كانون الثاني 2003، و4-7 كانون الأول 2003 بمشاركة كافة الفصائل. وفي 15-17 مارس/ آذار 2005 انعقدت جولة الحوار في القاهرة بمشاركة فتح وحماس وباقي الفصائل، حيث تم تبني برنامج فلسطيني ينصّ على الحق في مقاومة الاحتلال، وعلى الإعلان عن تهدئة تستمر حتى نهاية العام، كما تم الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية، وعلى القيام بإعادة تنظيم منظمة التحرير وإصلاحها وفق أسس تُمكِّن جميع القوى الفلسطينية من الانضمام إليها.
أما الحوارات التي تلت فوز حماس في الانتخابات التشريعية، فرغم تعددها ونقاشاتها الطويلة المتسفيضة، ورغم توصلها إلى وثيقة الوفاق الوطني وإلى اتفاق مكة، فإن نتائجها ما لبثت أن ذرتها رياح الممارسات على الأرض والانفلات الأمني والاغتيالات.
وفي كل مرة كانت عملية بناء الثقة تتعرض لضربات قاسية، فبينما كان الرئيس عباس يكلف هنية بتشكيل الحكومة، كان يقوم بنزع صلاحيات رئيسية من الحكومة في الأمن والإعلام والخارجية والتعيينات الإدارية.
وبعد اتفاق مكة بثلاثة أسابيع أصدر عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين دحلان مستشاراً له لشؤون الأمن القومي وأميناً لسر مجلس الأمن القومي. وما كادت حكومة الوحدة الوطنية تتشكل حتى فاحت روائح خطة دايتون الأميركية لإسقاط الحكومة الفلسطينية، بالتعاون مع أطراف متنفذة من فتح. ولم يكد يتمّ تعيين هاني القواسمي وزيراً للداخلية وتُقر خطته الأمنية بعد حوارات مضنية، حتى قدّم الوزير استقالته بعدما شلَّت عمله قيادات أمنية محسوبة على فتح.
وهكذا أخذ الحوار “المسلح” يغلب الحوار على “الطاولة” وتعقدت مظاهره في منتصف مايو/ أيار 2007، ثم وصل ذروته منتصف يونيو/ حزيران التالي عندما تمكنت حماس من السيطرة على قطاع غزة. وقد فتح ذلك المجال لقطيعة وأزمة ثقة هائلة بين الطرفين، لم تنفع معها العديد من الوساطات حتى الآن.
خلاصة
لا يظهر أن الرئيس عباس سيدخل في حوار غير مشروط مع حماس، إلا إذا تأكد من وصول مسار التسوية إلى طريق مسدود. كما قد يضطر عباس لحوار جاد مع حماس إذا ما استمرت الحركة في السيطرة على قطاع غزة، وخصوصاً حتى انتهاء ولايته كرئيس للسلطة الفلسطينية في نهاية العام 2008. وحتى هذا الحوار -إن تمّ- فقد لا يكون سوى حوار تكتيكي بهدف اجتياز مرحلة جديدة.
ولذلك فإن كاتب هذه السطور غير متفائل كثيراً بالحوارات بين فتح وحماس، ما لم يتمّ العمل بشكل مخلص وجاد على ترتيب البيت الفلسطيني وفق “عقد” وطني ملزم مبني على استقلالية القرار الفلسطيني، وعلى تحييد عنصر التأثير الخارجي فيه، وعلى إنهاء احتكار فصيل فلسطيني للسلطة والهيمنة والوصاية على مؤسسات صناعة القرار وخصوصاً منظمة التحرير، وعلى تكريس التداول السلمي للسلطة، وعلى أن يعكس القرار الفلسطيني ومن يقوده الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني.
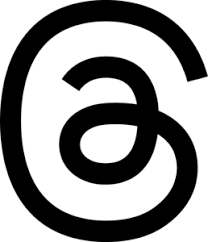

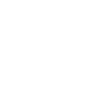
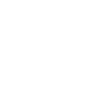
أضف ردا