بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
يبدو الرئيس عباس وقيادة حركة فتح كشخص تحدث طويلاً عن أهمية الخروج الآمن من الباب، ولكنه عندما اتخذ قراره، قام بالقفز من الشباك!!
من بين ثلاثة سيناريوهات محتملة لانعكاسات قرار المحكمة الدستورية للسلطة الفلسطينية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات جديدة خلال ستة أشهر، يبدوالسيناريو الأسوأ هو الأكثر ترجيحاً في ظلّ بيئة سياسية منقسمة، وفي ظلّ نظام سياسي فلسطيني ضعيف ومأزوم ومهترئ.
القرار الذي سمعه الناس عبر وسائل الإعلام يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، لم يسمعوه من المحكمة الدستورية نفسها، وإنما من محمود عباس، لنكتشف لاحقاً أن القرار قد اتخذته المحكمة قبل ذلك بعشرة أيام أي في 12 ديسمبر/كانون الأول 2018.
لم يكن قرار حل التشريعي مفاجئاً للمتابعين، فمنذ مايو/أيار 2006 وبعد فوز حماس بأغلبية المجلس ببضعة أشهر، وعباس يلوّح بالدعوة لانتخابات جديدة للمجلس. وطوال أكثر من 11عاماً تلت سيطرة حماس على السلطة في قطاع غزة، وسيطرة فتح على السلطة في الضفة الغربية، رفض عباس الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي؛ وحلَّ عملياً كرئيس مكان المجلس، منخلال إصدار العشرات من القوانين والتشريعات التي تمس صلب عمل المجلس.
وتزايدت الدعوات “الفتحاوية” لحل المجلس التشريعي خلال سنة 2018، وبرزت في قرارات المجلس الثوري لحركة فتح في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير (الذي تهيمن عليه فتح) “لتولي مسؤولياته” لحل المجلس التشريعي. مع العلم بعدم وجود صلاحيات لهذا المجلس في النظام الأساسي للسلطة لاتخاذ قرار كهذا. غير أن عباس فضّل استخدام المحكمة الدستورية كأداة للحل، باعتبار ذلك أكثر منطقية وقبولاً في منظومة السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية نفسها تواجه إشكالات حقيقية وخلافات داخلية فلسطينية بشأن مشروعية تشكيلها وطريقته، والميول السياسية “الفتحاوية” لبعض أعضائها، ومدى الصلاحيات التي تجعلها قادرة ومؤهَّلة للنظر في هكذا مسائل.
ثلاثة سيناريوهات مستقبلية:
بالنظر إلى الانعكاسات المستقبلية لقرار حلّ المجلس التشريعي على البيئة السياسية الفلسطينية، فلعلنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة مسارات (سيناريوهات):
السيناريو الأول: تجاوب القوى والفصائل الفلسطينية مع قرار الحل، وجعل المجلس “خلف ظهورنا”، كما ذكر محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لفتح. وهو الخيار الذي تسعى حركة فتح لتحقيقه. وقد بدا ذلك واضحاً من خلال الدعوات التي ظهرت لتشكيل حكومة فلسطينية، تقود المرحلة الراهنة باتجاه الانتخابات وتشارك فيها فصائل منظمة التحرير.
ويبدو أن فتح تعلم مسبقاً أن حماس (وهي ليست عضواً في المنظمة) سترفض القرار، وبالتالي ستسعى فتح لمحاصرة حماس وعزلها، وفرض المسار الذي ترغبه من خلال شراكة مؤقتة مأمولة مع فصائل المنظمة، وربما من خلال تقديم بعض “الحوافز” لهذه الفصائل.
ويظهر أن هذا المسار مسار مستبعد، بعد أن أعلنت الفصائل الرئيسة الأخرى في المنظمة بما لا يحتمل اللبس رفضها لقرار المحكمة الدستورية، ولتوجهات عباس والقيادة الفتحاوية. فالجبهة الشعبية أعلنت رفضها الكامل للقرار، وذكرت أن المحكمة الدستورية غير قانونية، وأن أحكامها منعدمة، وأن ما قامت به قيادة السلطة هو خطوة خطيرة تعزز الانفصال. والجبهةالديموقراطية قالت إن القرار لا يحل الأزمة، وإنما سيعقّد الأوضاع، وأنه مخالف للنظام الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة. كما سبق لبسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن اعترض على هذا التوجه، مؤكداً أن حلّ المجلس لن ينهي الانقسام، وإنما ستكون له آثاره السلبية.
وعملياً فقد بقيت فتح “تُغرّد” وحدها خارج السرب. كما أن حالة التقارب التي تراهن فتح عليها قد أسهمت هي نفسها (فتح) في إضعافها ودقّ (الأسافين) تجاهها طوال سنة 2018. فقد قاطعت الجبهة الشعبية اجتماعات المجلس المركزي الثلاث التي انعقدت في أثناء هذه السنة، كما قاطعت اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني. ثم إن الجبهة الديموقراطية قاطعت اجتماعي المجلس المركزي الأخيرين. واتسعت دائرة الغضب أو الانزعاج من السلوك الفتحاوي عندما انضمت المبادرة الوطنية بقيادة مصطفى البرغوثي فقاطعت الاجتماع الثالث للمجلس المركزي. وبالتالي فإن ما كان يحدث عملياً مع نهاية هذا العام هو مزيد من العزلة لفتح، ومزيد من التقارب السياسي مع سلوك حماس.
وعلى هذا، فإن هذا السيناريو يبدو الأقل حظاً من بين السيناريوهات الثلاث.
السيناريو الثاني: بقاء الأمر الواقع، والتعامل مع قرار الحل كقرار سياسي تكتيكي، فاقد لقيمته العملية.
بمعنى أن البيئة السياسية الفلسطينية لن تحمله على محمل الجد، وستتعامل معه كـ”زوبعة في فنجان”؛ ومجرد أداة ضغط سياسي لجأت إليها قيادة فتح، وهي تعلم انعدام تأثيرها أوضعفه. وبالتالي فهي عندما ترى الاعتراض الواسع عليها، ستسكت تدريجياً عن الاتكاء على هذا القرار، أو الحديث فيه. غير أنها قد تنفض عنه الغبار بين فترة وأخرى كأداة مناورة سياسية.
يُقوي هذا السيناريو أن الفصائل الفلسطينية الأخرى، ومعظم القوى الفاعلة، التي لا يمكن أن تتم الانتخابات أو تٌعطَى المشروعية لهذه الخطوة، من دونها، قد رفضت قرار المحكمة، واعتبرته قراراً مسيّساً. كما أن حماس التي تملك الأغلبية الساحقة في المجلس، وهي طرفٌ أساسٌ في المصالحة، وفي “نزاع الشرعية” قد رفضت القرار، وأكدت على استمرار عمل المجلس.
ويدعم ذلك، أن أبرز المراجع القانونية في القانون الدستوري قد اعتبرته قراراً غير مشروع دستورياً، وتجاوزاً للقانون الأساسي للسلطة، وتجاوزاً من المحكمة الدستورية لصلاحياتها، كما ورد في الرأي الاستشاري للبروفيسور أحمد مبارك الخالدي، عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح سابقاً، ورئيس لجنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيني. كما أن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء سامي صرصور، أكد عدم مشروعية قرار الدستورية، مؤكداً كما أكد الخالدي أن ولاية التشريعي لا تنتهي إلا بتأدية الأعضاء الجدد للمجلس الجديد اليمين الدستورية، وفق نصّ صريح قاطع في النظام الأساسي الفلسطيني، وأنه لا توجد لأي جهة “شرعيةُ” حلّ المجلس. وأن هذا النص لم يحصل على مثله الرئيس عباس نفسه، المحددة ولايته بخمس سنوات وفق النظام الأساسي.
ويميل هذا السيناريو إلى أن فتح عندما تجد هذه البيئة الواسعة من المعارضة، ستلجأ إلى تهدئة الأمور، والمناورة بأشكال أخرى مختلفة، كما أن الفصائل الأخرى بما فيها حماس ستلجأ حرصاً على عدم تدهور الأمور إلى محاولة استيعاب الانعكاسات السياسية وامتصاصها، والدفع من جديد في اتجاه المصالحة. وهذا السيناريو يحظى بفرصة نجاح، شرط تراجع فتح عن تنفيذ الاستحقاقات الناتجة عن هذا القرار.
السيناريو الثالث: تفاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وزيادة الانقسام السياسي والجغرافي، وتراجع فرص إنفاذ المصالحة.
وتعتمد جدلية هذا السيناريو على أن لجوء عباس وقيادة فتح لاستخدام المحكمة الدستورية في النزاع السياسي الفلسطيني هو نوع من “كسر العظم” و”حرق السفن” في العلاقات السياسية الداخلية الفلسطينية. وأنه قفزة “إلى الجحيم” كما عبَّر الخبير السياسي هاني المصري. إذ إن هذا القرار المُسيَّس بامتياز، قد ضرب اتفاقية المصالحة في الصميم، والقائمة أصلاً على الشراكة والتعددية والمسارات المتوازية في العملية الإصلاحية لبنية النظام السياسي الفلسطيني. واتفاقية المصالحة نفسها تدعو إلى تفعيل المجلس التشريعي، وليس إلى تعطيله (وهو ما استمر بممارسته عباس طوال سنوات). وبالتالي فإن هذا القرار سيزيد المنظومة السياسية الفلسطينية بؤساً وتفتتاً، بسبب سعي طرف فلسطيني (فتح) لاستخدام بعض الأوراق التي يملكها في تكريس هيمنته على الساحة، وليس في إصلاحها.
ويدعم هذا السيناريو أن عباس قد مضى بعيداً في السنتين الماضيتين في محاولات “إخضاع” حماس، وفرض هيمنته على الساحة الفلسطينية، بالرغم من اتساع دائرة المعارضة لسياساته داخل منظمة التحرير وخارجها. فبالإضافة إلى استمراره في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والذي تُجمِع على رفضه معظم القوى الفلسطينية، فقد فرض عقوبات على قطاع غزة منذ مارس/آذار 2017، كما رفض عقد الإطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني حتى الآن، ولو -على الأقل- في سياق مواجهة ما يُعرف بـ”صفقة القرن”. وأصر من جهة أخرى، على عقد المجلس الوطني الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان 2018، متجاهلاً التوافقات الفلسطينية التي حدثت في بيروت في يناير/كانون الثاني 2017 حول عقده. وفوق ذلك، فهو ما زال يستخدم حجة “التمكين” للحكومة الفلسطينية في تعطيل مسار المصالحة أو في الامتناع عن رفع العقوبات عن القطاع. وكل النقاط السابقة التي يصر عليها، تجد معارضة واسعة من القوى الفلسطينية المختلفة، وليس من حماس وحدها.
وعلى ذلك، يبدو أن عباس طالما ظلَّ في موقعه، فإن المنظومة السياسية الفلسطينية ستتجه نحو مزيد من التأزيم، بينما تتراجع الفرص الحقيقية للمصالحة.
ولعل هذا السيناريو هو للأسف الأقرب للحدوث.
وأخيراً، فإن الأزمة العميقة التي يمر بها النظام السياسي الفلسطيني تستدعي تضافر القوى المختلفة، لتجاوز حساباتها الشخصية، وتقديم أولويات بناء المشروع الوطني على أسس سليمة، خصوصاً ونحن نواجه مخاطر حقيقية لإغلاق الملف الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: موقع “TRT” عربي، 1/1/2019
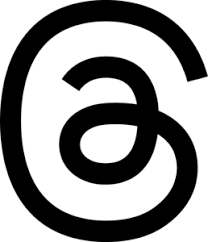

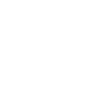
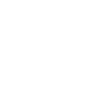
انشأ الرئيس ابو مازن المحكمة الدستورية لانه رجل يحترم القانون وقد صبر على حركة حماس 12 سنة وهي ترفض المصالحة واعادة الامور الى طبيعتها قبل الانقلاب بل تطالب بالشراكة والتقاسم الوظيفي الذي رفضته منذ ان نشأت حركة حماس في غزة ولكن بعد انقلابها على السلطة وفشلها بالحكم والمقاومة ولم تحرر شبرا واحدا بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي ومستوطنيه من غزة في ظل وجود السلطة الوطنية هذا من ناحية .
اما موضوع الانتخابات سيعلن الرئيس ابو مازن عن موعد الانتخابات وستحدث لان المجلس التشريعي باغلبية حماس كله شارك وايد ودافع عن الانقلاب ولم يسمع اهل غزة كلمة حق او دفاع عنهم وهم اختاروا حماس ظانين انها سوف تحقق لهم الافضل واذا بحماس تقمع وتقتل ونوابها لا يحركون ساكنا وكل ما يعرفونه تخوين الاخرين . وهذه حجة قوية للرئيس ابو مازن وهو الانقلاب اولا ثم موت المجلس التشريعي وعدم فاعليته . وفي هذه الحالة يحق للرئيس ان يصدر قرارات توازي قوة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي .
ثم ان القيام باجراء انتخابات يحل المشكلة فالمجلس التشريعي ليس حكرا على اتباع حماس او اتباع فتح الى ما لا نهاية . نحن نريد للديمقراطية الفلسطينية ان تستمر كل اربع سنوات وليس كل 12 سنة . ولهذا من حق الاشخاص ان يرشحوا انفسهم او ان ينتخبوا وبعد انتهاء عملية الانتخابات يتوجه المجلس الجديد لاداء اليمين امام الرئيس . اما ان تنمع حماس الانتخابات وترفضها وتريد مجلس تشريعي جديد ان يأتي فكيف سيحدث هذا دون اجراء الانتخابات .
وبما ان حماس اعتادت ان تتهم الرئيس والسلطة بالتنسبق الامني فلماذا تطالب بالمشاركة في هذه السلطة ولا زالت متمسكة بالمجلس التشريعي وتطااب ان تكون عضو في منظمة التحرير . ان كل شعب فلسطين اصبح يدرك مدى الكذب والنفاق والتخبط الذي تعيشه حركة حماس لدرجة انها اصبحت معزولة من كل الدول وعادت تتوسل ايران لتعيد علاقتها معها مقابل اموال سياسية لتكون اداة بيد ايران بدلا من ان تتوافق مع حركة فتح اكبر فصيل واكثر حنكة سياسية ودبلوماسية وحفظا للقرار الوطني المستقل .
في النهاي سواء شاركت حماس او لم تشارك هي والشعبية والديمقراطية وغيرهم في الانتخابات فان الانتخابات سوف تحدث وقد رفضت حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية المشاركة في انتخابات التشريعي عام 1996 وندموا وجاؤوا مهرولين بعد عشر سنوات وشاركوا في انتخابات 2006 واستمروا ليومنا هذا .
الهدف من الانتخابات ليس اقصاء احد وانما اصلاح النظام السياسي وتوحيد النظام من خلال البرلمان وكذلك توحيد الوطن لنستطيع مواجهة الاحتلال ولا نعلم لماذا ترفض حماس الوحدة وتفضل نفسها على الكل الفلسطيني وهي لم تحقق شيء مفيد للقضية الفلسطينية او للشعب . على حركة حماس ان تعيد حساباتها وان تفكر بمصلحة الوطن والشعب بدلا من ان تفكر بنفسها وتنفذ اوامر خارجية تصدر لها .