الصفحات الخمس الأولى من الفصل الرابع: “الوضع الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان” (نسخة نصيّة HTML)
النص المعروض هو للصفحات الخمس الأولى من الفصل … للاطلاع على الفصل الرابع كاملاً اضغط هنا ![]() (29 صفحة، 1.1 MB)
(29 صفحة، 1.1 MB)
الفصل الرابع: الوضع الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان
زياد الحسن
أولاً: التكوين الاجتماعي وولادة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين:
لقد كانت نكبة سنة 1948 الحدث الأكبر تأثيراً في تكوين المجتمع الفلسطيني الحديث، فهي التي قسّمته إلى داخل وشتات، وجعلت الخيمة والمخيم مفردات رئيسية في وعي هذا المجتمع ووجدانه، ومع انضمام النكسة إلى قاموس المصطلحات الفلسطيني سنة 1967، انقسم الشتات إلى لاجئين ونازحين، وانقسم الداخل إلى داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، وداخل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كان الفلسطينيون يميلون في رحلتهم من ديارهم إلى الاستقرار في أقرب مكان آمن، لتسهيل عودتهم التي كانوا يرونها قريبة، وهذا ما أدّى إلى تهجير بعضهم مرتين وثلاثاً، فخلال حرب سنة 1948 التي استمرت 11 شهراً، خرج أبناء بعض القرى والمدن التي كانت تتعرض للهجوم إلى المدن والقرى المجاورة الأكثر أمناً، واضطروا للمغادرة من جديد حين امتدت الهجمات إلى هذه المدن والقرى؛ ليعبروا الحدود إلى البلدان المجاورة ليلحقوا بإخوة لهم كانوا تجشّموا عناء هذه الرحلة براً وبحراً منذ البداية. في ملاجئهم الجديدة، كانت السلطات المرتَبِكة حديثة النشأة تحاول إدارة الأزمة، فتجمع المهجّرين في أماكن وصولهم عبر الموانئ والحدود البرية في مراكز مؤقتة، إلى حين إعداد مراكز استقبال مؤقتة أيضاً لكنها أكثر تجهيزاً، وبعض هذه المراكز أخذت اللاجئين إلى أماكن أبعد عن مدنهم وقراهم الأصلية، حتى وصلت مخيماتهم إلى النيرب في ضواحي مدينة حلب شمال سورية على بُعد 355 كم من وطنهم، وإلى مخيم نهر البارد شمالي مدينة طرابلس، على مسافة 143 كم من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
شكّل لبنان الوجهة الأساس لفلسطينيي الشمال، فاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الزيتونة يُشير إلى أن 95.5% من سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، تعود جذورهم إلى مدن شمال فلسطين المحتلة وقراها، فيما كان 1.3% منهم فقط من يافا، و3.3% توزعوا على باقي مدن وقرى فلسطين ، والشكل التالي يوضح أصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:
كان المجتمع الفلسطيني قبل النكبة مجتمعاً زراعياً في أغلبه، فمعظم سكان فلسطين تركّزوا في قرى المناطق الخصبة، بدءاً من الشمال وجبال الجليل، وفي جبال الضفة الغربية لنهر الأردن حيث يصل معدل هطول الأمطار إلى 500 ملم سنوياً، وفي الأغوار التي ترويها مياه نهر الأردن وفروعه، وكذلك في السهل الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط، أما مدن فلسطين قبل نكبة سنة 1948 فيمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين: الأول؛ كان المدن الداخلية مثل القدس، والناصرة، وصفد، ونابلس، والخليل، وبيت لحم، وكانت تشكل مراكز حضارية يعتمد عليها سكان القرى المحيطة في الحصول على الخدمات والصناعات الحرفية، وفي تسويق محاصيلهم الزراعية وماشيتهم ومنتجاتها، فيما تعتمد هي على سكان القرى في الحصول على مواردها الغذائية الأساسية وفي تجارتها مع المدن المحيطة والخارج مستخدمةً منتجاتهم، وكانوا يشكلون سوقاً هاماً لما ينتجه حرفيوها وأسواقها القديمة. ثلاثة من هذه المدن الداخلية، القدس، والناصرة، وبيت لحم، تتمتع بقدسية دينية كانت تعطيها صبغة مميزة، وتضمن استمرار تدفق الحجاج والزوار لها خصوصاً في فترات الهدوء والاستقرار السياسي.
وكان بعض زوار تلك المدن، خصوصاً، زوار القدس، يُسحرون ببهائها وتأسرهم قدسيتها، فيقررون البقاء فيها ليندمجوا في نسيجها الاجتماعي، ويزيدوه تنوعاً وثراءً. القسم الثاني كان المدن الساحلية، التي كانت إلى جانب علاقتها مع قراها المحيطة، تُعدّ مراكز تجارة واستيراد وتصدير، وكان عدد لا بأس به من سكانها، بل ومن سكان قراها، يعتمدون على مهن البحر كالصيد، والبحرية، وصناعة القوارب، وخدمة الموانئ، وكان لكل من عكا وحيفا ويافا وغزة موانئها، لكن ميناء يافا كان الميناء الأبرز، وكان من أكبر المراكز التجارية في شرق المتوسط.
هذا التوزيع السكاني يُظهر أن المجتمع الفلسطيني كان مجتمعاً زراعياً بامتياز، فكان يعتمد على زراعته، سواء في عيشه المباشر أو في صناعته وتجارته، وهذا ما جعل الأرض تحتل مكانة متميزة لدى الفلسطيني فلاحاً كان أم ابن مدينة.
الإسلام كان وما يزال مكوناً أساسياً لوعي هذا المجتمع وانتمائه، وقدسية الأرض التي يحيا فيها كانت حاضرة في وجدانه، كما أن فلسطين مليئة بالأماكن والمزارات والمقامات التي تذكر بالكثير من الأنبياء والصحابة والصالحين الذين عاشوا فيها. وما ورثه من ذكريات الحروب الصليبية، والتحرير على يد صلاح الدين الأيوبي كانت ما تزال حاضرة في عمرانه، ومؤسساته، وحتى عاداته حتى سنة 1948، وكان الاحتفال بموسم النبي موسى ، الذي سنّه صلاح الدين الأيوبي، أحد أهم النماذج للعادات التي ترسخت في الوجدان الفلسطيني لمئات السنين.
القبيلة والعشيرة والحمولة والعائلة، بحسب المكان الذي نتحدث عنه، كانت مكونات أساسية للمجتمع، ومؤسسات رئيسة في صناعة وعي الفرد والجماعة وصوغ حياتهم، وحلّ مشاكلهم وصراعاتهم أو حتى افتعالها، وكانت مصدراً أساسياً للمكانة والنفوذ والتقدير، كما هو معتاد في المجتمعات الفلاحة والبدوية.
هذه الصورة التي رسمناها لمكونات المجتمع وأسلوب عيشه تنبئنا بوضوح عن نوع الصفوة والقيادة التي تسود فيه، فالمكانة في المجتمع الفلسطيني كانت مرتبطة بملكية الأرض كما كان حال آل الشوا في مدينة غزة ومحيطها، أو بالعشيرة وأصلها وحجمها كما كان حال عرب التعامرة في محيط بيت لحم، أو بالدرجة العلمية والمكانة الدينية كما كان حال عائلات الحسيني والخالدي في القدس، وعائلات طوقان وهاشم في نابلس، أو بالحرفة والتجارة التقليدية التي كانت أقل تأثيراً وأضيق امتداداً من مصادر التأثير السابقة. كانت هذه القيادات تقليدياً تحتل مركز الصدارة وتقود المجتمع على المستوى المحلي والوطني، وعلى الرغم مما قد يوجه من نقد لآلية تولد هذه الصفوة وللدور الذي كانت تلعبه، إلا أنها كانت منبثقة عن البنية العامة للمجتمع، وتتفاعل مع أجزائه ومكوناته؛ فتقوم بالدور المفترض للصفوة في توجيه الحياة والتأثير فيها وتوعية الجمهور ومحاولة حماية مصلحة المجموع، وكانت تتطور بشكل خلاق لتتفاعل مع التهديدات، وهذا ما شهدته ثورة سنة 1936، التي ظهرت فيها صفوة جديدة من قادة الثورة الفلاحين من غير ذوي الأملاك أو العشيرة الكبيرة أو العلم، صنعتهم الثورة وصقلتهم وجعلت منهم أسياداً في الميدان، وكان المجتمع ككل مستقراً على شكل راسخ من التعاون، والعلاقات، والإنتاج، والتبادل، والتفاعل، والصراع.
ما فعلته النكبة هو أنها نقضت نسيج هذا المجتمع خيطاً بخيط، فلا قبيلة ولا عشيرة ولا حمولة ولا عائلة، الأسرة على صغرها تشتت أفرادها بين الداخل ومختلف المهاجر، ولا أرض ولا إنتاج زراعي، ولا بيع لمحصول ولا تجارة في مدينة ترتكز على هذا المحصول، ولا حانوت ولا حرفة ولا ميناء ولا صيد ولا رأس مال ولا تجارة، ولا مفتي ولا قائد، أغلبية الفلسطينيين أصبحت مبعثرة، وسعى كل واحد لأن يلمّ شعث نفسه، وله مكانة واحدة: لاجئ.
لقد كان التحدي الأكبر أمام المجتمع الفلسطيني، بعد أن استوعب الصدمة وأدرك أن هذا اللجوء سيطول، هو أن يُعيد هذا المجتمع بناء نفسه كوحدة متماسكة من جديد في مخيمات اللجوء على الرغم من كل المعوقات؛ فغابت الصفوة لفترة من الزمن. وكان اللاجئون كتلة ديموغرافية طيّعة في يد السلطات المضيفة، تنقلها، وتوزعها، وتحددها، وتنظم تحركها أو تقيده، خصوصاً بعد أن تبدلت الروح الأخوية لإدارة الأزمة، وحلّت محلها روح أمنية تضع عينها على الحسابات الداخلية، بعد أن اكتشفت هذه الدول أن اللجوء سيطول.
مرت فترة الخمسينيات من القرن العشرين والمجتمع الفلسطيني في الشتات عموماً، وفي لبنان خصوصاً، يحاول إعادة بناء نفسه، وإعداد الحدّ الأدنى الممكن الذي يؤهله لمواصلة الحياة، وترافق هذا مع جهد وكالة الأونروا؛ لتوفير الحدّ الممكن من العون والمواد الغذائية، ثم من البنى التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، ومع جهد من الدولة لحصر اللاجئين في مخيماتهم وتحديد أماكن إقامتهم وتقييد تنقلهم، فرضت عليهم شروطاً قاسية في التنقل، خصوصاً أولئك المقيمين في المخيمات والتجمعات المؤقتة في الجنوب، إذ كانت تفرض عليهم الحصول على تصاريح خاصة من الأمن اللبناني للانتقال إلى خارج دائرة سكناهم، وكان للمكتب الثاني (المخابرات) والأمن اللبناني مخافر ونقاط ثابتة في كل المخيمات والتجمعات؛ لتتابع دقائق حياة الأفراد الفلسطينيين وتتدخل في عيشهم. ومع ذلك، فقد نشأت بعض النخب الفلسطينية في مختلف مناطق الشتات، وكانت قاعدة تَولُّد النخب هذه المرة قائمة على التعليم بالدرجة الأولى، وعلى الوظيفة التي يُتيحها هذا التعليم لصاحبه، خصوصاً في دول الخليج، التي كانت تفتح أبوابها في ذلك الحين للطاقات الشحيحة المتوفرة في العالم العربي؛ لتسهم في البناء الحديث لتلك الدول بعد الطفرة النفطية، وهذا ما زاد قيمة التعليم، والتعليم الجامعي خصوصاً، رسوخاً لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين كانت هذه الفرصة قَشَّتَهُم الوحيدة للنجاة.
كما بدأ بعض أصحاب المهن والحرف والتجار بمزاولة مهنهم، والمبادرة بفتح مصالح وتجارات في دول الشتات، فأنشأ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان شركة فرج الله، أول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات، وسلسلة محال عطا الله فريج أول مجموعة محال لبيع الملابس الجاهزة في لبنان، وأسّس باسم فارس أول شركة عربية للتأمين في لبنان، وافتتح أدوين إبيلا أول “سوبرماركت”، وأسس فؤاد سابا وكريم خوري أول شركة لتدقيق الحسابات في لبنان، وكان منهم جورج دوماني أول من رفع العلم اللبناني في القطب الجنوبي، وحنا حوا أول من قاد طائرة جامبوجت في شركة الميدل إيست اللبنانية، إضافة إلى الدكتور إبراهيم السلطي، أول رئيس عربي مقيم للجامعة الأمريكية في لبنان، وإدوارد سعيد المفكر الذي شغل الدنيا، وأسس وليد الخالدي وفايز الصايغ مع عدد من رموز الفكر في لبنان مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة 1963، فكانت من أولى مؤسسات الدراسات المتخصصة في لبنان . لقد تمكن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أن يكونوا رواداً مسهمين في الاقتصاد، والثقافة، والتعليم، ومختلف المهن على الرغم من حداثة عهد مجتمعهم الناشئ، لكن هذه النخب كانت بحاجة لمزيد من الوقت لتنمو وتتطور وتكبر وتأخذ موقعها في قيادة المجتمع الناشئ وحمايته، والعمل على بلورة أهدافه الوطنية، وهذا ما لم يتيسّر لها.
جاءت حرب سنة 1967 لتقضي على آمال العرب بالنصر الذي كانت تعِدهم به الأنظمة التقدمية، ولتقضي على آمال اللاجئين بعودة قريبة، ولتؤكد أنهم من الآن فصاعداً يجب أن يأخذوا الزمام بأيديهم ليحقّقوا عودتهم، فبادرت الحركات الفلسطينية، وخصوصاً حركة فتح التي كانت تنشأ في المهجر بسرية، إلى مباشرة العمل المسلح من الأردن، ولم تلبث أن امتدت إلى لبنان، ثم انتقلت بالكامل إلى لبنان بعد المواجهات الضارية مع الجيش الأردني في 1970-1971. هذا الانتقال جعل منظمة التحرير وقيادتها تتصدى لقيادة المجتمع الفلسطيني في لبنان، وما لبثت صفوة جديدة أن نشأت على أساس الانتماء السياسي والكفاح والبندقية أن تصدرت المجتمع، واللافت في هذه الصفوة أن رموزها المركزية كانت في معظمها من خارج مجتمع اللاجئين في لبنان.
النص المعروض هو للصفحات الخمس الأولى من الفصل … للاطلاع على الفصل الرابع كاملاً اضغط هنا ![]() (29 صفحة، 1.1 MB)
(29 صفحة، 1.1 MB)
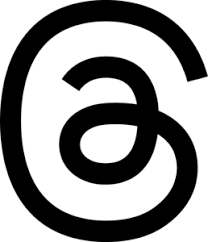

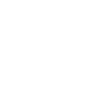
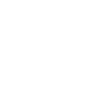
أضف ردا