سيطرت “احتجاجات الخيام”، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، على الميادين والشوارع الرئيسية في المدن الإسرائيلية. جاءت هذه الاحتجاجات على خلفية تراجع مكانة الطبقة الوسطى وغلاء المعيشة، في ظل تقليص الحكومة الإنفاق على الخدمات العامة. وقد طالب المتظاهرون بتغيير النهج الاقتصادي – الاجتماعي للحكومة والعودة إلى نظام “الرفاه الاجتماعي”.
لم تدع الاحتجاجات إلى إجراء تغيير في الحياة العامة في “إسرائيل”، ولم يجر المسّ بالشأن السياسي أو منظومة العمل الحزبي داخلها، مع أن الأوضاع الاقتصادية والحياة الاجتماعية تأثرت بسبب توقف مسار التسوية مع الفلسطينيين. وبقي الأمن بعيداً عن متناول المطالبين الذين اكتفوا بالدعوة لإجراء بعض التقليصات في ميزانيات الأمن، لصالح مرافق اقتصادية – اجتماعية معينة، بحيث لا تؤثر على الأمن ذاته.
على خلفية ما تقدم، يمكن القول بأن الحكومة قد تتمكن من إجراء بعض الإصلاحات التي ستؤدي إلى امتصاص غضب الشارع، في حين إنه من المستبعد أن يحدث هذا الحراك تغييراً جوهرياً في المنظومة الحزبية داخل “إسرائيل”. في الوقت نفسه، ومع أن المحتجين عزفوا عن الخوض في الشأن السياسي إلاّ أن ذلك في الغالب قد لا يطول كثيراً، حيث من المتوقع أن يصار إلى إعادة طرح الشأن السياسي خلال الفترة القادمة ولو بأساليب مختلفة.
مقدمة:
كان تموز الماضي ملتهبا في المشهد الإسرائيلي العام، إذ طفت على الوجه حركة احتجاجات اجتماعية انطلقت من مركز مدينة تل أبيب منتشرة في عدد كبير من مدن “إسرائيل” من الشمال وحتى الجنوب. وأخذت هذه الحركة اسم “احتجاج الخيام”، حيث نصب المحتجون آلاف الخيام في ميادين المدن وأطراف الشوارع الرئيسية عند مداخلها، وانضم عشرات آلاف الشباب الإسرائيلي إلى دعوة الاحتجاج.
ولفهم تداعيات هذه الحركة علينا التطرق أولاً إلى دوافع حصولها وأهدافها وما آلت إليه في نهاية المطاف.
دوافع حركة الاحتجاج:
1. شهدت الطبقة الوسطى في “إسرائيل” خلال العقدين الأخيرين تراجعا في مكانتها الاجتماعية في أعقاب تآكل مستمر لرواتب ومداخيل المنضوين تحت سقفها، ويمكن إرجاع ذلك إلى السياسة الاقتصادية التي اتبعتها حكومات “إسرائيل” المتعاقبة في الفترة المُشار إليها أعلاه، وخاصة سياسة حكومة نتنياهو الداعمة لخصخصة القطاع العام وتخلُّص الحكومة من شركاتها وتحويلها إلى القطاع الخاص. وبالتالي بدأت تتركز الثروات والموارد المالية بيد عائلات إسرائيلية عددها عشرون.
2. غلاء المعيشة في “إسرائيل” وارتفاع أسعار السلع ومتطلبات الحياة، أمام تآكل أجور الطبقة الوسطى المتضررة الأكبر من سياسات حكومة “إسرائيل”. فلم يعد بإمكان عائلة إسرائيلية متوسطة أن تعيش بمستوى اقتصادي – اجتماعي اعتادت عليه سابقاً. والأصعب من هذا أن هذه العائلات لم يعد بإمكانها أن تُنهي الشهر. وبالتالي تآكلت القدرة الشرائية للرواتب المتآكلة أصلاً مقابل ارتفاع في أسعار معظم السلع الضرورية وغير الضرورية.
3. نتيجة زيادة الطلب على الشقق السكنية سواء كان لغاية الشراء أم الإيجار في مدينة تل أبيب والمدن المحيطة بها ارتفعت الأسعار بشكل فاحش في السنة الأخيرة، مما أدى إلى عدم تحمل الشباب والأزواج الشابة من أبناء الطبقة الوسطى تحمل ذلك.
4. سياسة الحكومة في تقليص الإنفاق على الخدمات العامة، وبالتالي خفض نسبة الضرائب على الطبقة الوسطى بهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي. إلاّ أن المتضررين كانوا من الطبقة الوسطى أنفسهم، أما المستفيدون فكانوا من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال إذ زاد دخلهم بشكل فاحش، ودفعوا نسبة ضرائب متدنية واستعادوا الضرائب غير المباشرة التي يدفعها أبناء الطبقة الوسطى وهم من الأجيرين الذين لا يمكنهم استعادتها.
5. تخلّصت حكومة “إسرائيل” سواء الحالية أو سابقاتها من كونها حكومة “دولة رفاه اجتماعي”، وذلك على حساب نقل ذلك إلى شركات القطاع الخاص، وبهذا تكون قد خلّفت ورائها الطبقة الوسطى وغيرها من دون خدمات مؤكدة سواء في قطاع التعليم أو الصحة، إذ احتاج المواطن إلى دفع مبالغ كبيرة لقاء نيله هذه الخدمات.
6. هناك شرائح سكانية في المجتمع الإسرائيلي لا تشترك في سوق العمل، أي أنها لا تُنتج، خاصة المتدينين المتشددين. اعتماد هؤلاء على ما توفره لهم أحزابهم المتدينة المشتركة في الائتلاف الحكومي. بمعنى آخر ما تنجح هذه الأحزاب، وغالباً تحقق ذلك، في ابتزاز الحكومة بأموال كثيرة تُحَوّل على شكل أموال مخصصة للمؤسسات التي تديرها هذه الأحزاب. وهناك العرب الفلسطينيين في الداخل الذين لا تأثير لهم في سوق العمل جراء سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة الهادفة إلى تهميشهم وإقصائهم كجزء من آلة التمييز ضدهم، وعدم توفير فرص عمل لهم في قراهم أو مدنهم ورفض شركات كثيرة استيعابهم في صفوفها من منطلق عنصري بات واضحاً وغير خفيّ.
7. ميزانية الأمن في “إسرائيل” التي تستحوذُ قسطاً كبيراً من مُجمل الميزانية العامة، وتأتي على حساب ميزانيات التربية والتعليم والصحة والتطوير…
8. الدعم غير المحدود بمبالغ كبيرة والذي تقدمه الحكومة للنشاط الاستيطاني، وخاصة مشاريع البناء التي يجري تنفيذها في الضفة الغربية، بدلاً من الاستثمار في البناء في “إسرائيل” من قبل الحكومة أو شركات متعاقدة معها.
9. ازدياد وتعمق الفجوات والثغرات الاجتماعية والاقتصادية مع الأطراف التي تعتبر فقيرة مقارنة مع تل أبيب.
المطالب التي رفعتها ولوحت بها حركة الاحتجاج:
يجب التنويه هنا إلى أن حركة الاحتجاج لم تطالب بتنفيذ انقلاب اقتصادي – اجتماعي، كل ما طلبته يتمحور في إعادة دولة الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية إلى المشهد الحياتي العام في “إسرائيل” بعد أن سيطر وساد الاقتصاد الحر على هذا المشهد وكوّن “حيتاناً” من الأثرياء، ودفع إلى أسفل شرائح عريضة من الطبقة الوسطى. ويستشف من المطالب أن الحركة دعت أو نادت بحاجة المجتمع الإسرائيلي إلى نقطة توازن جديدة بين نظام السوق الحرة وبين تقسيم أكثر عدلاً للدخل وتوفير ظروف معيشية مقبولة مع الحفاظ على المصالح العامة. وبالمجمل العام يمكن ملاحظة عدد من المطالب العامة التي رفعتها الحركة، وهي:
1. المطالبة بإجراء تعديلات على النظام الاقتصادي العام في “إسرائيل” دون تغييره جذرياً. أي أن هذه الحركة تتفاعل مع النظام المتعلق بالسوق الحرة ولكن حاجتها إلى لجم مساحة وفضاء تحرّك السوق الحرة.
2. تغيير النهج الاقتصادي – الاجتماعي للحكومة وإعادة العمل بنظام “دولة الرفاه” المؤسسة على أسس العدالة الاجتماعية، وهذا هو الشعار المركزي للحركة. وهذا يعني إعادة مسؤولية الرفاه الاجتماعي إلى الحكومة بعد أن تنازلت عنها لصالح القطاع الخاص الذي تحكّم بالسوق والأسعار والأجور.
3. مطالبة الحكومة إعادة العمل بنظام الرقابة الحكومي على الأسعار كما كان معمولاً به، خاصّة أسعار المواد الأساسية والمدعومة والضرورية، ورفع الأجور وفرض التعليم الإلزامي المجاني وتحسين الخدمات الصحية، وفرض ضرائب على أصحاب رؤوس الأموال.
طبيعة الحركة:
من المفيد التعمق في فهم طبيعة وجوهر هذه الحركة قبل الوصول إلى تداعياتها على المشهد العام في “إسرائيل” وتأثيرها على سياسة الحكومة الحالية وصنّاع القرار. فالحركة الاحتجاجية لم تخرج عن الإجماع الفكري الصهيوني، أي أنها لم تُعلن ثورة شاملة على نظام الحكم ولم تطالب مُطلقاً بإسقاط الحكم، حتى أنها لم تطالب بإجراء انتخابات برلمانية. إنما انحصر دورها في المطالبة بأمور عينية معيشية تخصّ طبيعة تكوين الطبقة الوسطى في تل أبيب.
من جهة أخرى فإن الحركة لم تدعُ إلى تغيير أجندة الحياة العامة في “إسرائيل”، حيث إن الشأن الأمني لم يكن مطروحاً بالمطلق إلاّ من باب تقليص ميزانيات الأمن لصالح مرافق أخرى. وفي حقيقة الأمر هذا المطلب ليس جديداً، إذ إنّ هناك مناداة منذ فترة إلى تقليص ميزانية الأمن ولو بنسبة قليلة لا تؤثر على الأمن ذاته.
ويمكن ملاحظة مسألة إضافية في طبيعة هذه الحركة أنها تبغي إلى إعادة جدولة سلّم أولويات الميزانية الإسرائيلية وكيفية صرفها وليس تعديلها جذرياً، أي أن الحركة ليست ثورية مطلقاً لا في منطلقاتها ولا في جوهرها.
تداعيات حركة الاحتجاج:
مما لا شك فيه أن حركة كهذه أشغلت سياسيي “إسرائيل” وتركت بصماتها على مجمل تحركاتهم وتوجهاتهم ولو مؤقتاً لمُدّة شهر ونصف تقريباً، إذ إنه ساد شعور بخمول عام في الشارع الإسرائيلي وتقبّل المُقَدَّم من قبل الحكومات وكأنه شيء مُسلّمٌ به، وخاصّة تلويح كافّة حكومات “إسرائيل” بالأمن كذريعة لكل خطواتها الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحية. وممّا لا شك فيه أيضاً أن هذه الحركة قد أحدثت صدمة ما وبصورة محدودة على صناع القرار والرأي العام. ويُمكننا ملاحظة عدد من التداعيات في محاور عدّة منها:
1. تراجع وانخفاض شعبية نتنياهو وحكومته، وفقاً لاستطلاعات الرأي العام التي تجرى بشكل مستمر، وخاصة في فترة نصب خيام الاحتجاج في تل أبيب وسواها من مدن وبلدات في “إسرائيل”. وبالتالي أسهمت الحركة في إضعاف مكانة ودور الليكود، كحزب حاكم أوهَمَ الجماهير الإسرائيلية أنه قادر على قيادة السفينة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وهذه نقطة في غاية الأهمية إذ ستترك أثراً في حال سقوط حكومة نتنياهو (ستُحسب نقطة ضده) والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، وهذا أمر غير منظور في المستقبل القريب بالرغم من أن كثيرين توهموا حصول ذلك في أعقاب انتشار الاحتجاج.
2. تيقظ أحزاب المعارضة من سباتها العميق المُتَمَثّل في عدم قدرتها على مواجهة سياسات حكومة نتنياهو ذات الأغلبية البرلمانية المستندة على أحزاب متدينة ويمينية متطرفة.
3. لا شك أن الجمود السياسي الذي اختاره نتنياهو في مسار التفاوض مع الفلسطينيين لم يحقق ثماراً، إنما عمل على التأثير السلبي على الاقتصاد والحياة الاجتماعية، إضافة إلى ازدياد وحِدّة عُزلة “إسرائيل” إقليميّاً (جراء ثورة يناير في مصر، وحراك الشارع في الأردن، ونهج حكومة أردوغان في اسطنبول…)، إذ ساد الشعور أن “إسرائيل” مقبلة على مسلسل مواجهات دامٍ مع الفلسطينيين، وخاصة أن المصالحة التي تمّ التوقيع عليها بين فتح وحماس قد أقلقت حكام إسرائيل (بالرغم من عدم تطبيقها ميدانيّاً). لهذا يجب تحريك المسار السياسي للتخفيف من حِدّة الأزمة الاقتصادية.
4. وعطفاً على ما ورد أعلاه في البند السابق فإنّ حركة الاحتجاج لم تتطرق إلى الصراع السياسي الدائر بين “إسرائيل” والفلسطينيين والعرب، إذ حاول قياديو الحركة الامتناع كُـليّاً عن التطرق إلى مسألة الاحتلال وأعبائه وتكلفته، كي لا يتمزق شمل المُحتجين الذين انضمت إليهم قطاعات من اليمين الإسرائيلي بما فيه المتطرف جدّاً.
5. خرجت أصوات في حركة الاحتجاج تُنادي بإعادة صياغة أُسس المشروع الصهيوني المبنية على التماسك الاجتماعي، وهذا ما لوّحَت به الحركة من إعادة “دولة الرفاه” التي أسهمت في تماسك المجتمع الإسرائيلي في السنوات التالية لتأسيس “إسرائيل”. وبالتالي بعث المشروع الصهيوني من غياهب التاريخ بإعادة ما يسمى “القيم الاجتماعية والمثل العليا التي دعت إليها الصهيونية وآباؤها الأوائل”.
6. إن سقف حركة الاحتجاج لم يكن عالياً كسقوف حركات الاحتجاج أو الثورات في عدد من الدول العربية ، وخاصة في مصر. وهنا يمكن إدراك تداعيات هذا الأمر على الحركة بكونها حركة مؤقتة وتأثيرها مؤقت، وهو ليس تأثيراً على المدى البعيد. السقف المحدود هو في المطالب وبالتالي في استجابة الحكومة عليها وخاصة أن المسألة مرتبطة بقضايا مالية وميزانيات. وبمعنى آخر مطالبة الحركة للحكومة بحل أزمة السكن في تل أبيب ليبقى أهل تل أبيب فيها ينعمون برغد العيش. وهنا طرح حل من قبل نتنياهو وعدد من مسئولي حكومته (وإن كان غير رسمي إلى الآن) بأن يتم توجيه شباب تل أبيب إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث يوجد فيها آلاف الشقق السكنية، والتي ينالونها مجاناً أو بأثمان بخسة تتحول مع الوقت إلى هِبَات.
7. قد تفرز حركة الاحتجاج قوى سياسية جديدة على الساحة العامة في “إسرائيل” تمهيداً لانتخابات الكنيست القادمة. الحديث هنا عن تشكيل حركة سياسية أو حزبية مؤلفة من أبناء الطبقة الوسطى، ولكنها لا تحمل آفاقاً سياسية جديدة أو ثورية، ليقال إنها خرجت عن الإجماع السائد. وستبقى ضمن نطاق التحرُّك السياسي الصهيوني المعمول به، أي عدم التعرض للـ “البقرة المقدسة” أي الأمن الإسرائيلي.
ما ستفرزه الحركة أيضاً:
يمكننا ملاحظة سلسلة من التعديلات في عدد من المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والتي لن تزعزع أسس “دولة إسرائيل” كدولة يتحد سكانها اليهود فيما بينهم حول إجماع متفق عليه على القضايا الرئيسية.
ويمكننا أيضاً ملاحظة أن لجنة صياغة المطالب وطرح مقترحات الإصلاح “لجنة تراختنبرغ” لن تُقدّم ما هو جديد، كل ما ستقوم به هو المساهمة بصورة غير مباشرة في امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي العام، وفي هذه النقطة حصرياً فإنّ نتنياهو متفوق وناجح.
لذا، نرى أن حركة الاحتجاج قد لفتت أنظار صُنّاع القرار إلى ضرورة لجم حركاتهم وتحركاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ولم تطرح هذه الحركة قضايا الاستيطان والاحتلال وحصار غزة، فهذا أمر متروك للحكومة ولا شأن لتل أبيب وسكانها به.
ومن غير المأمول أن يحدث انقلاباً على المنظومة الحزبية في “إسرائيل” ما دام سقف حركة الاحتجاج قد حُدّد مُسبَقاً لمطالب العدالة الاجتماعية دون وضع الأصبع على الوجع الحقيقي في “إسرائيل”، ألا وهو نظام الحكم ومنظومة الرؤى سياسياً.
واضح أنّ مُحتجي تل أبيب قد رفضوا الخوض في الشأن السياسي، والأزمة هي في هذا الشأن تحديداً، ولكن هروبهم أو عزوفهم عنه لن يطول به المدى، حيث سيُطرح مستقبلاً، وستتضح الصورة أن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع الاستمرار في تحصين نفسها من تداعيات ثورات العالم العربي، ولن تكون الخيام هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور جوني منصور بخالص الشكر على كتابته النص الأساسي الذي اعتمد عليه هذا التقدير.
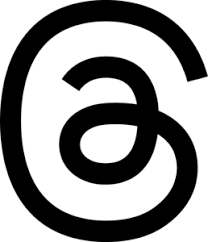

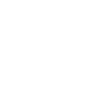
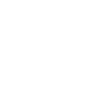

أضف ردا