بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
الحرية والتحرير أمران متلازمان، فالأرض المحتلة المستعبدة للأجنبي لا يحررها الأذلة المستعبدون لأنظمتهم ومخابراتهم؛ والأرض يحررها الأحرار وليس العبيد. فالحر الذي تحرر من قيود الخوف، وشعر بمعاني العزة والكرامة، هو من يملك الإرادة، ومن يملك الشعور بالمسؤولية، ومن يملك القدرة على المبادرة، ومن يملك أدوات الإبداع. وليس استعادة الأرض وكرامة الأمة ممكنا لمن فقد كرامته، وليس تحرير الأرض مرتبطا بعبد يائس من الحياة، وإنما بِحُرٍّ يريد صناعة حياة جديدة له ولأمته.
الأنظمة الثورية التي جاءت على ظهور الدبابات، في الربع الثالث من القرن العشرين، لقيت في البداية استجابة واسعة من الجماهير التي كانت قد يئست من الأنظمة الوراثية ومن الأنظمة المرتمية في الحضن الأميركي، فقد ظنت الجماهير أن خلاصها قد جاء على يد الأنظمة الثورية التي بررت استيلاءها على الحكم بمكافحة الفساد وبمحاربة الاستعمار وبتحرير فلسطين واستعادة المقدسات، وبتقديم نموذج حكم يلبي تطلعاتها في الحرية والتقدم والازدهار.
وإذا كانت الأنظمة الثورية قد نجحت في إزالة بعض مظاهر الهيمنة الاستعمارية، إلا أنها قدمت كشف حساب بئيس بعد فشل نماذجها الاشتراكية، وبعد قيامها بإعادة إنتاج الفساد وتدويره لطبقة جديدة فئوية أو عائلية أو طائفية، وبعد هزيمتها بشكل مهين في صراعها مع الكيان الإسرائيلي خصوصا في حرب 1967.
غير أن أسوأ ما قامت به، متفوقة على الأنظمة “الرجعية”، هو أنها أحضرت لبلادنا أسوأ ما في التجربة البشرية في إذلال الإنسان، وفي استعباد شعوبها لأجهزة مخابراتها، وأنها قتلت في الإنسان إنسانيته، وقتلت فيه معاني العزة والكرامة، وأسست أنظمة شمولية تسبّح بحمد “الزعيم الفرد الملهم”. فنشأ جيل ذليل مستعبد يسكنه الخوف، يصلح أن يتبع أذناب البقر لا أن يصعد قمم الجبال. وبذلك أرجعت حلم التحرير عشرات السنوات إلى الوراء.
هذه الأنظمة التي كيَّفت لنفسها شرعيات شعبية غير حقيقية أو مزورة، ظلت تصرّ على خطابها الثوري وشرعيتها الثورية وشعارات تحرير الأرض والمقدسات، في الوقت الذي تضخمت ثروات الزعيم، وتجمعت حوله عصابة من الفاسدين والانتهازيين، وسعى لتحويل دولته الثورية إلى جمهورية وراثية، ونخر الفساد أجهزة الدولة وكوادر الحزب الطلائعي، الذي “طلَّع” أرواح الناس؛ وكان مطلوبا من الناس أن يواصلوا “التسبيح” وأن يستمروا بعزف اسطوانات مشروخة حول الثورية والتحرر والتقدمية، بينما لا يرون حولهم سوى مجموعة من مصاصي الدماء، تحميهم سياط الأجهزة الأمنية.
النظام الذي يخاف من شعبه لا يستطيع أن يقوده في عملية تحرير، كما لا يستطيع أن يقوده في مشاريع نهضوية وحضارية. والنظام الذي يخيف شعبه، لكنه لا يخيف عدوه، لا يمكن أن يشكل أية حالة تحرير جادة، طالما أن سلاحه موجه نحو شعبه وليس نحو عدوه. وطالما بقي النظام خائفا من شعبه فسيظل أيضا خائفا من عدوه؛ لأنه يفتقد السند الحقيقي في المواجهة كما يفتقد الحضن الدافئ الذي يحميه ويدعمه ويرعاه.
إن عملية التحرير تعني تفجير طاقات الأمة وقدرتها على الإبداع، وهي عملية غير ممكنة إلا في أجواء الحرية، وهي غير قابلة للتنفيذ في أجواء الكبت والإرهاب. والأنظمة التي تقوم بإغلاق الأدمغة و”تعليبها”، أو سجنها، أو تهجيرها هي أنظمة تمنع أحد أهم وسائل استنهاض الأمة وتعبئتها ونهضتها وإعدادها لعملية التحرير.
لا يمكن الجمع بين أنظمة الاستبداد وبين مشاريع المقاومة والتحرير، لأن مشاريع التحرير هي بطبيعتها ضدّ القهر والظلم، ولأن أنظمة الاستبداد هي بطبيعتها أدوات للقهر والظلم.
إن من أسوأ ما قامت به الأنظمة الثورية أنها قتلت في الإنسان العربي ذلك الأسد الموجود في داخله، وجعلت مكانه أرنبا أو ظبيا أو عصفورا جفولا؛ وضعت في داخله رجل الأمن والمخابرات الذي يسلبه عقله وإرادته، ثم أبقت له ألفاظا كبيرة ضخمة ليتلهى بها: ثورة، تحرير، تقدمية، سلطة شعب…، لكن الويل له إن “صدَّق الكلام” وأخذ الأمور بشكل جاد، لأنه عند ذلك سيقبض عليه متلبسا بالعمالة والخيانة والرجعية، وسيعدّ من أذناب الاستعمار!!
الأنظمة الثورية التي ظهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ورفعت شعارات التحرر والتحرير، انشغلت معظم الوقت بتثبيت نفسها وسحق خصومها، أما كشف حسابها في حرب حزيران 1967 فكان من أسوأ ما شهده العرب في التاريخ المعاصر والحديث والوسيط والقديم؛ كان كارثة بكل المقاييس عندما ضاعت باقي فلسطين والجولان وسيناء، لأن هذه الأنظمة لم تكن تدرك، أو لا تريد أن تدرك، أن الإنسان الذي أذلته وأفسدته، هو إنسان لا يمكن أن يحمل مشروع تحرير.
ومع ذلك فقد استمر بعض هذه الأنظمة في التغني أن “إسرائيل” كانت تستهدف إسقاط النظام الثوري، وأنه بالرغم من ضياع الأرض فإن النظام نجح في البقاء ليتابع منجزاته!!
ربما يثير التساؤل معرفة أن سقوط قطاع غزة قد استغرق يوما واحدا أو يومين سنة 1956وسنة 1967، واستغرق سقوط سيناء (وهي ضعفا مساحة فلسطين التاريخية) يومين سنة 1967، واستغرق سقوط الجولان سنة 1967 (وهي أحد أقوى خطوط الدفاع في العالم) يوما واحدا؛ أما سقوط بغداد سنة 2003 فلم يستغرق سوى “مسافة السكة”، حيث سقطت بشكل مهين ودون مقاومة. لماذا؟ على الزعماء “الملهمين” الذين كانت تنتظرهم هذه اللحظات التاريخية أن يجيبوا؟
من حقنا أن نقارن وأن نتساءل لماذا صمدت بيروت سنة 1982 أكثر من ثمانين يوما؟ ولماذا صمد مخيم جنين (نحو كيلومتر مربع واحد فقط) في الضفة الغربية 11 يوما سنة 2002؟ ولماذا صمد جنوب لبنان 33 يوما في حرب تموز 2006؟ ولماذا صمد قطاع غزة 23 يوما في حرب 2008-2009؟ …، كلها صمدت في وجه هجمات صهيونية شرسة عاتية؟ وكيف صمدت الفلوجة في العراق بشكل بطولي في وجه أقوى جيوش العالم “الأميركيين” ولنحو شهر في ربيع 2004؟ ما الذي تغير؟ إنه “الإنسان”، الإنسان المؤمن الحر العزيز الذي يملك إرادته وقراره، والذي قاتل بإمكانيات أقل، بعيدا عن وصاية الأنظمة الثورية، فضلا عن وصاية الأنظمة الدائرة في الفلك الأميركي.
إن جوهر الفكرة الإسلامية يقوم على أساس “تحرير الإنسان”، وذلك “بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد”؛ وهي العبارة التي ذكرها الصحابي ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد جيوش الفرس، عندما سأله عن سبب قدوم جيوش المسلمين. إنه تحرير الإنسان من عبادة الأوثان والزعماء والهوى والمال وأي من المخلوقات، مع إيمان راسخ أن الرزق والموت والحياة هي بيد الله وحده، والنتيجة: صناعة إنسان حرّ عزيز كريم، لا يخشى من بشر على حياته وماله.
وهذه نقطة البدء ومنطلق أية عملية بناء حضاري، أو تشكيل نظام سياسي صحي، يمثل بشكل حقيقي هموم الجماهير وآمالها؛ وهي المنطلق لأن يمارس الإنسان كافة حقوقه السياسية والمدنية دونما استجداء، وأن يحاسب حكامه وزعماءه دونما خوف أو اضطراب؛ وهي أساس الشعور بالحق وواجب حفظه وحمايته.
إن من أعلى المقامات في الإسلام مقام العبودية لله، وهو الوجه الآخر للتحرر مما سواه. وعندما وصف الله سبحانه في فواتح سورة الإسراء الفئة التي ستقوم بهزيمة بني إسرائيل فإنه قال “عبادا لنا أولي بأس شديد”؛ فهم لا يركعون إلا لله ولا يذلون إلا إليه، وهم المؤهلون فعلا للنصر والتحرير.
وعندما مدّ بنو إسرائيل ألسنتهم لموسى عليه السلام قائلين “اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون”، كانوا يعبرون عن حالة العبودية والذل التي أصابتهم تحت حكم الفراعنة، فلم يعودوا صالحين ولا قادرين ولا راغبين في قتال “القوم الجبارين”؛ عند ذلك رفع موسى يده إلى السماء ليشكو إلى الله أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه هارون. فكان القرار الرباني أنّ هذا الجيل المطبوع بالذل والجبن يجب أن يُغيَّر -بعد تيهٍ لمدة أربعين سنة- بجيل جديد ينشأ في الصحراء حرا من المخاوف والقيود، حتى يتمكن من أداء المهمة.
يحقق المستعمر نصرا جزئيا باغتصاب الأرض، ولكنه يبقى نصرا مؤقتا، أما نصره الكامل فلا يتحقق إلا إذا اغتصب من الإنسان إنسانيته وروحه وكرامته وإرادته، وعند ذلك يستطيع الاطمئنان إلى طول بقائه.
ويقوم المستعمر باحتلال الأرض ويمنع ابن هذه الأرض من حقه فيها، ومن حكمه إياها، ومن حقه في تقرير مصيره، ومن حريته في التصرف بموارده وثرواته. وقد يمنعه من حرية التنقل والعمل، ومن العمل السياسي، ومن التعبير عن الرأي، وغير ذلك.
ألا ترى أن الأنظمة الثورية، التي تجمع الثلاثي المشؤوم المكوّن من الظلم والاستبداد والفساد، تلتقي مع المستعمر في جوهر فعلها، في فكرة إذلال الإنسان وحرمانه من حقوقه؟ إن الإنسان يفقد إنسانيته وكرامته في كلتا الحالتين…، والفرق الجوهري أن الجريمة في الحالة الأولى يرتكبها المستعمر الأجنبي، وفي الحالة الثانية تكون صناعة محلية (تستفيد من أسوأ ما لدى الخبرات الأجنبية). وسواء كان ذلك طربوشا أم عقالا أم قبعة أم خوذة أم شعرا منكوشا، فإن الظلم هو الظلم، والاستبداد هو الاستبداد، والفساد هو الفساد.
تلك الأنظمة التي تتحدث باسم الجماهير وغصبا عنها، وتقول إنها تعبر عن تطلعاتها في التحرير والاستقلال، يجب أن تكون صادقة مع نفسها ومتوافقة مع ذاتها في التعبير عن تطلعات الجماهير أيضا في توفير العدالة والحرية والكرامة في بلدانها، فالأمران صنوان متلازمان. ولذلك فإن عقلية الوصاية التي تمارسها الأنظمة الثورية الشمولية يجب أن تذهب وتزول.
إن أولئك الذين جاؤوا على ظهر دبابة ليتحدثوا باسم الجماهير، عليهم أن يقدموا كشف حسابهم لهذه الجماهير، وعليهم أن يرضخوا للإرادة الحرة لهذه الجماهير التي لها الحق في محاسبتهم ومعاقبتهم وإزاحتهم، إذا ما كشفت فشلهم وفسادهم وتزويرهم لإرادتها. ولا خيار لهذه الأنظمة إلا المسارعة في عملية إصلاحية حقيقية، أو أن تتوقع ثورة شعبية تطوي صفحة هذه الأنظمة.
أما ما يثير السخرية والرثاء فهو ما ينادي به بعض منظري الأنظمة الثورية من أن الجماهير لم تنضج بعد لممارسة العملية الديمقراطية، وهو ما يعني أنهم يرغبون في البقاء جاثمين على صدور الناس إلى ما لا نهاية، دون الاستناد إلى أية شرعية معتبرة سوى شرعية القهر والقوة.
وبالرغم من أن الإنسان في بلداننا العربية يعود في عمقه وإبداعه الحضاري إلى أكثر من خمسة آلاف عام، فإنه ما زال برأيهم غير مؤهل لممارسة عملية شورية ديمقراطية، مع أن الناس في مجاهل الغابات الاستوائية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، الذين تحضروا منذ سنوات قليلة، يمارسون هذه العملية بحرية كاملة في بلدانهم.
إن أكثر من أربعين أو خمسين عاما من الحكم الثوري والشمولي لم تزد فيها الممارسات الديمقراطية إلا تخلفا، ولم تزد الحياة السياسية فيها إلا فسادا، وبالتالي فلا بيئة صحية ممكنة لإنضاج عملية ديمقراطية في أجواء شمولية قمعية فاسدة؛ لأن هذه الأنظمة هي سبب المشكلة وليست أداة حلها.
إن حديث هذه الأنظمة عن عدم نضج الجماهير لممارسة اللعبة الديمقراطية هو تعبير عن فشل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية في أداء مهامها في التوعية وفي إعداد الناس، وهو محاولة لإخفاء الفشل والهرب من المحاسبة والسعي للاستمرار على الكراسي بعكس إرادة الناس.
وبالطبع فإن هذا المقال يركز فقط على الأنظمة الثورية، أما الأنظمة الأخرى الموجودة أصلا في الحضن الأميركي، فربما تمّ تسليط الضوء على دورها في مقال آخر، لكنها في كل الأحوال لا تدَّعي الثورية ولا تتأبط مشاريع التحرير، ولا تضع نفسها في موضع المقاربة التي نناقشها.
وباختصار، فإنه لا يحق للأنظمة التي ترفع شعارات تحرير الأرض أن تقوم باستعباد شعوبها، لأن ذلك هو النقيض الجوهري لمشروع التحرير. وقد تصبر بعض الشعوب على مرارة المعاناة والحرمان، وعلى الصلاحيات الواسعة للقيادة لإعطاء فرصة لتنفيذ برامج فعالة جادة، لكن من الطبيعي أن تنفجر هذه الشعوب في وجه أنظمتها الثورية، عندما تفقد هذه الأنظمة مبرر وجودها، وتنكشف عن أنظمة قمعية عائلية أو طائفية أو فئوية فاسدة، تحاول التخفي تحت غلالة رقيقة من الشعارات المهترئة.
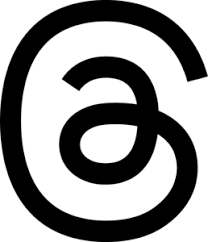

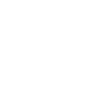
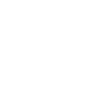
أضف ردا