بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
عند الحديث عن أزمات تواجهها حماس أو فتح فإن ذلك يجب أن يوضع في إطاره الحقيقي، وليس من الإنصاف الانشغال باتهام هذا الطرف أو ذاك، فكلاهما قدّم الكثير لقضية فلسطين وشعبها.
وجوهر المشكلة هو الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من قتل وتدمير وسجن وحصار وتجويع لشعب فلسطين، ومن تهويد لأرضها. وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو في كيفية التخلص من الاحتلال.
وتقدم الحركتان برنامجين مختلفين أحدهما (فتح) يستند أساساً إلى خطة التسوية، والآخر (حماس) يستند أساساً إلى خط المقاومة. وإذا كان ثمة حديث عن أزمات فهو في حقيقته تعبيرٌ عن عملية إدارة كلّ منهما لبرنامجه ضمن الظروف المتاحة، وما يواجه كل برنامج من عقبات وتحديات.
غير أن المشكلة تزداد تعقيداً إذا تعلق الأمر بمشاكل بنيوية داخلية أو قلة الخبرة أو بسوء الإدارة لدى أيٍّ من الطرفين.
يحلو للبعض تصوير المشهد الفلسطيني من خلال التركيز على أزمة الحكومة التي تقودها حماس. وهو تصوير يجتزئ الصورة العامة، فلعلّ غيرها يعاني أزمات أكبر منها.
تعاني حماس من ثلاثة إشكالات رئيسية، الأولى: مرتبطة بالحكومة الفلسطينية التي تقودها وما تواجهه من مشاكل من خصومها السياسيين وخصوصاً رئاسة السلطة وفتح، ومن عدم كونها طرفاً مقبولاً لدى أطراف رسمية عربية ودولية، ومن شتى أنواع الحصار، والثانية: في إشكالية الجمع بين خطي السلطة والمقاومة، والثالثة: في عدم توفر أجواء محلية مستعدة لإشعال انتفاضة واسعة جديدة، مما يجعلها مضطرة للتعامل أكثر مع الخيارات السياسية في المرحلة الحالية على الأقل.
غير أن المدقق في أزمة حماس هذه سيجد أنها من النوع المرتبط بإدارة المرحلة وأجوائها، ولا علاقة له ببنية حماس.
ورغم أنه من السابق لأوانه الحكم على حكومة لا يزيد عمرها على بضعة أشهر، فإن شتى الضغوط لم تفلح في إجبارها على التنازل عن أيٍّ من ثوابتها، فضلاً عن أنها في ممارستها للحكم ظلت تقدم نماذج شفافة بعيدة عن الفساد المالي والسياسي والإداري.
إن جوهر الأزمة التي تواجهها حماس ليس له علاقة بشرعيتها أو كفاءة حكومتها (من بين 22 وزيراً هناك 14 من حملة الدكتوراه) ولا نظافتها، ولكنه يعود إلى عدم الاستجابة لمجموعة شروط وإملاءات إسرائيلية أميركية.
كما يعود إلى وجود طرف فلسطيني منافس وقوي، لا يزال يملك رئاسة السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتدين له بالولاء الأجهزة الأمنية، ومعظم موظفي السلطة يتبعون خطه، ويمارس سلوكاً على الأرض يسعى من خلاله إلى إسقاط حكومة حماس والحلول مكانها بالسرعة الممكنة.
وهو يستطيع بسهولة، من خلال استخدام صلاحيات رئاسة السلطة، أو عدم تنفيذ الأوامر الإدارية في الوزارات والمؤسسات، أو السلوك الأمني المشاكس، أن يعطل أو يعوّق عمل الحكومة.
من الناحية القانونية فإن الحكومة الفلسطينية هي معنية بتسيير الشؤون الحياتية للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وقد جعلت اتفاقات أوسلو منظمة التحرير وليس السلطة هي الجهة المعنية بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي وبالتفاوض معه؛ ولم يطالب أحدٌ حكومات السلطة الفلسطينية السابقة التسع بالاعتراف بإسرائيل أو نبذ الإرهاب.. كما أن اتفاقات أوسلو وما تلاها من علاقات وترتيبات لم تلزم حركة فتح بالشروط التي يتم الآن مطالبة حماس والحكومة التي تقودها بها.
وبعبارة أخرى، فإن الحصار الإسرائيلي الأميركي (والعربي إلى حدٍّ ما) هو حصار يفتقد مبرره القانوني، حتى وفق معايير اتفاقات أوسلو نفسها؛ وهو حصار مرتبط بوجود حماس في الحكومة.
ولذلك فإن الكلام عن حكومة وحدة وطنية يصبح بدون معنى (إذا ما أريد مراعاة الشروط الإسرائيلية الأميركية) ما دامت حماس تشارك في الحكومة ولو بعضو واحد!! وهو ما ذكره الأميركان لمحمود عباس عندما زار نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وليس رفض حماس للمبادرة العربية هو السبب الحقيقي لحالة الجفاء والبرود من عدد من الدول العربية. فهذه المبادرة رفضتها إسرائيل منذ اليوم الأول لإعلانها قبل أكثر من أربع سنوات، كما تجاوزتها الرباعية أي أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة بتبنيها مشروع خريطة الطريق، فضلاً عن أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، أعلن عن وفاة عملية التسوية.
ولكن خط المقاومة الذي تمثله حماس، ومشروعها الإسلامي، وامتداداتها الإخوانية بالإضافة إلى الضغوط الأميركية على الدول العربية، هو السبب الفعلي لمحاولة عزل حماس عن محيطها العربي.
إن أزمة حماس مرتبطة بوجودها في موقع متعارض مع المتطلبات والشروط الإسرائيلية الأميركية، وهو شهادة حسن سلوك قبل أن يكون عريضة اتهام.
إذا ما تمّ حصر أزمة حماس بما يتم التركيز عليه الآن من عدم قدرتها على إدارة الحكومة، ومن عدم قدرتها على توفير رواتب الموظفين فضلاً عن حالة الحصار والعزلة، فيمكن لحماس أن تخرج من الأزمة من خلال ترك الحكومة، والعودة إلى خط المقاومة، وممارسة دورها الرقابي في المجلس التشريعي.
ولكن حماس تدرك، كما سيدرك ناقدوها ومحبوها الراغبون بخروجها من الحكومة، أن الأمر غير مرتبط في جوهره بإدارتها للحكومة، وإنما بوجودها نفسه وببرنامجها وبخطّها المقاوم.
وستكون من مهام أية حكومة فلسطينية جديدة (ترضى عنها إسرائيل وأميركا) وترغب بالاستمرار بمسار التسوية وخريطة الطريق، أن تنفذ أولى مستلزماتها وهو القضاء على ما يسمى الإرهاب ونزع أسلحة المقاومة، وبالتالي إدخال الوضع الفلسطيني في صراع من نوع جديد وأزمات جديدة.
وسيتحول اتهام حماس من كونها سبباً في منع رواتب الموظفين إلى كونها عقبة في طريق التسوية وحلم الدولة الفلسطينية وهو الاتهام القديم المتجدد، وهو ما يعني عملياً أزمة جديدة لحماس!
البرنامج الذي تحمله حماس (الذي هو سبب أزمتها) هو نفسه سبب شعبيتها!! وإن إصرارها على خط المقاومة ورفض الاعتراف بإسرائيل هو سبب احترامها بين قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي.
وبالتالي فما يتمّ تسويقه على أنه أزمة حماس هو في الحقيقة جانب من التحديات التي يواجهها المشروع الذي تحمله، وليس عليها سوى التعامل مع المرحلة بما يناسبها، بعد أن نجحت في كسب الشرعية السياسية والشعبية لبرنامجها.
وهي على أي حال هي تدرك أن المرحلة هي مرحلة تضحيات وليس جني مكاسب، يساعدها في ذلك بنية تنظيمية متماسكة، ودينامية عالية، وعدم تلوثها بملفات الفساد والتنازلات.
أما المدقق في أزمة فتح فسيجد أن مشكلتها أعقد بكثير من مشكلة حماس، إذ تعاني فتح أولاً من مشكلة بنيوية تنظيمية حقيقية، ومن حالة تشرذم داخلي ومن صراعات وصلت حد الاغتيالات والتصفيات.
ومنذ سنة 1989 لم تنجح فتح في عقد مؤتمرها العام، وشهدت انتخاباتها الداخلية وانتخابات اختيار من يمثلها في المجلس التشريعي (البرايمرز) ممارسات لا تليق بحركة عريقة مثلها. وكان الكثير من عناصرها يشكون من تفرُّد ودكتاتورية رئيسها ياسر عرفات، لكن الوضع زاد سوءاً بعد وفاته.
وتعاني فتح ثانياً من تآكل رصيدها النضالي، إذ أن فتح التي نشأت لتحرير الأرض غرب الضفة الغربية (الأرض المحتلة 1948) تنازلت عن هذا الهدف، فقد قامت قيادتها (التي تقود م. ت. ف) بالاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود على 77% من أرض فلسطين، وأعلنت نبذ الإرهاب ووقّعت على اتفاق أوسلو وقادت تيار التسوية، واضطرت لقمع حركات المقاومة إيفاءً بالتزاماتها تجاه إسرائيل. وظهرت فيها مجموعات ورموز على علاقات سياسية واقتصادية وأمنية بالإسرائيليين.
ولا شك أن مجموعات كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح شاركت بفعالية في الانتفاضة، لكن فتح لم تعد كما كانت من قبل (عندما قدمت حتى نهاية سبعينيات القرن العشرين نحو 80% من شهداء الثورة الفلسطينية وأسراها) بعد أن نافسها أو تجاوزها أداء حماس العسكري في انتفاضة الأقصى، كما أن برنامجها النضالي أصبح باهتاً بعد أن اختلط بمشاريع التسوية وبالعلاقة مع الإسرائيليين.
ومن جهة ثالثة تعاني فتح من حالات استشراء الفساد في أوساط العديد من عناصرها، وخصوصاً تلك التي حصلت على مناصب ومواقع في السلطة الفلسطينية.
وهي ملفات كثيرة، وتكفي الإشارة لتقرير المجلس التشريعي سنة 1997 الذي أكد سرقة 326 مليون دولار، وهو مبلغ هائل قياساً بميزانية السلطة الضئيلة، مما جعل التشريعي يحجب الثقة عن حكومة عرفات (56 صوتاً مقابل صوت واحد) ولكن الرئيس عندما شكّل حكومته الجديدة، احتفظ بمعظم الوجوه المتهمة بالفساد مع إجراء بعض التنقلات في مواقعها.
ويوم 5 فبراير/ شباط 2006 كشف النائب العام عن خمسين قضية فساد، وأن أكثر من 700 مليون دولار أُهدرت فيها. أما فضيحة بيع الإسمنت الفلسطيني إلى الإسرائيليين الذي استخدموه في بناء المستوطنات والجدار العازل، فهي فضيحة معروفة والمتورطون فيها شخصيات كبيرة في السلطة وفتح.
كان الإجماع على وجود فساد في السلطة التي تقودها فتح واستشراء مظاهره من أكبر مظاهر الإجماع الفلسطيني، إذ وصل إلى 81% حسب استطلاعات الرأي لمؤسسات معتمدة محسوبة على اتجاهات علمانية متوافقة مع خط السلطة المؤيد لأوسلو.
وهو ما اضطر قيادات فتحاوية كبيرة مثل محمد جهاد إلى القول إن عرفات قد أحاط نفسه بثلة من اللصوص والمبتزين، أو حسام خضر الذي وصف المقربين من أبي عمار بأنهم عصابة من المافيا.
ولعل أحد أهم أسباب فوز حماس في الانتخابات التشريعية هو حالة الترهل والفساد التي تشهدها فتح نفسها. وهو ما يملي على العناصر النظيفة والغيورة في فتح مسؤولية إصلاح البيت الفتحاوي.
تجربة فتح في الحكم وخصوصاً في السلطة الفلسطينية هي من جهة رابعة لا تقدم نموذجاً مشجعاً سواء في الإدارة السياسية أم الاقتصادية أم الأمنية للملفات المختلفة. وهي ملفات يستحيل تقييمها في هذا المقال.
وقد سلكت فتح سلوكاً حزبياً في إدارتها للسلطة، وتبنّت التعيينات السياسية والإدارية والأمنية على أساس الولاء أو الانتماء لفتح. وهو ما جعل فتح نفسها تعاني من أزمة دخول الكثير من أصحاب المصالح والمتسلقين إلى صفوفها.
وأكتفي هنا بالإشارة إلى أن استطلاعات الرأي، أثناء إدارة فتح للسلطة، كانت تعطي وعلى فترات مختلفة تقييماً سلبياً للديمقراطية الفلسطينية لا يتجاوز 20-30%، وكان نحو 20% فقط يعتقدون بوجود حرية صحافة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2003 كان 61.4% من الفلسطينيين في الضفة والقطاع يقيمون أداء السلطة بين سيئ وسيئ جدا.
وفي أحد استطلاعات الرأي في يونيو/ حزيران 1999 كان هناك 4% فقط يعتقدون أنهم لا حاجة لهم للواسطة للحصول على العمل أو لقضاء مصالحهم، كما ذكر 54% أن وضعهم الاقتصادي صار أسوأ مما كان عليه قبل اتفاق أوسلو سنة 1993.
ويستطيع القارئ الرجوع إلى نتائج مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في نابلس ومركز القدس للإعلام، والاتصال لمزيد من التفصيلات.
ويعني هذا أنه إذا كان ثمة أزمة في حكومة حماس، فلا يعني ذلك أن الجمهور سيكون سعيداً بحكومة لفتح وفق المواصفات السابقة.
أما المشكلة الخامسة فهو أنه لو افترضنا جدلاً أن تبني حكومة حماس لخيار المقاومة وعدم الاعتراف أدى لأزمتها، فإن مسار التسوية نفسه الذي تبنته فتح هو أحد أهم أسباب أزمتها.
إن مسار التسوية يعاني من انسداد الأفق ومن حالة فشل كبيرة، ومن غضب فلسطيني أدى لاندلاع انتفاضة الأقصى، ومن استغلال الشريك الإسرائيلي بصورة بشعة لعملية التسوية في مضاعفة الاستيطان وتهويد القدس، وجعل المقاومة تبدو وكأنها إرهاب، وفي تسويق إسرائيل لنفسها عربياً ودولياً، مع عزل وإضعاف الجانب الفلسطيني.
ولذلك فإن على المستعجلين من فتح إسقاط حكومة حماس أن يدركوا أنهم لن يستلموا سوى كرة لهبٍ، وأن أزمتهم ستكون أكبر، فكيف ستقدم فتح نفسها وهي تعاني من التشرذم والفساد وانسداد مسار التسوية، وماذا ستفعل عندما تُطَالب بسحق حركات المقاومة ثمناً للتسوية؟!
إن الوضع الفلسطيني لن يلبث بعد ذلك أن يُحبط مرة أخرى من مشروع تسوية يحوي بذور فشله في ذاته. وهو إحباط سوف يعبر عن نفسه في انتفاضة جديدة ستعيد حماس إلى الواجهة بشكل أقوى وأوسع شعبية.
وختاماً، فإن انتقال إدارة الملف الفلسطيني من يد حماس إلى فتح لن يؤدي إلاّ إلى الدخول في أزمة أو أزمات من نوع جديد، لأن أصل المشكلة يكمن في الاحتلال وحلفائه وفي التخاذل العربي والإسلامي.
ولذلك فإن الأولى أن يتفق الفلسطينيون على برنامج يوحّدهم على قياساتهم الوطنية والإسلامية، وليس على القياسات الإسرائيلية أو الأميركية.
وهو ما يدعو إلى السعي بكل الطرق إلى حكومة وحدة وطنية تفرض نفسها على الجميع، وترفع السقف السياسي الفلسطيني. أو على الأقل ألا ينشغل طرف فلسطيني بإسقاط وإفشال طرف آخر، عن مواجهة العدو المشترك.
المصدر: الجزيرة نت 26/10/2006
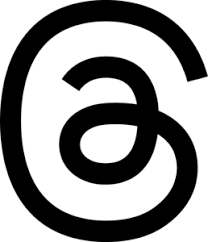

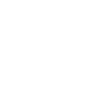
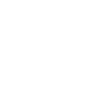
أضف ردا