بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 
لا أدري لماذا وضع الأخ الدكتور محمد اشتية نفسه في هذا الموقف الصعب، بالموافقة على تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية “الثامنة عشرة”.
والدكتور اشتية من ألمع القيادات الفتحاوية، وأكثرها كفاءة وخبرة، ويحمل الدكتوراه في الدراسات التنموية، وعمل وزيراً للأشغال ورئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)؛ وخطابه السياسي منفتح، ولا يميل لتوتير الأجواء مع مخالفي فتح، كما يفعل بعض زملائه في قيادة فتح. وكان الأولى بمثله أن يأتي لحكومة تعزّز الوحدة الفلسطينية الشاملة، وتكرس التوافق، وتنفذ اتفاق المصالحة، وليس رئيساً لحكومة تُعزّز الانقسام، وتحاول فرض أجندة فصيل معيَّن على “الكل” الوطني.
منذ البداية، وقبل تشكيلها، تحول مشروع حكومة اشتية المرتقبة إلى حكومة “أزمة” وحكومة “مأزق”، و”وصفة للفشل”؛ ذلك أن الأسس والظروف التي قامت عليها جعلت أقدامها من “طين”، ولم توفر لها الحد الأدنى للنجاح.
من الناحية الرسمية، طلب الرئيس عباس من اشتية في كتاب التكليف دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية و”إعادة غزة لحضن الشرعية الوطنية”، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإجراء الانتخابات التشريعية في محافظات الوطن (الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة)، “لترسيخ الديموقراطية والتعددية السياسية”. أما اشتية الذي قبل التكليف، فقد ذكر في خطاب القبول أنه يقبله باسم حركة فتح، موجهاً رسالته إلى عباس باعتباره ليس فقط رئيساً لمنظمة التحرير ولدولة فلسطين، وإنما أيضاً باعتباره رئيساً لحركة فتح!! ودون أن يشير رسمياً إلى كون عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية. وأكد اشتية على العمل مع الشركاء في منظمة التحرير على إنفاذ البرنامج الوطني، كما أكد على “الشرعية الواحدة والقانون الواحد”.
حكومة أزمة:
جاء تكليف اشتية بتشكيل حكومة في ظل أزمة عميقة للمشروع الوطني الفلسطيني، وفي ظلّ تعطّل وتدهور منظمة التحرير ومؤسساتها، وفي ظل تحوّل السلطة الفلسطينية من مشروع يهدف إلى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أرض فلسطين المحتلة سنة 1967، إلى سلطة وظيفية تخدم أغراض الاحتلال الإسرائيلي أكثر مما تخدم مشروعها الوطني؛ وفي ظل فشل القيادة الفلسطينية في إنفاذ اتفاق المصالحة ومترتباته؛ وفي ظل فشل حكومة رامي الحمد الله على أداء مهامها، والتي يفترض أن تكون قائمة على “التوافق الوطني”.
فالخط الذي اختطته الحكومة السابقة عبّر عملياً عن سياسة الرئيس عباس أو توجهات حركة فتح، فسعت لتطويع حماس ولفرض سياسة انتقائية في تطبيق المصالحة، ومتابعة تنفيذ قرارات وبرامج لم تثر غضب أو حفيظة حماس والجهاد الإسلامي فقط، وإنما أيضا الفصائل الأساسية الشريكة في منظمة التحرير كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية.. وأصرت، بخلاف معظم القوى والفصائل الفلسطينية، على متابعة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وعلى استمرار العقوبات على قطاع غزة. وهو ما أدى إلى مقاطعة هذه القوى الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني.
ولم تكن قيادة فتح بعيدة عن تصعيد التأزيم، عندما قضت “المحكمة الدستورية” في رام الله بحل المجلس التشريعي الفلسطيني؛ وهو ما رفضته معظم القوى والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أن خبراء القانون الدستوري الكبار طعنوا في شرعية حكم المحكمة الدستورية. كما أن معظم الفصائل رفضت المشاركة في الانتخابات الفلسطينية بناء على حكم الدستورية.
وهكذا جاء تشكيل حكومة اشتية في بيئة سياسية مأزومة، تعاني فيها حركة فتح نفسها من مزيد من العزلة في الوسط الفلسطيني. فهل كان من المناسب الإيغال في سياسات التأزيم ذاتها من خلال استبعاد حماس، ومحاولة تشكيل حكومة لا تملك فرص دعم ومشاركة الفصائل الأساسية في المنظمة؟! وكيف ستتمكن هكذا حكومة من “استعادة الوحدة الوطنية” وفق كتاب التكليف، إلا إذا كانت تظن أن حماس ستخضع لإملاءاتها، وأنها ستأتيها وهي “شالحة”، على حدّ تعبير سابق قيادي فتحاوي كبير.
الفصائل الفلسطينية الأساسية في المنظمة رفضت بالفعل المشاركة في الحكومة المرتقبة قبل أن يتم تكليف اشتية بتشكيلها، باعتبارها تُكرِّس الانقسام وتُعقد الأزمة. وعلى هذا الأساس، صدرت تصريحات رسمية من الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية والمبادرة الوطنية. وعندما جاء كتاب التكليف جاء ليعمق القلق بشأن مسارات المصالحة، إذ لم يُشر إطلاقاً إلى وثيقة الوفاق الوطني ولا إلى اتفاق المصالحة، بينما جاءت موافقة اشتية باسم فتح، لتحدد مجالات تشكيلها بأعضاء منظمة التحرير فقط.
حكومة مأزق:
كان يُفترض لأي حكومة جديدة على رأس مهامها إجراء انتخابات ديمقراطية، أن تكون حكومة توافق تتمتع بأوسع حالة إجماع وطني، وتوفر بيئة سياسية صحية، وأجواء انتخابية نزيهة تبعث على الثقة. غير أن التكليف بتشكيل حكومة فصائلية بقيادة فتحاوية، كان خطوة للوراء، وضربة للأجواء المطلوبة لأي انتخابات تتمتع بالمصداقية. وهكذا، فإن مثل هذه الحكومة إن تشكلت ستُعبّر عن “المأزق” الفلسطيني، ولن تكون مَعْبَراً للخروج منه. وستُكرّس فشل المنظومة السياسة الفلسطينية، التي يُصرّ فصيل واحد على الانفراد بقيادتها منذ أكثر من خمسين عاماً.
لا ندري كيف ستحقق حكومة اشتية “الوحدة الوطنية”، إذا كانت الفصائل الوطنية والإسلامية لن تشترك فيها؟
ولا ندري كيف ستجري انتخابات فلسطينية ديمقراطية تعبر عن “التعددية السياسية”؛ إذا كانت معظم الفصائل الفلسطينية ستقاطعها؟
وهل تستطيع حكومته إجراء الانتخابات بعيداً عن قطاع غزة الذي تهيمن عليه حماس؟ وكيف تطمئن القوى الفلسطينية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ما دامت الضفة تدار في أجواء تُطارِد قوى المقاومة وتيارات “الإسلام السياسي” وتتابع التنسيق الأمني؟!
وإذا كان الأسلوب الذي تمّ به وعلى أساسه اختيار اشتية لرئاسة الحكومة يعني متابعة الإجراءات والعقوبات ضدّ حماس وقطاع غزة، من خلال أساليب التطويع، فإن عناصر تأجيج وتفجير الوضع الداخلي الفلسطيني ستبقى قائمة، وستجد حكومة اشتية نفسها أداةً رئيسة في عملية المواجهة، ولذلك فيمكن القول إنها “ضمنت الفشل” في تحقيق الوحدة الوطنية أو التعددية السياسية.
وصفة للفشل:
في الأجواء التي تعصف بقضية فلسطين، وفي بيئة ما يسمى “صفقة القرن”، وأجواء التطبيع، والغطرسة الصهيونية؛ يحتاج الفلسطينيون لاستجماع قواهم وتجاوز خلافاتهم لمواجهة هذه التحديات. أما أن يتم تشكيل حكومة ذات لون واحد تواجه المخاطر الكبرى بأدوات تثير غضب الشارع الفلسطيني، وتكرس تمزيق الساحة الفلسطينية، وإهدار الطاقات، وإضعاف المناعة وعناصر القوة؛ فإنها ستكون أفضل “وصفة للفشل”.
ولا تملك الحكومة في رام الله ترف تجاهل التيار الشعبي الأوسع، ولا تجاهل القوى الوطنية والإسلامية العاملة على الأرض، المطالِبة بالتوافق الوطني، وبوقف التنسيق الأمني، وبرفع العقوبات عن قطاع غزة، وبعدم المساس بسلاح المقاومة.. وهي ترى بنفسها استطلاعات الرأي التي تصبُّ في هذا الاتجاه.
وبالتالي، سيكون ظهر حكومة اشتية مكشوفاً بشكل أكبر، في مواجهة المشروع الصهيوني المُتغوِّل والمتطرف وبرامجه في التهويد والاستيطان، والذي سيتابع الضغط عليها لمتابعة أدائها الوظيفي الحامي لأمنه واستقراره، وسيكون ظهرها مكشوفاً أكثر في مواجهة الحملة الأمريكية التي تستهدف إنفاذ “صفقة القرن”، وإنجاز التطبيع، وتضييع القدس وحقّ العودة، وإغلاق الملف الفلسطيني.
وستواجه اشتية، وهو الخبير الاقتصادي، مهمة اقتصادية عسيرة في ظلّ الاختلالات الهائلة لصالح الاحتلال التي فرضها بروتوكول باريس، وفي ظلّ تفشي الفساد في السلطة، الذي يؤكده 80 في المئة ممن تستطلع آراؤهم. وفي ظلّ اعتماد السلطة على أكثر من 80 في المئة من دخلها على إيرادات “المقاصة” التي يجمعها الاحتلال وعلى الدعم الخارجي، وفي ظلّ أن نحو 58 في المئة من وارداتها و83 في المئة من صادراتها هو مع دولة الاحتلال؛ وفي ظلّ القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.
هذه الحكومة التي يتم تحميلها مهام تنوء منها الجبال، هي عملياً ستقوم بضرب الرصاص على ساقيها، عندما تعمل بعيداً عن الغالبية الوطنية الشعبية، في منظمة التحرير ومن خارجها.
وإذا كان ثمة كلمة ناصح للدكتور اشتية، فهي أن تكون بما لديك من خبرة ومهارات وقدرة على استيعاب المخالفين جسراً للعبور الوطني نحو مصالحة حقيقية؛ أما وأن البيئة والشروط التي قامت عليها تكليفك بحكومة ستؤدي إلى مزيد من التأزيم والأزمات والفشل، وستكون أنت عنواناً لذلك، فالأولى أن تعتذر عن متابعة هكذا مهمة.
المصدر: موقع “عربي21″، 2019/3/15
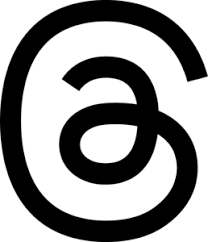

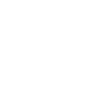
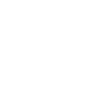
لماذا يكون المرء متهما دايما سواء أعلن انه من فتح أو أعلن انه لا يعمل في حكومته على أساس فصائلي ؟ لم يتجاهل من يرون أنفسهم اصحاب رأي وازن الطرف الذي افشل كل محاولة جدية لإنهاء الانقسام ويتهمون الطرف الذي سعى لإنهاءه بانه يعمق الانقسام؟ أليس مما يزيد عدم ثقتنا بالآراء المضللة والغير منطقية تعاميها عن ممارسات تعمق الانقسام مثل قمع حراك بدنا نعيش ومحاولات الاغتيال الحمدالله وفرج وحلس وما خفي كان اعظم.؟ ولم يكون قرار حل التشريعي غير شرعي والمحكمة لديها اختصاص حله إذا نظرنا لاختصاصها وفق القانون الفلسطيني وليس التفسير الأمريكي الاخواني؟ من حقنا ان ننتمي لما نومن به ولم نطالب احد بالانتماء له قسرا لا تحاسبوا على انتماءنا ولكن على أخطاءنا وامتلكوا الشجاعة والنزاهة لتفعلوا ذلك مع طرف الاستبداد والانقسام الحقيقي ولا تمارسوا عبادة الأشخاص تحت شعارات تستغل الدين أو المواطن أو أي موضوع للتذكير الأخ محمد اشتيه استقال من كل مهامه السابقة ليتفرغ لعمل الحكومة