بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
العودة الجادة لملف المصالحة، تعني تطبيق جميع ملفاتها بناء على اتفاق 2011 وما تلاه. وأن يكون ذلك على قاعدة الشراكة الوطنية لكافة الفصائل، ويجب أن يكون القرار الفلسطيني قراراً وطنيّاً وليس قراراً خاصّاً بفصيل معيّن دون سواه.
لا يظهر أن زيارة وفدي فتح وحماس للقاهرة في الأيام الماضية (خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018) قد أحدثت اختراقاً جديداً لمسار المصالحة الفلسطينية. هذا المسار الذي نشطت القاهرة في تفعيله في السنة الماضية حتى تمّ توقيع اتفاق تسليم إدارة قطاع غزة لحكومة رام الله في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، غير أنه سرعان ما تعثر بسبب اختلاف فتح وحماس في تفسير بنوده وآليات تنفيذه. وفي صيف هذه السنة نشطت القاهرة من جديد وسعت إلى إيجاد آليات وأفكار جديدة لدفع عجلة المصالحة، وبدت، بالرغم من تبنيها للمطالب العامة للسلطة في رام الله، أكثر تفهُّماً لبعض مطالب حماس، كما تساهلت إلى حد كبير في حركة مرور الأفراد عبر معبر رفح. وقام المسؤولون المصريون المعنيون بملف المصالحة بزيارات لغزة ورام الله، وباستقبال وفود من فتح وحماس طوال الأشهر الماضية. غير أن المحصلة النهائية ظلت متعثرة، وصعبة المنال.
يتركز جوهر الخلاف الحالي في أن فتح (رئاسة السلطة وحكومتها) تطالب بما تسميه “التمكين” الكامل للحكومة في قطاع غزة، وذلك بأن تُسلِّم السلطة الحالية في القطاع (حماس) كافة الأمور لها، بحيث تدير القطاع من “الباب إلى المحراب” وفوق الأرض وتحت الأرض، تحت شعار سلطة واحدة، وأمن واحد، وسلاح واحد. بينما ترى حماس ومعها معظم الفصائل الفلسطينية، أن سلاح المقاومة خط أحمر، وأنه لا يندرج في ولاية الحكومة في اتفاقيات المصالحة، كما ترى حماس أن استمرار أبي مازن وحكومته في إجراءاته العقابية على القطاع، والتهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية، بما قد يسبب الشلل الكامل لاقتصاد القطاع، وعدم استيعاب الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس في السنوات الماضية (نحو 23 ألفاً) كلها عناصر تفجير، يجب حلُّها قبل متابعة إنفاذ المصالحة.
وبينما تركز فتح في إنفاذ المصالحة على استلام قطاع غزة، فإن حماس تُصرّ على تنفيذ المصالحة كرزمة واحدة وبشكلٍ متوازٍ؛ وألا يكون إنفاذ الأمر مرتبطاً بما يروق طرفاً وتعطيل ما لا يروقه. من جهة أخرى، فإن باقي الأطراف الفلسطينية ترفض “ثنائية” فتح وحماس، وترفض تعطيل المشروع الوطني بسبب ذلك.
يظهر أن سياسة عباس في العقوبات، والاستفراد بإدارة الشأن الفلسطيني قد أسهمت في الإضرار بأجواء المصالحة. فقد راهن عباس على أن عقوباته التي بدأها أواخر مارس/آذار 2017، مقرونة بمعاناة حماس من أزمة مالية غير مسبوقة، ووقوع القطاع تحت حصار خانق، ستؤدي إلى تطويع حماس واستسلامها لطلباته؛ غير أن عقوباته، بالرغم من قسوتها وشدتها لم تنجح. بل إن هذه الإجراءات عندما طالت مدتها، تسببت في تصاعد الاستياء من عباس وحكومته، كما تزايدت الفصائل الفلسطينية المطالبة برفع العقوبات، بحيث تكاد فتح تجد نفسها وحدها في الإصرار على هذه السياسة.
وزادت عزلة قيادة فتح نتيجة سياستها الانفرادية في إدارة مؤسسات منظمة التحرير، ففي أجواء مندفعة فلسطينيّاً تطالب بتوحيد القوى في مواجهة “صفقة القرن” ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين، أصرت قيادة فتح على عدم عقد الإطار القيادي الموحد، الذي تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية، لتنسيق الجهود، مما تسبب في حالة من الاستياء.
وفي الوقت نفسه، لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية قادرة على توفير مظلة واحدة، للعمل السياسي المؤسسي الفلسطيني، بعد إصرار فصيل واحد على الهيمنة عليها، وبعد تراجع دورها وانعدام فاعليتها وضعف مؤسساتها، وغيابها عن واقع الشعب الفلسطيني، وتحوُّلها إلى ما هو أقرب إلى دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية. كما أن حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تمثلان شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، غير ممثلتين فيها. وبدلاً من أن تقوم قيادة فتح بإنفاذ البند المتعلق بالمنظمة حسب اتفاقات المصالحة؛ فقد أصرّت على عقد ثلاثة مجالس مركزية للمنظمة خلال سنة 2018 قاطعتها الجبهة الشعبية، وقاطعت اثنين منها الجبهة الديمقراطية، كما أصرت على عقد مجلس وطني في رام الله تحت الاحتلال (بخلاف اتفاق بيروت في يناير/كانون الثاني2017) قاطعته أيضاً الجبهة الشعبية. وهو ما وسَّع دائرة الاستياء تجاه سياسات فتح في الوسط الفلسطيني.
نجحت مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس/آذار 2018 كل يوم جمعة من كل أسبوع، والتي حازت إجماعاً شعبيّاً، في تحويل الانفجار الشعبي الذي توقعه عباس وحكومة رام الله في قطاع غزة في وجه حماس، إلى غضب ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإلى غضب ضد إجراءات عباس، وكل من يحاصر غزة. وقد أثار ذلك خصوصاً منذ النصف الثاني من مايو/أيار مخاوف متزايدة لدى الطرف الإسرائيلي (وحتى الطرف المصري) من أن ينفجر الوضع في قطاع غزة باتجاه اختراق الحدود بعشرات الآلاف مع فلسطين المحتلة. كما أن المخاوف من أن انهيار الوضع في القطاع، قد يتسبب في فوضى وانفلات أمني يدفع ثمنهما الجانبان المصري والإسرائيلي، بينما يقبع عباس في رام الله بعيداً عن هذه الاستحقاقات. ثم إن الأطراف الإسرائيلية والإقليمية والدولية لا ترغب في الوقت الحالي في وجود غزة متفجرة تُلهب الأوضاع في البيئة العربية، مما قد يُفسد على “إسرائيل” أجواء التطبيع التي تسعى لتطويرها في المنطقة. فضلاً عن عدم رغبة الطرف الإسرائيلي في الدخول في حرب جديدة مع قطاع غزة. ولذلك أصبح ثمة ميل لدى الأطراف المعنية بالحصار (باستثناء سلطة رام الله) بفك الجانب الإنساني عن السياسي (ولو مؤقتاً) وتخفيف الحصار عن غزة بدرجة “معقولة”؛ مع الاعتراف الواقعي بعدم القدرة على تطويع حماس وقوى المقاومة في الظرف الحالي.
ولذلك فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التي خففت الحصار من فتح معابر، وإدخال بضائع، وضخّ الوقود، وزيادة مساحة صيد السمك، والسماح بزيادة ساعات استهلاك الكهرباء، وإدخال المنحة القطرية. وكل ذلك لم يَرُقْ لعباس وحكومته، الذي رأى أن فرصة إخضاع غزة تُفلت من يديه.
أما حماس وقوى المقاومة فقد رأت أن تخفيف الحصار وإنهاءه هو إنجاز لمسيرات العودة ولقوى المقاومة، واستحقاق يجب قطف ثمرته، وليس مرتبطاً بأي أثمان سياسية؛ بينما حاول عباس الربط بين تخفيف الحصار وبين إنجاز المصالحة وفق تفسيره لها.
وبناءً على ذلك فقد نشط الجانب المصري طوال الأشهر الماضية في محاولة إقناع عباس باستلام حكومته للقطاع دون الخوض في سلاح المقاومة، وبحل قضية استيعاب الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، كما نشط في إقناع حماس بتوفير كل التسهيلات لتسليم الحكم لحكومة رام الله، وفي تهدئة الأوضاع وعدم التصعيد مع الجانب الإسرائيلي. غير أن عباس ظلّ مُصرّاً على ما يسميه “التمكين” الكامل لحكومته.
لم يحدث تطور حقيقي في الجولة الأخيرة في القاهرة. بل ظهرت تصريحات تصعيدية من طرف عزام الأحمد وحسين الشيخ. وذكر الأحمد (المعنيُّ بملف المصالحة في فتح) في مقابلة مع تلفزيون فلسطين في 27 مارس/آذار 2018 أنهم لا يثقون في حماس؛ وتحدَّث عن تشكيل لجنة ستجتمع حتى “تُقوِّض سلطة حماس”. أي أن فتح باختصار ما تزال تعيش آمال إسقاط حماس وإخضاعها. وهو ما يعني أن مسار المصالحة على أساس الشراكة الوطنية ليس سالكاً. وأن تجربة 12 عاماً من الفشل التي خاضتها قيادة فتح في هذا المجال، لم تقنعها حتى الآن بالكفّ عن هذه المحاولات.
فتح التي تتولى قيادة المنظمة وقيادة السلطة وتتمتع بـ “الشرعية” المدعومة إقليميّاً ودوليّاً، ما تزال “تدير” ملف المصالحة، وتراهن على الزمن، وعلى معاداة البيئة الإقليمية والدولية لتيارات “الإسلام السياسي” وتيارات المقاومة، وعلى الاستفادة من موقعها في فرض شروطها. وهو ما جعل الجولة الأخيرة للمفاوضات عديمة الجدوى. غير أن على فتح أن تعلم أن الوقت لا يسير بالضرورة لصالحها، فهي نفسها تُعاني أزمات حقيقية في قيادتها، وفي مسارها السياسي “السلمي” ومشروع الدولتين الذي وصل إلى حائط مسدود، وفي إدارتها للمنظمة التي جعلتها في “غرفة الإنعاش”، وفي إدارتها للسلطة التي تخدم أغراض الاحتلال أكثر مما تخدم تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي ربط كوادر فتح بعجلة الحياة اليومية للسلطة واستحقاقات التنسيق مع الاحتلال، وفي تزايد عزلة فتح في البيئة الفلسطينية نتيجة سياسات أبي مازن.
وأخيراً، فإن العودة الجادة لملف المصالحة، تعني تطبيق جميع ملفاتها بناء على اتفاق 2011 وما تلاه. وأن يكون ذلك على قاعدة الشراكة الوطنية لكافة الفصائل، ويجب أن يكون القرار الفلسطيني قراراً وطنيّاً وليس قراراً خاصّاً بفصيل معيّن، وعلى أبي مازن أن يتراجع عن إجراءاته تجاه غزة، وأن يتوقف عن الإصرار على السيطرة على سلاح المقاومة، وأن يتم تفعيل الإطار القيادي المؤقت، بانتظار الاستكمال العاجل لبُنَى فلسطينية مؤسسية راسخة وفعالة.
المصدر: TRT عربي، 5/12/2018
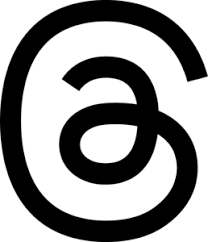

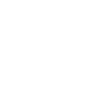
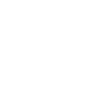
أضف ردا