 .بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
.بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
مرت 25 عاما على اتفاق أوسلو الذي وقعته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع العدو الصهيوني في سبتمبر/أيلول 1993. كانت هذه السنوات إلى حدّ كبير “سنوات عجافا” على مسار العمل الوطني الفلسطيني، وبنائه المؤسسي، وعلى مكانة القضية الفلسطينية.
نختار أن نقف في هذه المقالة على ستة دروس مستفادة من “تجربة أوسلو”:
1- وجوب التوافق الوطني على القرارات والمسارات المفصلية، المتعلقة بالقضية الفلسطينية
أسس اتفاق أوسلو لأكبر انقسام في التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر. وتحملت قيادة حركة فتح “وزر” الاستفراد بقرار مصيري لا يخص الشعب الفلسطيني وحده، وإنما الأمة العربية والأمة الإسلامية. وقامت من موقعها القيادي بتقديم تنازل تاريخي عن معظم أرض فلسطين (فلسطين المحتلة سنة 1948 التي تشكل 77% من مجمل فلسطين) واعترفت بالكيان الإسرائيلي، كما توافقت معه على آليات إشكالية وغير مضمونة في محاولتها للوصول إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
كان الرفض للاتفاق واسعا وغير مسبوق في التاريخ الوطني الفلسطيني، فقد انضمت للرفض فصائل أساسية في منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديموقراطية لتشكل مع حماس والجهاد الإسلامي والصاعقة والقيادة العامة وغيرها ما عرف بتحالف الفصائل العشر، كما رفضته شخصيات كبيرة ووازنة في حركة فتح، تُعبِّر عن تيار مهم داخل فتح نفسها. ومع ذلك، “ركبت” قيادة فتح رأسها مستعينة ببعض الفصائل الصغيرة الهامشية في العمل الفلسطيني. كان ذلك انقساما تجاوز في اتساعه وتأثيره انقسامات سابقة كما بين الحسينية والنشاشيبية، وعند إنشاء منظمة التحرير، وعند انطلاق برنامج النقاط العشر، أو تشكيل جبهة الرفض، أو تشكيل جبهة الإنقاذ.
كان اتفاقا أسس لتنازع مساري التسوية والمقاومة، فأصبح العمل المقاوم في نظر أنصار فتح عقبة في طريق إنشاء الدولة الفلسطينية المأمولة؛ كما أصبحت السلطة وأجهزتها الأمنية في نظر أنصار تيار المقاومة عقبة في وجه مشروع النضال والتحرير.
هذا الاتفاق تسبب في تعميق أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وتضارب مساراته، وإلى تعارض في الأولويات والبرامج وأساليب العمل؛ وهو ما دفعت الحركةُ الوطنية ثمنه غاليا في السنوات التالية، في تشتيت الجهود، وتفويت الفرص، وإضعاف الصف الداخلي، وفي ارتفاع قدرة العدو على الضغط والمناورة وتحقيق المكاسب. ولم يكن الانقسام الفلسطيني اللاحق خصوصا بين فتح وحماس، في أحد أوجهه إلا أحد تجليات و”بركات” اتفاق أوسلو.
2- القضايا الرئيسية تُحسم مسبقا، والمفاوضات تكون على تفاصيل التنفيذ
في كافة أشكال إنهاء الاحتلال والاستعمار يتم حسم القضايا الكبرى ابتداء عند توقيع الاتفاق، وتُترك التفاصيل للمفاوضات. فيتم حسم مسائل الانسحاب، والسيادة، وتقرير المصير (ما يتعلق بالأرض والشعب ومصير الشعب على أرضه).
أما “كارثة” أوسلو فتجلَّت في أنه اتفق على بعض التفاصيل، وأَجَّل القضايا الكبرى؛ فتحدث عن حكم ذاتي فلسطيني محدود، ينمو بالتدريج تحت هيمنة الاحتلال، دون ضوابط أو معايير تُلزمه. ولذلك أصبحت القضايا الكبرى في مهب الريح، وعلى رأسها: القدس، واللاجئون، والمستوطنات، وحقّ تقرير المصير، وحدود الدولة، والسيادة عليها، والثروات الطبيعية.
في الوقت نفسه، تلقى العمل الوطني الفلسطيني صفعة كبرى بتعهد قيادة فتح والمنظمة بإيقاف العمل المسلح، والالتزام بالطرق السلمية فقط، كما تمّ إخراج مرجعية الأمم المتحدة وقراراتها من العملية التفاوضية.
وبذلك، أصبح “المستقبل الفلسطيني” مرتبطا ومرتَهَنا بالإرادة الإسرائيلية والمزاج الإسرائيلي. ونجح الجانب الإسرائيلي في استغلال ذلك في تحويل مسار التسوية إلى “عملية تفاوضية لا نهائية”؛ رسَّخت من قدرته على فرض إرادته وإملاءاته، وعلى بناء الحقائق على الأرض.
لقد وقع الطرف الفلسطيني في خطيئة كبرى هي التعامل مع “إسرائيل” بشكل من الثقة أقرب ما يكون إلى اعتبارها “جمعية خيرية”، وليس “عدوا” لا يعترف إلا بموازين القوى على الأرض.
3- البناء المؤسسي: هشاشة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها
السلطة الفلسطينية التي أنشأتها قيادة المنظمة وفتح أقامت بنية ومنظومة مؤسساتية لا تملك الحد الأدنى لتحقيق متطلبات الدولة المستقلة.
فمن ناحية أقامت بنية محكومة بالاحتلال برا وبحرا وجوا، وهي لا تتحكم في حدودها ولا صادراتها ولا وارداتها ولا تحويلاتها المالية.
وهي من ناحية ثانية بنية يستطيع الاحتلال الإسرائيلي تعطيلها متى شاء، كما يستطيع (وقد فعل) تدمير مشاريعها الاقتصادية وبناها التحتية، بما في ذلك مؤسساتها التعليمية والخدمية ومحطاتها الكهربائية وحتى مراكز شرطتها.
وهي من ناحية ثالثة منظومة يحتاج فيها رئيس السلطة نفسه ووزراؤه ورموز قيادته ومديرو مؤسساته لإذن من “شاويش” إسرائيلي لحركتهم، في مناطق حكمهم في الضفة والقطاع، ويمكن أن يُعتقلوا أو تُقيّد حركتهم في أي لحظة.
ونشأ من ناحية رابعة ضمن هذه المنظومة بنية اقتصادية بوصفةٍ مضمونة للفشل، حيث مثّل بروتوكول باريس، مزيدا من “التفصيلات” الكارثية. ونشأ اقتصاد تُرتهن نحو 80% من إيراداته بإرادة العدو “المقاصة” أو بالدول الغربية المانحة، بينما تأتي نحو ثلثي وارداته من الاحتلال وتذهب أكثر من 83% من صادراته إلى الاحتلال!
ومن ناحية خامسة، أصبح ما يسمى اقتصادا فلسطينيا معنيا بـ”الرفاه” تحت الاحتلال، أكثر من إنشاء اقتصاد مستقل أو مقاوم. وتشكلّت منظومات مصالح و”فساد” ارتهن بقاؤها بوجود الاحتلال وليس بزواله.
واستنزفت من ناحية سادسة ميزانية السلطة وكادرها الوظيفي في الأجهزة الأمنية لتشكل أعلى نسبة في العالم، بنحو سبعة أضعاف المعدل العالمي لعدد رجال الأمن مقابل عدد السكان، وليَصبَّ جوهر عملها في التنسيق مع الاحتلال ومطاردة قوى المقاومة.
وهكذا، وجدنا أنفسنا في النهاية أمام بنية فلسطينية مشوهة، لا تملك أُفُقَ الوصول للدولة، ولا تنفيذ تطلعاتها في “حل الدولتين”.
4- لا لتقزيم المشروع الوطني الفلسطيني
أسس اتفاق أوسلو لتراجع مريع في المشروع الوطني الفلسطيني، فحوّله من مشروع يهدف إلى تحرير كل فلسطين إلى سلطة حكم ذاتي “تتطلَّع” إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع؛ غير أنها مرهونة بإرادة الاحتلال واعتباراته ومتطلباته.
وتحوَّل الحكم الذاتي إلى حالة “تأبيد” تخدم أغراض الاحتلال أكثر مما يخدم المشروع الوطني. وهكذا أوقعت قيادة فتح شعبها في “مصيدة لا فكاك منها” كما عبَّر المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد.
وتم تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية، فتراجعت مؤسساتها، وأُفرغت من محتواها، وضَمُرت حتى تحولت إلى “دائرة” من دوائر السلطة الفلسطينية. وتم إدخالها إلى غرفة الإنعاش، بحيث يتم استجلابها لطبع “الأختام” لشرعنة السلوك السياسي لقيادة السلطة وفتح.
وتحت اتفاق أوسلو تمّ “شرعنة” الصراع الداخلي، و”شرعنة” ضرب قوى المقاومة.
وفي بيئة اتفاق أوسلو تمّ تضييع فلسطينيي الخارج وإهمالهم، وعدم الاستفادة من قدراتهم الهائلة التي تمثل نحو نصف الشعب الفلسطيني.
ومع تمركز القيادة الفلسطينية وسلطتها تحت الاحتلال، أصبحت “إسرائيل” هي الحاضر الغائب في صناعة القرار الفلسطيني، وعنصرا فاعلا في اعتباراته؛ فلا يمكن للسلطة أن تعمل على الأرض، أو أن تقوم حكومتها بمهامها، أو تجتمع، أو يجتمع مجلسها التشريعي، أو تحدث انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى بلدية.. دون سكوت الاحتلال أو رضاه. وبالتالي فعلى أي جهة تريد أن تدير حياة الناس تحت الاحتلال أن تأخذ موافقته، ما دامت لا تستطيع انتزاعها.
5- لا للتهويد والاستيطان
وفَّر اتفاق أوسلو غطاء لاستمرار اغتصاب أرض فلسطين واستيطانها وتهويدها، مع عدم قدرة السلطة الفلسطينية على مقاومة ذلك، بل وقيامها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لضرب القوى المقاومة للاحتلال.
اتسعت برامج التهويد بشكل هائل في الضفة الغربية، وتزايد عدد المستوطنين اليهود من نحو 280 ألفا عند اتفاق أوسلو 1993 إلى أكثر من 800 ألف مطلع 2018. واحتفظ الاحتلال بنحو 60% من الضفة الغربية في سيطرة إدارية وأمنية كاملة (مناطق ج) ونحو 22% أخرى من الضفة في مناطق بإدارة أمنية مشتركة (مناطق ب). وعُزل نحو 12% من الضفة خلف الجدار العنصري، وتضاعف العمل الحثيث على تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبنيت عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وأنشئت مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية، وبقيت مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وتحول احتلال الضفة إلى “أرخص” استعمار في العالم، وإلى استعمار “خمس نجوم” وفق تعبير مسؤولين إسرائيليين.
لقد ارتكبت قيادة المنظمة وفتح خطيئة كبرى هي توقيع اتفاق لا يوقف الاستيطان طوال فترة التفاوض؛ وهو ما استغله الاحتلال الإسرائيلي بشكل بشع فقام بتغيير وجه القدس وباقي الضفة الغربية، بينما تستمر عملية التفاوض غير المنتهية، وبالتالي عملية التهويد غير المنتهية تحت رعاية “أوسلو”.
6- لا للاختراق الإسرائيلي الصهيوني السياسي والتطبيعي
كان اتفاق أوسلو مدخلا لشرعنة “إسرائيل” واحتلالها، وإقامة الكثير من الدول عربيا وإسلاميا وعالميا علاقات دبلوماسية معها. فهذه الدول “ليست ملكية أكثر من الملك”؛ وأصبحت تبحث عن مصالحها؛ وأصبحت العلاقة مع الطرف الإسرائيلي مدخلا لرضا “السيد الأميركي”. وقام الطرف الإسرائيلي بتوسيع دائرة علاقاته السياسية والاقتصادية بما يُحسن أوضاعه الاقتصادية وشبكة أمانه “الوطنية”؛ بينما تراجعت قدرة الطرف الفلسطيني على الضغط على الجانب الإسرائيلي، بشأن أي من استحقاقات “التسوية” أو انتزاع أي من الحقوق الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، أصبحت المقاومة الفلسطينية هي المحاصَرة، وأصبحت “عبئا” على قيادة السلطة والمنظمة والبلاد العربية؛ هذا إن لم يعتبرها البعض “إرهابا”.
وهكذا، فمن خلال الدروس الستة السابقة، نلاحظ إلى أي كارثة ساقتنا اتفاقيات أوسلو، وأي أثمان هائلة مدمرة تسببت بدفع الحركة الوطنية الفلسطينية لها.
إن جوهر المشروع الوطني يجب أن يظل مرتبطا بالثوابت على رأسها تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها، وبناء المؤسسات على أسس فعالة تستوعب الكل الوطني، وتتسع للدوائر العربية والإسلامية في مشروع التحرير.
المصدر: الجزيرة.نت، الدوحة، 15/9/2018
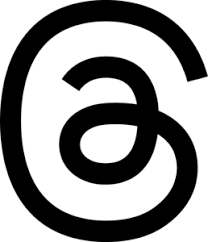

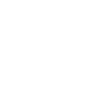
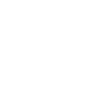
أضف ردا