المناعة الوطنية في مواجهة الاستهداف للذاكرة الفلسطينية: من روابط القرى إلى الفلسطيني الجديد … د. أحمد عطاونة (نسخة نصيّة HTML)
للاطلاع على ورقة العمل كاملةً اضغط هنا ![]() (14 صفحة، 649 KB)
(14 صفحة، 649 KB)
المناعة الوطنية في مواجهة الاستهداف للذاكرة الفلسطينية: من روابط القرى إلى الفلسطيني الجديد … د. أحمد عطاونة[1]
مقدمة:
المشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع استعماري استيطاني إحلالي، سعى منذ اللحظة الأولى لقيامه إلى تغيير كافة معالم فلسطين الجغرافية والسكانية والتاريخية والدينية. لقد بنى هذا الكيان روايته التأسيسية على الكذب والزيف حين ادعى أن فلسطين “أرض بلا شعب”، يجب أن تعطى إلى “اليهود” الذين هم “شعب بلا أرض”. شكَّل هذا الادعاء الزائف مقدمة ليس فقط لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، بل وللعمل بكل الوسائل للتخلص من الشعب الفلسطيني وإلغاء وجوده على أرضه. وقد حظي الكيان بالدعم الكامل من قبل الدول المهيمنة على المشهد السياسي الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضاربين بعرض الحائط كل قيم ومبادئ العالم الحر.
لم يكن الفلسطينيون ضحايا فقط لمعادلات سياسية دولية معقدة، أعادت تشكيل الخريطة السياسية الدولية في بداية القرن العشرين، وضحايا لأزمات قومية واجتماعية أوروبية جعلت من اليهود عنصراً منبوذاً وغير مرغوب فيه في المجتمعات الأوروبية، بل كانوا وما زالوا ضحايا للنفاق السياسي والسياسات الغربية الداعمة للعنصرية والتطرف الصهيوني الذي ما انفك يمارس الظلم والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ما تزال الإجراءات الصهيونية الهادفة إلى تشريد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والدينية تحظى بالرعاية والدعم الغربي. وفي الوقت ذاته، ما يزال الشعب الفلسطيني يظهر قدرة استثنائية على المقاومة والصمود والتحدي، فلا هو هَجَرَ أرضه وتخلى عنها، ولا من تمّ تشريده منها نسيها أو تنازل عنها. كما أنه لم يفقد بوصلته الوطنية ولم يستسلم للسياسات الصهيونية، ويقاوم كل محاولات الاستئصال والإلغاء بكل قوة وصلابة.
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الآليات والوسائل، التي حاول من خلالها الاحتلال وداعموه التأثير على الوعي الوطني والذاكرة الوطنية الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض الحلول التي تنتقص من الحق الفلسطيني، وتدفع الفلسطيني للتنازل عن ثوابته الوطنية. كما تهدف إلى استكشاف قدرات الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة في مواجهة هذا الاستهداف لمناعته الوطنية، وكيف تمكَّن من التصدي للمشاريع الصهيونية في هذا الصدد، على الرغم من تعقيد وصعوبة المشهد السياسي الإقليمي والدولي المرتبط بالقضية الفلسطينية.
مبررات الاستهداف للذاكرة (الفلسفة الصهيونية “الكبار سيموتون والصغار سينسون”):
لقد حظي موضوع التأثير على الذاكرة الوطنية الفلسطينية والوعي بالقضايا الوطنية وطبيعة الصراع باهتمام كبير لدى الكيان الصهيوني وداعميه الدوليين، وقد بذلت جهود كبيرة، وأنفقت أموال طائلة، وجندت طاقات كبيرة من مختلف التخصصات والمجالات لبلوغ الهدف المنشود. يعود ذلك إلى إدراك الحكومات الصهيونية المتعاقبة إلى أن نجاح مشروعهم وبقاء كيانهم مرتبط أساساً بهذا الأمر، وليس فقط بالقوة العسكرية والحلفاء الدوليين. فما زال قادة الكيان الصهيوني، وبعد كل مواجهة مع الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، يتحدثون عن ما يسمونه “حرب الاستقلال”، وأن هذا الكيان ما زال يقاتل ليدافع عن بقائه ، مما يثبت أن “إسرائيل” وبعد ما يقارب السبعة عقود على قيامها ما زالت تشعر بفقدان الاستقرار، وأنه يتم التعامل معها كجسم غريب مرفوض ومهدد. وعليه، فإن الاستمرار في العمل على طمس الهوية الفلسطينية والتأثير على وعيه بقضيته، وإضعاف ذاكرته الوطنية أمر لم يتوقف ولا يبدو أنه سيتوقف.
شكلت مقولة مؤسس الكيان الصهيوني، ديفيد بن جوريون David Ben Gurion، أن “الكبار سيموتون والصغار سينسون” فلسفة للتحرك الصهيوني تجاه الذاكرة الوطنية الفلسطينية، بل واتجاه الوجود الفلسطيني ككل. ومنذ بداية الحديث عن تأسيس الكيان، بدأ العمل على التأثير على ذاكرة ووعي شرائح الشعب الفلسطيني المختلفة، وبدأ التشكيك في أصل الوجود الفلسطيني على أرضه ومدى ارتباطه الديني والتاريخي فيه. هذا الموقف الصهيوني يبدو عائداً إلى الآتي:
أولاً: الحركات الصهيونية ومن ثم سكان الكيان الصهيوني يفتقدون إلى ذاكرة تاريخية أو وطنية مرتبطة بأرض فلسطين. وهم إن كان لديهم ذاكرة وطنية فهي مرتبطة بجغرافيا أخرى، حيث ولدوا وولد آباؤهم وأجدادهم، إذ ينحدر سكان الكيان الصهيوني من دول وثقافات وجنسيات شتى غالبيتها ليست عربية أو إسلامية، فقد هاجر غالبيتهم إلى فلسطين من دول أوروبية . وعليه، لا بدّ من محو ذاكرة السكان الأصلين أو إضعافها أو تشويهها لكي لا تبقى عنصر تفوق لديهم. يتزامن ذلك مع محاولات لاختراع ذاكرة صهيونية مصطنعة في محاولة لربط السكان الصهاينة بالأرض وتاريخها. لقد تمّ استدعاء تاريخ غارق في القدم ومحل شكّ كثير من الخبراء غير الفلسطينيين، بل وحتى الصهاينة، حيث أقر عدد من الباحثين الصهاينة أنهم لم يجدوا أي أثر يدل على وجود الهيكل المزعوم في منطقة المسجد الأقصى، على الرغم من أعمال البحث الكثيفة والمستمرة عن الآثار . كما تمت صياغة عدد كبير من الأكاذيب، المرتبطة بالتراث والثقافة والجغرافيا، مثل بعض المأكولات، والزي الشعبي، وبثها في عقول الصهاينة على أمل صناعة وعي وذاكرة مرتبطة بالجغرافيا الجديدة “فلسطين” التي يعيشون فيها .
ثانياً: أبدى الشعب الفلسطيني إصراراً استثنائياً في الحفاظ على ذاكرته الوطنية ومقاومة النسيان، فعلى الرغم من العقود الطويلة من عمر الاحتلال، والتي مورست خلالها كل أنواع الضغط عليه، وعلى الرغم من اختفاء أجيال وظهور أجيال جديدة، إلا أنه تمكن من الحفاظ على ذاته الوطنية، ولم يسمح للنسيان أو التشويه بأن يتسلل إلى وعيه وذاكرته الوطنية. فلسطين في أذهان كل الفلسطينيين بأجيالهم المختلفة، وبشرائحهم السياسية والاجتماعية والثقافية وفي كل أماكن تواجدهم ما زالت تحافظ على جغرافيتها وهويتها الوطنية. وحتى أولئك الذين يؤيدون مسار التسوية السياسية فإنهم يتعاملون مع الموضوع بصيغة الاضطرار والمرحلية، ويتمسكون بعلاقتهم التاريخية والثقافية والدينية بفلسطين التاريخية. هذا المفهوم يوضحه القيادي في حركة فتح، لؤي عبده عندما يكتب “نحن في وسط هذا العالم لا نحلم ولا نطلب المستحيل “إقامة دولة فلسطينية مستقلة” على جزء من أرضنا التاريخية لا يتجاوز مقداره خمس المساحة الإجمالية من مجمل أرض فلسطين التاريخية، التي سلبت منا في ليلة ما فيها ضوء قمر، وحلّ عليها قوى الظلام والعنصرية والفوق إنسانية” ؛ هذا الأمر ينطبق أيضاً على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الكيان الصهيوني ويحملون جواز سفره، فهم يرون أن تعايشهم مع الأمر الواقع، الذي فرض عليهم ولا يستطيعون تغييره، لا ينسيهم أنهم أصحاب الأرض الأصليون، وأن من يحكمونهم هم غزاة مثل غيرهم من الغزاة الذي مروا بفلسطين عبر تاريخها الطويل. هذا الموقف عبرت عنه مراراً قيادات الفلسطينيين في الأراضي التي احتلت سنة 1948، ومنهم من عبر عنه داخل “الكنيست الإسرائيلي”، ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2015 عبر أحمد الطيبي بكل وضوح عن هذا الرأي .
ما زالت فلسطين بمدنها وقراها وبمعالمها التاريخية معروفة جيداً لدى الفلسطيني، فعلى الرغم من الشتات الذي تعرض له الفلسطينيون، إلا أنهم ما زالوا يعلمون أبناءهم أينما وجدوا تاريخها وجغرافيتها، فتجد الطفل الذي ولد هو ووالديه خارج فلسطين يحدثك ليس فقط عن فلسطين ولا عن حيفا ويافا، بل وعن قريته التي هُجِّرَ منها . وبقيت المعالم الثقافية والدينية الفلسطينية راسخة في وجدان الفلسطيني، فالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي، على الرغم من السيطرة الصهيونية عليها، إلا أنها بقيت حاضرة في وجدان الشعب وقبلة لنضالهم ومقاومتهم. لقد قاوم الفلسطيني نظرية “الكبار سيموتون والصغار سينسون” بكل وسائل المقاومة، وتمكن إلى حدّ كبير من إحباطها والحيلولة دون إثباتها، وتكفي الإشارة إلى حجم النشاط الذي يقوم به الفلسطينيون في أوروبا لمساندة قضيتهم والتأكيد على حقهم في العودة، مثل مؤتمر العودة الذي يعقد سنوياً، لندلل على مدى فشل تلك النظرية الصهيونية .
ثالثاً: على الرغم من كون فلسطين تشغل حيزاً جغرافياً محدوداً، مقارنة بغيرها من الدول، إلا أنها كيان ومحتوى تاريخي ضخم، وهي في ذاتها كأرض وتاريخ عصية على الهضم والإلغاء. فبالإضافة لكونها مهد الديانات السماوية الثلاث، ومسرى الرسول محمد عليه السلام، فعلى أرضها وقعت أحداث تاريخية ومعارك فاصلة غيرت مجرى تاريخ حضارات ودول كبرى وكانت معبراً لفتوحات وغزوات، وذاكرتها التاريخية حافلة بانتصارات وبطولات لا يمكن للفلسطيني وللمسلم أن ينساها، فحطين وعين جالوت وغيرهما ما زالت محفورة في وجدان الفلسطيني أينما وجد، فما زال الاستشهاد بهذه الأحداث والتغني بها حاضراً بقوة في أدبيات وفنون الفلسطينيين .
رابعاً: فشل مشاريع الاحتواء أو “التعايش والترويض” التي استهدفت الشعب الفلسطيني، زاد من وتيرة الاستهداف للذاكرة الوطنية. فقد رفض الفلسطينيون فكرة التعايش مع المستوطنين الصهاينة بأي صيغة كانت، وما زالت النظرة للصهاينة بكافة شرائحهم أنهم غزاة محتلون. فلا مشروع روابط القرى ولا مشروع التسوية السياسية “اتفاق أوسلو” Oslo Accords، ولا حتى صيغة “دولة ديموقراطية واحدة” أو “ثنائية القومية” بدت أو تبدو قادرة على جسر الهوة السحيقة بين الفلسطينيين كشعب واقع تحت الاحتلال، وبين الصهاينة كمستعمرين ومحتلين. لقد بُذلت جهود سياسية دولية وإقليمية وأُنفقت أموال طائلة لإنجاح بعض مشاريع التسوية، على أمل أن تُحدث تحولاً في الموقف الشعبي الفلسطيني تجاه الوجود الصهيوني على أرض فلسطين، لكن ذلك كله لم يجد فرصة للنجاح، وما زالت المحاولات مستمرة، والمقاومة والصمود والرفض الفلسطيني مستمر.
خامساً: فشل مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجِّروا من أرضهم، وعدم تخلي الفلسطيني في الشتات عن مطالبه الوطنية المتمثلة في التحرير والعودة. فعلى الرغم من الاختلال الهائل في موازين القوى وحجم التخاذل العربي والإسلامي والدعم الدولي للكيان، إلا أن الفلسطيني، وبمساندة بعض القوى والحكومات، تمكن من إسقاط كل مشاريع التوطين ابتداء من خطة روجرز Rogers Plan وحتى مفاوضات السلام . إن رفض التوطين أو التنازل عن حقّ العودة لم يقتصر على أولئك الذين يعيشون حياة بائسة في مخيمات اللجوء في دول الجوار الفلسطيني، بل إن أولئك الذين يعيشون في الدول الغربية التي توفر قدراً كبيراً من الرفاهية هم الأكثر حضوراً في الحديث عن حق العودة، ففي أوروبا ينشط الفلسطينيون هناك بطريقة لافتة في هذا الشأن، وقد تمكن مركز العودة الفلسطيني في لندن، الذي يعد عنواناً بارزاً في هذا المجال من إحراز عضوية في الأمم المتحدة، ليجعل من هذا الموضوع محل حضور دولي دائم .
استهداف الذاكرة الوطنية: الآليات والوسائل:
استند الاحتلال الإسرائيلي وداعموه في استهدافهم للذاكرة الوطنية الفلسطينية إلى سياستين رئيسيتين وهما سياسة الإلغاء “الاستئصال”، والتي استخدمت فيها وسائل عدة، كانت خشنة في غالبيتها، وكذلك سياسة الاحتواء والترويض والتي اعتمد في تنفيذها على وسائل ناعمة وسياسية؛ وكل ما سنأتي على ذكره سيندرج تحت هاتين السياستين. فقد عمد الاحتلال وضمن محاولاته استئصال الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه إلى ارتكاب المجازر في أكثر من مكان وعلى مدى أزمنة عديدة، وهو ما أدى إلى تهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، واستمرت محاولاته لتهجير من تبقى، ولكنه عندما فشل في ذلك، لجأ إلى محاولات الترويض والاحتواء وطمس الهوية الوطنية. ويمكن وضع مشاريع روابط القرى ومشاريع التسوية السلمية والفلسطيني الجديد في هذا السياق، كما أنه لجأ أخيراً إلى نظام الفصل العنصري والمعازل. وضمن محاولاته المتكررة وغير المنتهية لاستهداف الوعي الوطني الفلسطيني والذاكرة الوطنية، فقد اعتمد الاحتلال على الآتي:
1. التهجير: عمد الاحتلال منذ الأيام الأولى لسيطرته على الأرض إلى سياسة التهجير وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فقد هدم الاحتلال ما يزيد عن 530 قرة وبلدة فلسطينية، وهجَّر أكثر من 800 ألف فلسطيني، في محاولة لتفريغ فلسطين من سكانها وإلغاء الوجود العربي فيها . وفي محاولة للاستئصال وإرهاب السكان عمد الكيان الصهيوني إلى ارتكاب العديد من المجازر، بلغ عددها وفق بعض المصادر 116 مجزرة . وما زال الكيان يواصل هذه السياسة حتى يومنا هذا في محاولة لكي وعي الشعب الفلسطيني ودفعه نحو اليأس من إمكانية نيل الحرية والاستقلال.
هذا الإجراء الصهيوني واجهه الفلسطينيون بصمود ومقاومة استثنائيين، تمثلا في الصمود على الأرض من جهة، والاستمرار بالتمسك بالحقوق وتطوير وتعزيز الوعي والذاكرة الوطنية لمن أُجبروا على الهجرة من جهة أخرى. فعلى الرغم من كل الإجراءات الصهيونية، ما زال على أرض فلسطين نحو ستة ملايين نسمة، وهو ما يقارب عدد المستعمرين الصهاينة على الرغم من كل التسهيلات والتشجيع المقدم لهم من الكيان وداعميه الدوليين، وما زال أحفاد الذي شردوا من الفلسطينيين يتغنون ببلادهم وينشدون لها لحن الحرية على الرغم من منافيهم البعيدة. لقد عملت الكيانات الفلسطينية المختلفة في داخل فلسطين المحتلة وخارجها بكل ما توفر لها من إمكانيات للحفاظ على الهوية والذاكرة الوطنية الفلسطينية، وسجلت في ذلك نجاحات حقيقية.
2. التهويد: الحركة الصهيونية، ورعاتها من القوى الغربية، حاولت منذ أن بدأت تعمل على إقامة كيان صهيوني على أرض فلسطين أن تعطي مشروعها الاستعماري بعداً دينياً، شأنها في ذلك شأن قوى استعمارية كثيرة عرفها التاريخ الإنساني، وعرفتها فلسطين أيضاً؛ فبدأت تروج لادعاءات ما زالت غير قادرة على إثبات صحتها، تربط بين اليهود وفلسطين كوطن تاريخي لهم، وأن فلسطين هي “أرض الميعاد” التي وعد الله بها اليهود دون غيرهم. تقاطعت هذه الدعاية الصهيونية مع خرافات تعتقد بها مجموعات صهيونية مسيحية، تعتقد بضرورة تجميع يهود العالم في فلسطين كخطوة تمهيدية لعودة المسيح ليحكم العالم لألف سنة يسمونها “الألفية السعيدة”، استناداً إلى هذه الأساطير، بدأت الحركة الصهيونية ومن ثم الكيان الصهيوني في حملة لم تتوقف لتسمية أهم مدن ومعالم فلسطين العربية والإسلامية بأسماء يهودية، حتى الأماكن الدينية لم تسلم من هذه الحملة، فما زال الصهاينة يدَّعون أن المسجد الأقصى بني على أنقاض هيكل سليمان.
لكن محاولة إلغاء الهوية الوطنية والإسلامية لفلسطين لم تنجح بالقدر الذي ترغب به “إسرائيل”، على المستوى الفلسطيني والإسلامي على الأقل، فحافظت المقدسات على اسمها ومكانتها الدينية، وبقي المسجد الأقصى كأبرز معلم إسلامي في فلسطين عنوان لهوية فلسطين الدينية والوطنية؛ وعنوان لنضالها المقاوم والسياسي، فقد كانت الانتفاضة الثانية، سنة 2000، لا تحمل اسمه فقط، بل إنها حدثت عندما انفجرت مفاوضات التسوية السياسية لخلاف حول الولاية السياسية والدينية على المسجد الأقصى.
3. تغيير المعالم الجغرافيا الفلسطينية: لقد شكَّل هذا الموضوع وما زال التحدي الأكبر أمام الفلسطينيين للحفاظ على كيانيتهم وهويتهم الوطنية، وفي ذات الوقت شكَّل الأداة الأكثر فعالية للمشروع الصهيوني في فلسطين، إذ إن مستعمرات “مدن، وبلدات” ضخمة أقيمت على أرض فلسطين، وحملت هذه المستعمرات أسماء صهيونية جديدة وغيّبت إلى حدّ كبير الأسماء الفلسطينية للجغرافيا التي بنيت عليها، مثلما حدث لمدن حيفا ويافا والناصرة وغيرها المئات من المدن والبلدات. ومما يشكل تحدياً كبيراً للفلسطينيين أن هذه المسميات الجديدة أصبحت منتشرة حتى في الأوساط العربية والفلسطينية الرسمية والشعبية، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على الذاكرة الوطنية.
لقد بذلت الأطراف الفلسطينية المختلفة جهوداً كبيرة للوقوف في وجه مشروع صهينة الجغرافيا الفلسطينية وأسماءها، والآليات التي تستخدم في سبيل ذلك كثيرة، لا مجال لذكرها، لكن المقاومة بمفهومها الشامل أهم ركائزها، فالإعلام والتثقيف الوطني والسياسي، والمدارس والجامعات وحتى الأسرة الفلسطينية ميادين مفتوحة لمقاومة هذا المشروع والتصدي له. وفي السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام في هذا الموضوع بشكل كبير، وقد تمكنت القوى الفلسطينية المقاومة من امتلاك عدد من الأدوات التي تعمل بشكل مكثف للتصدي لهذا المشروع.
4. التركيز على طمس المعالم التاريخية واستهداف كل ما يؤكد على الربط بين فلسطين وشعبها وهويتها العربية والإسلامية، وفي ذات الوقت إبراز ما من شأنه أن يربط بين اليهود وفلسطين. لقد امتدت هذه المحاولات الصهيونية إلى قضايا الفنون والتراث والآثار وكل ما من شأنه أن يؤكد العلاقة بين الأرض والإنسان الفلسطيني. وقد وصل الأمر إلى الادعاء بارتباط بعض الملابس والأكلات الشعبية الفلسطينية بالحركة الصهيونية اليهودية، فقد عمد الصهاينة إلى تقديم الوجبات الفلسطينية ولبس الزيّ الفلسطيني في مناسبات محددة، مثل ذكرى النكبة التي يرونها “ذكرى الاستقلال” . وقد كان هذا الموضوع ميدان مقاومة ومواجهة جديد بين الفلسطينيين والمشروع الصهيوني، في سبيله جند الفلسطينيون ما لديهم من إمكانيات لإحياء تراثهم وفنونهم والمحافظة على معالم الأثرية.
5. محاولة إيجاد أجيال فلسطينية جديدة تتقبل وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتتعايش معه. بعد فشل السياسات والجهود الصهيونية، التي تمّ ذكر بعضها سابقاً، في تهجير الشعب الفلسطيني والمس بهويته الوطنية، ثم اللجوء إلى أساليب أخرى تستهدف التأثير على الإنسان الفلسطيني، لا سيّما من بقي منهم في داخل الأراضي المحتلة، مستثمرين كل ظرف سياسي أو إقليمي مواتٍ، بهدف التأثير عليه للقبول بالأمر الواقع وليتقبل التعايش مع الكيان الصهيوني، وقد تعددت المحاولات والوسائل الصهيونية لبلوغ هذا الهدف، والتي منها:
• روابط القرى: بعد أن أجبرت “إسرائيل” قيادة وقوات منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة لبنان بعد اجتياحها له سنة 1984 ، وأصبحت الحركة الوطنية الفلسطينية التي تقودها حركة فتح في أضعف حالاتها نتيجة الهزيمة العسكرية والتشتت الذي تعرضت له، حاولت “إسرائيل” استثمار ما رأته فرصة تاريخية، لبناء كيان فلسطيني متعاون معها في الضفة الغربية وقطاع غزة، عرف في حينه باسم “روابط القرى” ؛ خصوصاً وأن الترهل كان قد أصاب الحالة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ زاد الانفتاح على “المجتمع الصهيوني” وتعززت علاقات العمل والارتباطات المصلحية لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني مع الكيان الصهيوني. ولتعزيز دور الكيان المتعاون مع الاحتلال “روابط القرى”، ربط الاحتلال مصالح الناس ومعاملاتهم الرسمية اليومية معه، وبدأ العمل على تشكيل ما يمكن أن يطلق عليه “إدارة ذاتية فلسطينية” في ظلّ الاحتلال، فتم ربط كل معاملات المواطنين الفلسطينيين بمكاتب “روابط القرى” المنتشرة في كافة محافظات الوطن، فكل من يريد تصريح للسفر أو الحصول على وظيفة أو تصديق وثيقة رسمية لم يكن أمامه خيار سوى التعامل مع هذه المكاتب.
• اتفاقية أوسلو: في محاولة “إسرائيلية” للالتفاف على الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت سنة 1987 وتزايد عمليات المقاومة النوعية للفصائل الفلسطينية، خصوصاً أنها تزامنت مع انطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي شكلت إضافة نوعية للمقاومة الفلسطينية وتمكنت من تزعمها لاحقاً، بعد تراجع دور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الميدان. وفي الوقت ذاته أرادت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية استثمار هذه اللحظة التاريخية التي أعادت الاعتبار للحركة الوطنية، فأقدمت على توقيع اتفاقية أوسلو، التي تستند إلى فكرة الاعتراف بـ”إسرائيل” على 77% من أرض فلسطين مقابل اعتراف “إسرائيل” بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني وإعطاء الفلسطينيين سلطة حكم ذاتي مؤقتة، كمقدمة لدولة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
ليس هنا مجال التفصيل في النقاش السياسي حول أوسلو، ولكن ما يهمنا هنا هو ما رافق هذه الاتفاقية من جهود هائلة للتأثير على وعي وذاكرة الشعب الفلسطيني الوطنية. لقد كان اتفاق أوسلو هو الأخطر على الإطلاق على ذاكرة الشعب الوطنية، إذ أن مفاهيم ومصطلحات وطنية تاريخية بدأت القيادة الفلسطينية ومؤيدو أوسلو بالتخلي عنها، مثل مصطلحات الكيان الصهيوني، العدو، الأسماء العربية للمدن…إلخ، وقد وصلت آثار أوسلو إلى المناهج المدرسية التي تدرس للطلاب، كما تمّ تأسيس عدد كبير من المؤسسات غير الحكومية قدّر عددها بنحو ثلاثة آلاف مؤسسة مسجلة حتى سنة 2009 ، قُدّم لها دعم تجاوز 1.3 مليون دولار بين 1999-2008 ، تبنى عدد كبير منها البرامج الثقافية والسياسية التي تهدف إلى نشر ثقافة التعايش مع الاحتلال وثقافات أخرى تضع المقاومة والتحرير في ذيل قائمة الاهتمامات.
• مشروع “الفلسطيني الجديد”: استثماراً للانقسام الذي حدث على الساحة الفلسطينية سنة 2007، والذي أدى إلى وجود سلطتين على الأرض، واحدة في غزة تديرها حماس، وأخرى في رام الله تديرها فتح، وذلك إثر اشتداد الخلاف بين حركتي فتح وحماس، ورفض الاعتراف والتعامل مع نتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي حدثت سنة 2006، والتي فازت فيها حركة حماس بالأغلبية، حاولت الولايات المتحدة وعبر منسقها الأمني، الجنرال كيث دايتون Keith Dayton، الاستفراد بالضفة الغربية، التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، للتخلص من الحالة الوطنية التي ظهرت على خلفية انتفاضة الأقصى، وإجبار الاحتلال على الخروج من قطاع غزة، وبدأت عملاً مكثفاً على أكثر من صعيد لإعادة صياغة الوعي الوطني بشكل مختلف، ينبذ فيه المقاومة ويعزز ثقافة التطبيع والتعايش مع الاحتلال.
استخدم دايتون، وبموافقة قيادة السلطة عدة أدوات لإنجاح مشروعه الجديد، فقد عمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وإعادة صياغة العقيدة الأمنية والعسكرية لهذه الأجهزة، وكذلك إعادة بناء عناصرها ذهنياً وعسكرياً بحيث يكونوا عناصر معادية للمقاومة ورافضة لها، فقد أقدمت هذه الأجهزة مرات عديدة على اعتقال خلايا مقاومة، بل وصل الأمر إلى حدّ تصفية بعضها، مثلما حدث في قلقيلة سنة 2009 عندما حاصرت مجموعة مسلحة وقتلت عناصرها . وأعيد تفعيل المشاريع الثقافية والسياسية الهادفة إلى التطبيع مع الاحتلال وقبول التعايش معه، وانطلقت مرة أخرى مؤسسات المجتمع المدني العاملة لهذا الغرض وضخت الأموال لتحسين البنية الاقتصادية في الضفة بالتزامن، مع تشديد الحصار على قطاع غزة في محاولة لتقديم نموذجين مختلفين للشعب الفلسطيني: نموذج تسيطر على حياته الهموم والحصار والمعاناة “قطاع غزة” وربط ذلك بالمقاومة وبرنامجها، ونموذج فيه قدر من النمو الاقتصادي والرخاء والأمل بمستقبل أفضل “الضفة الغربية” وربط ذلك بمسار التسوية السياسية والتعايش مع الاحتلال.
الخلاصة:
كل محاولات التأثير على الإنسان الفلسطيني، أو ما عرف بإيجاد فلسطيني جديد، عبر الأدوات السابقة لم تصل إلى غاياتها، فقد قاومها الشعب الفلسطيني وأثبت في كل مرة أنه عصي على التطويع ومدرك لمخططات الكيان الصهيوني وداعميه، وأنه كذلك متفوق وطنياً ووعياً على قيادته، فحتى عندما انخرط جزء من قيادة الشعب الفلسطيني بالعمل لصالح هذا التوجه، أوسلو مثالاً، تمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لهذه الحالة وفاجأ قيادته، كما فاجأ العدو، بأنه لن يستسلم لعدوه ولن يفرط بهويته وقضيته الوطنية. لقد جاءت انتفاضة سنة 1987 بعد مشروع “روابط القرى”، وانتفاضة الأقصى، وثلاثة حروب جاءت في ظلّ أوسلو، وها هو “الفلسطيني الجديد” الذي عمل دايتون جاهداً وأنفق أموالاً وجهداً هائلاً للتأثير عليه يطلق انتفاضة جديدة وبشكل لم يتوقعه أحد. لقد جاءت انتفاضة القدس التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لتنسف كل النظريات التي تتحدث عن إمكانية تطويع الفلسطيني أو التأثير على وعيه الجمعي الوطني والتلاعب بذاكرته الوطنية.
لم يتوقف الاحتلال يوماً عن محاولة طمس الهوية الفلسطينية وتثبيت أركان كيانه على الأرض الفلسطينية، وكان وما زال ينتقل من خطة لأخرى ومن مرحلة لأخرى في سبيل ذلك، فكلما فشل مخطط أو وسيلة لجأ إلى وسيلة أخرى، فعندما فشل في سياسة التهجير والترحيل عبر الحروب والقتل والتضييق على الناس، لجأ إلى خيار التطويع والاحتواء عبر الوسائل السياسية كما حدث في أوسلو، وعندما بدأ يدرك أن أوسلو لن تقود إلى بناء سلطة فلسطينية “صديقة أو متعاونة” معه، وبالذات بعد سيطرة المقاومة على غزة وبناء قوة عسكرية قادرة، لجأ إلى خيار الفصل العنصري “الأبرتهايد” Apartheid وبناء الجدران حول التجمعات السكانية الفلسطينية وإحالتها إلى معازل، مما يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني الدائمة إلى التصدي لمخططات الاحتلال ومشاريعه، ويثبت أن سياسة حرف البوصلة والتأثير على الذاكرة بما يخدم المشروع الصهيوني فشلت فشلاً ذريعاً، ويعود ذلك إلى العوامل الرئيسية الآتية:
1. عمق إيمان الشعب الفلسطيني بقضيته وارتباطه بأرضه.
2. البعد الديني لفلسطين والمكانة الخاصة للمسجد الأقصى عند الفلسطينيين والمسلمين.
3. كثافة الحضور التاريخي في فلسطين وارتباطه بذاكرة وتاريخ الشعب الفلسطيني كشعب عربي مسلم.
4. عدم قدرة الغرب والكيان على فهم طبيعة الفلسطيني العربي والمسلم والتعامل معه عبر مقاربات خاطئة، كالربط بين التنمية الاقتصادية والقبول بالاحتلال أو ربط المقاومة بالفقر وغياب الرفاهية.
5. دور الفصائل الفلسطينية في مواجهة السياسات الاحتلالية والعمل على زيادة وعي الناس وتثقيفهم سياسياً ووطنياً.
6. المقاومة، لا سيّما المسلحة منها، التي جذرت حالة العداء مع الاحتلال، وعززت ثقة الفلسطيني بذاته وكشفت عن وحشية الاحتلال واستحالة التعايش معه.
7. مقاومة الاحتلال هو السلوك الطبيعي للشعوب المحتلة، والشعب الفلسطيني ليس استثناء.
8. التطرف الصهيوني وعدم قدرة الصهاينة على التعايش مع الآخر، وهيمنة عقلية الانتقام والعنصرية على الكيان الصهيوني بمكوناته المختلفة.
[1] باحث مشارك في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (غير مقيم)، ومتخصص في الشأن الفلسطيني. حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مالايا في ماليزيا.
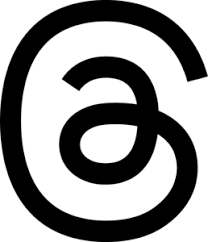

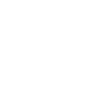
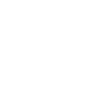
أضف ردا