تقدير استراتيجي رقم (34) – تموز/ يوليو 2011.
ملخص:
ليست “إسرائيل” هي المصلحة الأمريكية الوحيدة في المنطقة، ولكنها تظل حجر الأساس في سياستها الشرق أوسطية، ومن السابق لأوانه توقع ما إذا كانت “الثورات العربية” ستدفع صاحب القرار في البيت الأبيض باتجاه تغيير أولوياته. تقوم إدارة أوباما بممارسة نوع من الضغط على حكومة نتنياهو من أجل أن تراعي مصالح الحليف الأمريكي في المنطقة، و أن تستجيب للتصورات الأمريكية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وخصوصاً الفلسطيني الإسرائيلي. غير أن وزن مؤيدي “إسرائيل” الأمريكيين، وقوة نفوذ اللوبي الصهيوني جعلا إدارة أوباما تتراجع تكراراً أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواقفها. في ظل ما تقدم، يمكن القول بأنه من المتوقع أن تسير السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، في أحد الاتجاهات التالية:
1- أن تشهد السياسية الأمريكية نوعاً من التفاعل الإيجابي تجاه الضغط على “إسرائيل” لتسريع مشروع تسوية القضية الفلسطينية. ويرتكز ذلك على مدى تحقيق الثورات العربية غاياتها، وتكوينها لفضاءات استراتيجية داعمة للحق الفلسطيني.
2- أن تستمر السياسة الأمريكية على حالة الانحياز الدائمة لصالح “إسرائيل” على حساب العرب والفلسطينيين. يعزز هذا الاتجاه “الثقل النوعي” الذي يتمتع به الكيان الإسرائيلي داخل أمريكا، والتجربة التاريخية طوال العقود الماضية، فضلاً عن الخلفيات الثقافية والدينية المؤثرة في صناعة القرار الأمريكي.
3- عدم قيام إدارة أوباما بتنفيذ كافة المتطلبات الإسرائيلية، بما في ذلك ممارسة الضغط الكافي على حلفائها الأوروبيين، فيما يتعلق بعدم الاعتراف بـ”الدولة الفلسطينية”. وقد يحصل هذا الاحتمال بسبب تعنت حكومة نتنياهو وعدم تجاوبها مع تصورات أوباما.
مقدمة:
غني عن القول أن الانخراط الأمريكي في الصراع العربي-الإسرائيلي قديم ويمتد إلى تاريخ تأسيس دولة “إسرائيل” على أنقاض فلسطين وشعبها. فهو ليس وليد اهتمام إدارة ما بالصراع، أو بتغير الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بقدر ما أنه ثابت لا يتغير في المقاربة الأمريكية الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة الراعي والداعم الأول لهذه الدولة؛ في سياق عملية وراثة لنفوذ الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية الآفلتين في المنطقة.
“إسرائيل” واحدة من بين مصالح أمريكية متعددة في المنطقة
المقاربة الأمريكية للصراع، تميزت وعلى الدوام بالانحياز الصارخ للجانب الإسرائيلي، غير أن مصالح أمريكا في المنطقة لا يمكن حصرها فقط بـ”إسرائيل”. فثمة مصالح أخرى تحتم على الولايات المتحدة، الاهتمام بالمنطقة. فثمة مصادر الطاقة وأمنها، كما أن ثمة حسابات الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتحكمها بكثير من المفاصل البحرية والبرية الإستراتيجية. فضلاً عن بروز عوامل أخرى في عالم اليوم، متمثلة بما تصفه واشنطن بحربها الحرب على “الإرهاب” وما يرتبط بذلك من أمنها القومي والاستراتيجي، خصوصا فيما يتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية المنطقة للاستقرار الاقتصادي الأمريكي.. الخ.
لذلك، فإن الولايات المتحدة، ورغم سياسية الانحياز الكلية والصارخة لـ”إسرائيل”، فإنها، وتحديداً بعد حرب حزيران/ يونيو عام 1967، سعت إلى محاولة إيجاد حلول سلمية للصراع العربي-الإسرائيلي. وتضاعفت هذه الجهود الأمريكية بعد حرب رمضان في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973، ذلك أن الولايات المتحدة بدأت تدرك بأن استمرار ذلك الصراع دون حلول جذرية له، سيعني تهديداً لمصالحها الإستراتيجية الأخرى في المنطقة.
هكذا بدأ الموقف الأمريكي يتطور عبر السنوات والعقود الماضية تجاه إيجاد حلول سلمية للصراع، أولاً على المستوى العربي-الإسرائيلي، كما في كامب ديفيد عام 1978 بين مصر و”إسرائيل”، وصولاً إلى محاولة إيجاد حل شامل للصراع في المنطقة يشمل الفلسطينيين بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. غير أنه من الضروري بمكان أن نُبقي في أذهاننا بأن الانحياز لـ”إسرائيل” بقي دائماً هو الثابت الموجه للسياسية الأمريكية في هذا السياق، حتى وإن تضاربت الرؤى والمواقف الأمريكية مع الإسرائيلية.
المصالح الأمريكية الأخرى ومحاولة إيجاد التوازن مع “إسرائيل” أمريكياً
الصراع العربي-الإسرائيلي، ولبه القضية الفلسطينية، حاضرٌ دائماً في الأجندة الأمريكية عبر العقود الطويلة الماضية. وكما أن حجم الانخراط الأمريكي تضاعف وتأثر بأحداث مفصلية تاريخية في المنطقة، فإنه لا شك يتأثر الآن بأحداث “الربيع العربي”، حتى إن الرئيس الأمريكي نفسه، باراك أوباما أشار في خطابه الذي فَصَّلَ فيه مقاربة إدارته للأحداث العربية ضمن سياق رؤيته حول تحقيق سلام فلسطيني-إسرائيلي وأهميته بالنسبة للطرفين، فقال إن “منطقة تشهد تغيرات عميقة ستقود إلى حالة من الشعوبية، بشكل يستلزم أن يؤمن ملايين من الناس-وليس عدد قليل من القادة فقط-بأن السلام ممكن”. تلك كانت، وبلا شك، إشارة ضمنية إلى ضرورة أن تستوعب “إسرائيل” حجم وعمق التغييرات الحاصلة في المنطقة، وتداعياتها المستقبلية على أمنها.
على خلفية الانخراط الأمريكي المباشر في هذا الصراع، نجد أن إدارة أوباما بدأت بالانخراط في ملف عملية السلام في المنطقة منذ اليوم الأول لتولي الأخير كرسي الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2009، وتوج ذلك في خطابه إلى العالم الإسلامي من القاهرة في شهر حزيران/ يونيو 2009، ساوى فيه بين معاناة الفلسطينيين التاريخية ومعاناة اليهود التاريخية (وهذا بحد ذاته يعتبر خروجاً حاداً على الخطاب المتعارف عليه أمريكيا وجلب على أوباما انتقادات كبيرة من اليمين الأمريكي واللوبي الصهيوني، على الرغم من عسف المقارنة أيضاً من وجهة النظر العربية) داعياً فيه “إسرائيل” إلى تجميد فوري للاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك ما تسميه “إسرائيل” بـ”النمو الطبيعي”. هذا طبعاً دون أن نغفل، الجانب الأكبر من الصورة التي تحدث أوباما في سياقها عن الروابط التاريخية والثقافية والروحية التي تربط أمريكا بـ”إسرائيل”، وتأكيده على أن هذه العلاقة لا يمكن أن تنكسر يوماً، فضلاً عن الاشتراطات التي رتبها على الجانب الفلسطيني. حينها خلص أوباما إلى القول بأن “السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا في سلام وأمن. إن هذا السبيل، بحسب رؤية أوباما، يخدم مصلحة “إسرائيل” ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريكا ومصلحة العالم”.
وفي سياق المصالح الأمريكية الأخرى غير “إسرائيل” في المنطقة، يسعى أوباما إلى طمأنة العرب والرأي العام الأمريكي بأنه سيبدأ انسحاباً من العراق، وسيسعى لحسم المعركة في أفغانستان في أفق انسحاب قريب، فضلاً عن الضغط على “إسرائيل”، في محاولة لتحسين صورة بلاده أمام الرأي العام العربي والإسلامي، وضمان أمن واستقرار المصالح الأمريكية الأخرى في المقابل. غير أن جميع جهوده اصطدمت بصخرة العناد الإسرائيلي، إلى حد دفع مراقبين أمريكيين إلى القول بأن أول فشل واجهه أوباما في سياسته الخارجية تمثل في عجزه عن حمل “إسرائيل” على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وهو الأمر الذي دفع بالعلاقة بين أوباما ونتنياهو إلى التوتر.
مع ذلك فإن إدارة أوباما اضطرت إلى التراجع عن مطالبها من الجانب الإسرائيلي. فبعد أن أكد خطاب أوباما في القاهرة على أن المطلوب من “إسرائيل” تجميد كامل للاستيطان في الضفة الغربية، استثنى شرقي القدس منه في مرحلة تالية، ثمّ استثنى ما يسمى بـ”النمو الطبيعي”، وصولاً إلى الاكتفاء بالحديث عن ضرورة “كبح” الأنشطة الاستيطانية، وهو ما حددت معناه لاحقاً وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، حيث اكتفت بالقول إن وقف الاستيطان ليس شرطا للعودة إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
التراجعات الأمريكية أمام عناد “إسرائيل” لم تعن انتهاء الجدل في الولايات المتحدة حول المصالح الأمريكية الأخرى، وتأثير موقف الحكومة الإسرائيلية السلبي عليها بسبب سياسات هذه الأخيرة التي لا تأخذ مصالح الحليف الأمريكي في الحسبان. ففي شهادة لقائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية الجنرال ديفيد بتريوس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي في آذار/ مارس 2010 قال فيها بأن الصراع العربي-الإسرائيلي يؤثر سلباً على قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها الأخرى في الشرق الأوسط، كما أنه يسهم في تصاعد حدّة العداء للولايات المتحدة، ويحدّ من علاقات أمريكا الإستراتيجية مع الحكومات العربية.
هذه المواقف، وجدت صدىً لها داخل إدارة أوباما، خصوصاً عبر مستشار الرئيس للأمن القومي حينئذ، جيمس جونز، ولكن مرّة أخرى اصطدمت مصالح أمريكا الأخرى مع مصلحة “إسرائيل”. وفي هذا السياق، وظّف أنصار “إسرائيل” في الولايات المتحدة تراجع شعبية أوباما بسبب استمرار تدهور الاقتصاد الأمريكي للضغط على أوباما ومحاصرته. مما أدى إلى الحيلولة دون استفادة الأخير من رزمة الإغراءات التي قدمها لنتنياهو من أجل تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 3 أشهر أخرى في حملها على فعل ذلك. فكان أن وُئدت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة والتي بدأت بضغط أمريكي جراء ذلك.
التطورات العربية.. عامل ضغط على الموقف الأمريكي
ضمن هذا السياق فإن أهم ما أسهمت وتسهم به ثورات “الربيع العربي” هو أنها أعادت بالدفع بحزمة المصالح الأمريكية الأخرى في المنطقة من غير “إسرائيل” إلى الواجهة. بمعنى أن صانع القرار الأمريكي تعززت لديه القناعة أكثر، بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، في ظل سعي الشعوب العربية إلى توسيع هامش حريتها وتأثيرها على القرار السيادي الوطني، بما في ذلك التخلص من تبعية بعض الأنظمة العربية المفترضة للولايات المتحدة ولـ”إسرائيل”.
من هنا، دخل طرفي النقاش الداخلي الأمريكي حول تعريف ومقاربة المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في سباق مع الزمن في محاولة لتوظيف الأحداث الجارية في العالم العربي لصالحهما. فنتنياهو المستاء من الموقف الأمريكي “المتهاون” في نظره في التعامل مع الثورات العربية، وخصوصاً في مصر، التي أفضت إلى اقتلاع نظام الحليف حسني مبارك، أراد أن يُجهض أي محاولة أمريكية قادمة للضغط على “إسرائيل”. فكان، وبناء على نصيحة من حلفائه في الولايات المتحدة أن طلب من قيادة الكونغرس الأمريكي إذناً لمخاطبة مجلسي الكونغرس: النواب والشيوخ، حول التطورات الأخيرة الجارية في العالم العربي، ومسعى السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطلب نيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية. فنتنياهو، أراد أن يضع الكونغرس في مواجهة الرئيس الأمريكي، ذلك أنه وإن أبدت الولايات المتحدة معارضتها للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ملوحة بالفيتو، إلاّ أن نتنياهو يريد من الإدارة الأمريكية أكثر من ذلك، أي الضغط على الحلفاء الأوربيين، وخصوصاً بريطانيا وفرنسا، بعدم تأييد المسعى الفلسطيني.
وفعلاً وافقت القيادة الجمهورية للكونغرس الأمريكي على إفساح المجال أمام رئيس وزراء دولة أجنبية لتحدي رئيس الولايات المتحدة عبر منصة الكونغرس نفسه، وحدد لذلك موعد الرابع والعشرون من أيار/ مايو 2011.
إدراك إدارة أوباما بأن نتنياهو يريد أن يحرك الكونغرس ضدها، دفعها، إلى التصميم على عدم السماح لنتنياهو بأن يتقدم بـ”مرافعته” قبل أوباما. فكان أن ألقى الرئيس خطابه حول المقاربة الأمريكية للتطورات في الشرق الأوسط في التاسع عشر من شهر أيار/ مايو 2011، أي أياماً قليلةً قبل خطاب نتنياهو المقرر في الكونغرس.
الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، قبل فترة قصيرة من الخطاب، بما سيقوله أوباما في خطابه حول مسيرة السلام الفلسطينية-الإسرائيلية المتعثرة. ولأن خطاب أوباما تضمن حديثاً عن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، بما في ذلك تمتعها بحدود دائمة مع “إسرائيل” ومصر والأردن، مع تبادل للأراضي متفق عليه، فضلاً عن إشاراته للمعاناة والإهانة التي يشعر بها الشعب الفلسطيني بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قول أوباما بأن “الحلم بدولة يهودية وديمقراطية لن يتحقق عبر احتلال دائم”، فقد جُنّ جُنون نتنياهو. فقام هذا الأخير وقبل إلقاء أوباما لخطابه في ذلك اليوم بإجراء مكالمة هاتفية غاضبة مع كلينتون.
طبعاً، لم يُلق نتنياهو بالاً إلى تطمينات أوباما والتزاماته لـ”إسرائيل”، بقدر ما ركز على ما جاء في خطاب الأخير من حديث عن دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، مهملاً حتى مسألة تبادل الأراضي. أيضا، كان مما أثار حنق نتنياهو أن أوباما اعتبر أن قضيتي القدس واللاجئين مؤجلتان إلى ما بعد الاتفاق على الحدود، في حين أن نتنياهو أراد موقفاً صريحاً من الرئيس الأمريكي بأن لا عودة للاجئين إلى “الدولة اليهودية” ولا لتقسيم القدس “العاصمة الموحدة والأبدية” لـ”إسرائيل”.
غير أن أوباما، لم يُخفِ انحيازه في خطابه لصالح المقاربة القائلة بأن ثمة مصالح أمريكية أخرى في المنطقة بالإضافة إلى “إسرائيل”. فتحدث عن أن الوضع الحالي “غير قابل للاستمرار”، كما أشار إلى تعب المجتمع الدولي من مفاوضات لا تنتهي، محيلاً مرّة أخرى إلى أن استمرار الوضع القائم ليس في مصلحة “إسرائيل”، بعد أن كان أشار في سياق حديثه عن “الربيع العربي” بأن المصلحة الأمريكية أيضاً تتطلب تعديلات في السياسات الأمريكية نحو المنطقة وشعوبها.
وفي سياق صراع الإرادات بين أوباما ونتنياهو، جاء الأخير للقاء الرئيس يوماً بعد إلقاء أوباما لخطابه. في ذلك اللقاء رفض نتنياهو أي حديث عن التراجع إلى حدود عام 1967، حتى ولو تضمن ذلك تبادل أراضٍ، مشيراً إلى أن ذلك يعني حصر “إسرائيل” ضمن حدود غير قابلة للدفاع عنها.
لكن، ولأن صناعة القرار الأمريكي تخضع لاعتبارات وعوامل كثيرة تسهم في صياغتها، ومنها حقيقة وجود لوبي صهيوني مؤثر في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”، فإن الرئيس أوباما وجد نفسه مضطراً بعد يومين من لقائه نتنياهو إلى أن يدافع عن رؤيته لحل الصراع في خطابه أمام منظمة “إيباك”.
ففي خطابه ذاك، بدأ أوباما يشرح حقيقة رؤيته لجمهور المنظمة النافذة في واشنطن. المثير أن أوباما، وإن سعى لتخفيف وقع لغة مشروعه الجديد للحل، غير أنه تمسك به، معتبراً أن كل ما فعله هو أنه قال “في العلن ما هو متعارف عليه بشكل سري”. وبأنه وإن كان دعم أمريكا لـ”إسرائيل” مطلق إلاّ أننا “لا نستطيع أن ننتظر عقداً أو عقدين أو ثلاثة عقود أخرى للتوصل إلى سلام. مضيفاً بأن “التوجه لعزل “إسرائيل” دولياً وإصرار الفلسطينيين على مقاطعة المفاوضات سيستمران بالتعزز في ظل غياب عملية سلام ذات مصداقية”.
غير أن أهم ما جاء في خطاب أوباما ذاك، هو محاولته توضيح موقفه من نشوء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، معتبراً أن كلماته “أُسيء تفسيرها”، وبأنها لا تمثل لغةً خلافيةً ولا هي جديدة، على أساس أن هذا هو الإطار العام للحل الأمريكي لكل الإدارات الأمريكية السابقة، بما فيها إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون. كما اشتكى أوباما من أن التركيز الإعلامي كان على حديثه عن حدود عام 1967، في حين أُغفلت الإشارة إلى تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين. مضيفاً بأنه عنى بأن “إسرائيل” والفلسطينيين سيتفاوضون على حدود مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وقال: “إن هذه الصيغة معروفةٌ جيداً لجميع من عملوا لجيل على هذه القضية. إنها تسمح للأطراف نفسها بمراعاة التغييرات التي حدثت على مدى السنوات ألـ 44 الماضية، بما في ذلك الحقائق الديموغرافية الجديدة على الأرض واحتياجات كلا الجانبين”. مضيفاً: “إن الهدف النهائي هو دولتان لشعبين. “إسرائيل” كدولة يهودية ووطن قومي للشعب اليهودي، ودولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني؛ تتمتع كل دولة بحق تقرير المصير، والاعتراف المتبادل، والسلام”.
غير أن هذه التطمينات من أوباما لم تقنع “إسرائيل” وأنصارها، فهذا المرشح الرئاسي الجمهوري، ميت رومني، يتهم أوباما “برمي إسرائيل تحت الحافلة”.
وأما نتنياهو، ففي خطابه أمام الكونغرس، سعى لإعادة موضعة النقاش حول المصالح الأمريكية في المنطقة، وذلك عبر قوله صراحة: “في شرق أوسط متقلب، “إسرائيل” هي مرساة الاستقرار الوحيدة. في منطقة تتغير فيها التحالفات، “إسرائيل” هي حليف أمريكا الذي لا يتزعزع. لقد كانت “إسرائيل” دائما حليفة أمريكا، وستكون “إسرائيل” دائما حليفة أمريكا”. كما توسع نتنياهو في حديثه عن الديمقراطية الإسرائيلية، زاعماً أن الحريات والديمقراطية التي يكافح من أجلها الشعب العربي اليوم، هي ذات الحرية التي يتمتع بها “مليون عربي إسرائيلي منذ عقود”.
كما أنه زعم أيضاً بأنه أعلن قبل سنتين قبوله بدولتين لشعبين، دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع دولة يهودية، على “أرض الشعب اليهودي التاريخية”. وبالتالي فإن اليهود “في يهودا والسامرة ليسوا محتلين أجنبيين”، مع إدراكه أن شعباً فلسطينياً يشاركهم “مساحة الأرض الصغيرة” تلك. وبعد ذلك عدد نتنياهو الإنجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اقتصادياً وعمرانياً، معتبرا ذلك كله عائدٌ إلى سياسيات “إسرائيل” المتسامحة والمساعدة. ولكن إذا كان الأمر كذلك، “فلماذا لم يتحقق السلام؟”، هكذا يتساءل نتنياهو. ويجيب: السبب عائدٌ إلى أن الفلسطينيين لا يريدون دولة فلسطينية إذا عنى ذلك قبول دولة يهودية بجانبها. “صراعنا لم يكن يوماً حول قيام دولة فلسطينية، بل كان دائما حول وجود دولة يهودية”. مطالباً عباس بأن يتحلى بالشجاعة وأن يقف أمام شعبه معلناً قبوله بدولة يهودية، كما وقف نتنياهو معلناً قبول دولة فلسطينية.
الاحتمالات:
ما دامت الإدارة الأمريكية غير قادرة على حسم المفاضلة بين مصالحها الحيوية في المنطقة و”إسرائيل”، وما دامت “الثورات العربية” في مرحلة عدم اكتمال الإثمار، فإن إمكانية تغير سياسات الولايات المتحدة سوف تسير ضمن أحد الاحتمالات التالية:
الأول: الضغط على “إسرائيل” وتسريع تسوية القضية الفلسطينية:
بسبب التغير الذي تشهده الخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع الهيمنة الأمريكية الاقتصادية ومعاناتها داخلياً على هذا الصعيد، وتراجع سمعتها عالمياً جراء سياساتها العدوانية والأحادية الجانب، خصوصاً زمن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، فضلاً عن تراجع قدرتها على استخدام قوتها العسكرية الهائلة.. كلها عوامل قد تخلق مستقبلاً عناصر ضغط مضاد على مؤسسة القرار الأمريكية لإعادة النظر في مقارباتها لمنطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن “الربيع العربي” إن كُتب له أن يصل مرحلة الاكتمال والإثمار، سيكون أحد تلك العوامل الضاغطة لاجتراح مقاربة أمريكية أكثر اتزاناً، ولكن تحقُّق ذلك كليا لن يكون في مرحلة قريبة، كما أن الانحياز الأمريكي لـ”إسرائيل” سيبقى ثابتاً، على الأقل في المدى المنظور.
ولكي يتم تسريع الضغط على الولايات المتحدة لتبني مقاربة أكثر اتزاناً نحو قضايا المنطقة، فإن هذا يتطلب، في حال نجاح “الربيع العربي” في تحقيق مبتغاه، وجود إستراتيجية عربية موحدة ومنسقة وشاملة، تأخذ في اعتبارها العمق والسند الشعبي لمطالبها. عندها سيكون الخيار في واشنطن متلخصا في: هل نضحي بكل مصالحنا الحيوية والإستراتيجية الأخرى في المنطقة من أجل “إسرائيل”، أم نعمل على الحفاظ عليها كلها-ومن ضمنها إسرائيل-عبر تبني سياسات أكثر عدالة واحتراما للمنطقة وشعوبها!؟
الثاني: الاستمرار في الانحياز لصالح “إسرائيل” على حساب العرب والفلسطينيين:
إن محاولة إدارة أوباما الضغط على “إسرائيل”، لا يعني أبداً أنه تمرد على الانحياز الصارخ لـ”إسرائيل”، ولا هو أصلاً في وارد التمرد عليه. فـ”إسرائيل” تتمتع “بثقل ذاتي” ونوعي في الولايات المتحدة يجعلها فوق الخلافات الحزبية. فهي تمتلك ثقلاً معنوياً وسياسياً وأخلاقياً وتاريخياً في الولايات المتحدة. وعندما نتحدث عن “ثقل إسرائيل الذاتي”، فنحن نتحدث عن ذلك المشروع (فوق الحكومي وفوق الحزبي الإسرائيلي) الذي يُنْظَرُ له أمريكياً على أنه قصة نجاح باهرة في محيط تتلاطم أمواجه وتسعى لإغراق تلك السفينة شبه المعدمة في ظلمات سمائه وهيجان مائه. هذا “الثقل الذاتي” بما يمثله من وطأة تاريخية وسياسية ومعنوية وأخلاقية، ترى أن التخلي عن “واحة الديمقراطية” في صحراء قاحلة من الدكتاتوريات، يعدّ بحد ذاته تدنياً وسقوطاً أخلاقياً ما بعده سقوط. وهذا هو بالدرجة الأولى ما يبطئ جهود أوباما ويضعفها. يبرز مفعول السياق الأخير للتحليل في نفوذ “إسرائيل” الرهيب على الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه: النواب والشيوخ. فاللوبي الصهيوني يمتلك إمكانيات مالية وإعلامية هائلة تجعل من أي عضو في الكونغرس يفكر ألف مرة قبل أن يتحداه. خصوصاً إذا أَضفنا إلى ذلك اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية بعد أقل من عام ونصف من الآن، وهذا ما يجعل من أي ضغط على “إسرائيل” أمراً صعباً.
الثالث: عدم الضغط على الأوروبيين بحيث تعترف هذه الأخيرة بـ”الدولة الفلسطينية”:
هذا الاحتمال يجعلنا نفهم تلك التقارير الإعلامية التي نقلتها بعض الصحف الأمريكية هذا الشهر من أن إدارة أوباما أعطت حكومة نتنياهو شهراً لقبول خطة الرئيس الأمريكي، كما جاءت في خطابه يوم التاسع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي. ونقلت الصحافة الأمريكية أن ستيف سيمون، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال لزعماء اليهود الأمريكيين يوم الجمعة (10/6/2011) بأن على حكومة نتنياهو أن ترد خلال شهر واحد على خطة الرئيس أوباما لبدء المفاوضات المباشرة. وقد حصل موقف الإدارة الأمريكية على دعم قوي من قبل الرباعية الدولية، وذلك بدعوتها “إسرائيل” إلى إعلان قبولها بخطاب أوباما كأساس للمفاوضات المباشرة. كما نقلت الصحف عن مسؤولين أمريكيين تذمرهم من الطلب الإسرائيلي المتكرر من الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الأوروبيين، وخصوصاً بريطانيا وفرنسا، وذلك لضمان عدم دعمهم للفلسطينيين في مجلس الأمن والأمم المتحدة فيما يتعلق بنيتهم طلب اعتراف أممي بدولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر القادم. وحسب أولئك المسؤولين، فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية خارج نطاق المفاوضات الثنائية، ولكن المشكلة حسب أولئك المسؤولين أن الحكومة الإسرائيلية لا تساعد الإدارة الأمريكية في مسعاها للضغط على حلفاءها الأوربيين في هذا السياق وذلك ما دامت ترفض البديل الذي قدمه الرئيس أوباما.
مقترحات:
1- التأكيد على إدراج “الثورات العربية” القضية الفلسطينية كعنوان أساسي في مشروعها النهضوي العربي والإسلامي.
2- تسليط الضوء على انحياز أمريكا الكامل لصالح “إسرائيل”، على حساب المصالح العربية عموماً والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص؛ كواحدة من وسائل الضغط على الإدارة الأمريكية، كي تضطر إلى مراجعة مواقفها في ضوء مصالحها في المنطقة.
3- إطلاق فعاليات شعبية في سياق “الثورات العربية” تأييداً للشعب الفلسطيني ودعماً لقضيته العادلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر والانحياز الأمريكي الدائم.
4- مطالبة القيادة الرسمية الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ المصالحة، وإطلاق المرجعية القيادية؛ بما يساعد على بلورة استراتيجية وطنية موحدة تشكل أفقاً سياسياً للحراك الفلسطيني، ولا تلتزم بالسقف الأمريكي ولا محدداته المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
* كتب مسودة هذا التقدير مشكوراً الأستاذ أسامة أبو ارشيد.
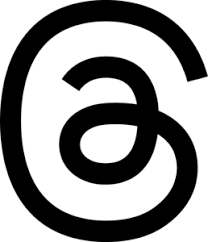

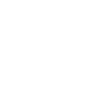
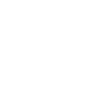
أضف ردا