بقلم: د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
تقول قصة قديمة إن امرأة كانت كثيرة الضجر والشكوى إلى زوجها بسبب سكنها وأطفالها في غرفة واحدة تضيق بهم وباحتياجاتهم. ولأن الزوج كان ضيّق ذات اليد لا يملك ما يُحسّن به أحوال أسرته، قرر أن يلقّن زوجته المزعجة درساً. وذات يوم أحضر صندوقاً من الدجاج الحي، وطلب من زوجته أن تجد له مكاناً في الغرفة لأن صديقه تركه أمانة عنده، فانفجرت غاضبة ولكن لم يكن أمامها سوى الاستسلام أمام إصراره.
وفي اليوم الثاني أحضر بطاً وإوزّا وأصر على أن تجد له زوجته مكانا، وفي اليوم التالي أحضر كلباً، وكذلك في اليوم الرابع أحضر حماراً. ورغم ثورات الغضب والاعتراض، فإن الزوجة كانت تتعايش في النهاية مع الأمر الواقع، لعدم وجود بدائل أفضل.
ووسط أجواء الضيق الخانق والروائح الكريهة وأصوات النهيق والعواء والنقنقة والبطبطة، صارت الزوجة التعيسة تحلم بـ”تحرير” بيتها واستعادة ما انتزعته “الحيوانات” منه، بدلا من السعي إلى توسيعه، وقررت “النضال” بكافة “الطرق السلمية” لتحقيق مطالبها العادلة.
وبعد مدّة أرجع الزوج الحمار إلى صاحبه، ففرحت الزوجة أيما فرح لتخلصها من رفساته وروائحه ونهيقه، وراحت توسع مكاناً لاثنين من أطفالها، ثم أعاد الزوج الكلب، ثم البط والإوز ثم الدجاج، فاحتفلت الزوجة بانتصاراتها المتتالية.
وقامت المرأة المنكوبة السعيدة تشكر زوجها على هذا البيت الواسع الذي أسكنها فيه، وسط شعور بنشوة الانتصار بعد استعادتها “حقوقها الشرعية المغتصبة”.
المقصود من القصة أن تجربة ما هو أسوأ قد تؤدي بالمرء إلى أن يقنع بما هو سيئ، بدل أن يتطلع إلى ما هو أفضل.
كي الوعي
السلوك البشري عبر التاريخ استخدم الفكرة بأدوات مختلفة في تكريس سياسات ظالمة، كالتعامل مع العبيد، أو الطبقات الدنيا من المجتمع، أو في تعامل أجهزة المخابرات مع قوى المعارضة، كما استخدمه المستعمرون مع مستعمراتهم، وكذلك يستخدمه الصهاينة الإسرائيليون مع الدول العربية ومع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة.
القوة الطاغية التي يملكها العدو، والاستعداد للانتقام الشرس من قوى المقاومة، بتنفيذ سياسات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وسفك الدماء وتدمير المنازل على رؤوس أصحابها، وإعادة الحياة قروناً إلى الوراء، والحصار والإذلال، والقضاء على مصادر الرزق، ومنع حرية الحركة ومنع الخدمات الصحية، وشن عمليات الاعتقال والتعذيب.. كلها أدوات يستخدمها الإسرائيلي لمحاولة هزيمة الفلسطيني نفسيا وإشعاره بالعجز ليستسلم للأمر الواقع.
ولعل تعبير “كي الوعي” يصلح لوصف الحالة المشار إليها، وكان من أوائل من استخدمه كمصطلح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال موشيه يعلون.
وربما تكون عملية توصيف كي الوعي حالة جدلية بسبب وجود منطقة رمادية بينها وبين حالة ارتقاء الوعي، إلا أن الفارق الأساسي بينهما يتمثل في أن ارتقاء الوعي يعني لجوء المقاومة إلى استخدام وابتكار أدوات جديدة، وقدرتها على التفاعل مع البيئة المحيطة والظروف المتغيرة بشكل أفضل، شرط ألا يؤدي ذلك إلى انحراف أو تراجع عن الهدف الأساسي.
أما كي الوعي فيعني تشكيل قناعات وسياسات جديدة تنحرف عن الهدف الأصلي وتقزّمه، إلى أن تكون في نهاية المطاف متفقة أو غير متعارضة مع شروط العدو، أو تحت السقف الذي يقبله.
المقاومة بين ارتقاء الوعي وكيّه
عندما أنشأ الصهاينة كيانهم الإسرائيلي على نحو 77% من أرض فلسطين وشردوا نحو 60% من شعبها في حرب 1948، كان الانشغال الفلسطيني والعربي والإسلامي منصبا على تحرير فلسطين وإنهاء الكيان الإسرائيلي. وعندما نشأت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 كانت معنية بهذا الهدف.
وعندما حدثت كارثة حرب 1967 أخذ يسود في الساحة العربية شعار “إزالة آثار العدوان” واسترجاع الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، مع نسيان أو تناسي هدف تحرير كل فلسطين.
الخلط بين الشعور بالانتصار وبين الوقوع تحت حالة كي الوعي بسبب الخبرة الناتجة عن الصراع أو الحرب، قد يؤدي إلى مشاعر خادعة بإمكانية تحقيق مكاسب وفرض الإرادة على العدو، في الوقت الذي تتم فيه عمليات تراجع وتنازل، تبررها وتغطيها حالات تزايد الشعبية ونشوة الانتصار والثقة بالنفس، وتكرسها حالات انعدام المعارضة، وضعف النقد الذاتي، واللهاث نحو تحقيق مكاسب سريعة، وتقزيم الأهداف، والسعي للحصول على “البردعة” بعد الفشل في امتلاك “الحمار”.
حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 قُدّمت للجماهير باعتبارها انتصارا عربيا، غير أنها كانت آخر الحروب العربية، وتولدت قناعة لدى الأنظمة العربية بعدم إمكانية هزيمة إسرائيل أو إزالتها، خصوصاً مع حالة اختلال موازين القوى في ضوء الدعم الأميركي والغربي المطلق لإسرائيل.
وهكذا، ففي الوقت الذي كان يتم فيه التغنّي والاحتفال “بانتصار” أكتوبر، كان النظام العربي الرسمي يسير باتجاه التسوية والاعتراف بإسرائيل (كما فعل السادات في مصر)، وليس بمراكمة الإنجاز باتجاه عملية التحرير.
تُرى هل كان على العربي أن يحتفل بروعة “الانتصار” أم يبكى على تراجع مشروع التحرير؟ وهل كان الذي حدث ارتقاءً للوعي أم انتكاسة له؟
أما الأنظمة العربية التي قررت مقاطعة النظام المصري بعد توقيعه اتفاقية كامب ديفد عام 1978 واتهمته بالتخاذل والخيانة والعمالة، فهي نفسها التي لحقت به وتبنت مشروع التسوية فيما بعد.
الثورة الفلسطينية تعرضت لضغوط وحروب وتحديات هائلة من العدو والصديق، وامتزجت في خبراتها حالات من ارتقاء الوعي ومن كيّه.
كانت حركة فتح وبعض فصائل الثورة تظن في بداية انطلاقتها أن عملياتها عبر الحدود ستجبر الأنظمة العربية على خوض المعركة مع إسرائيل، ولكن نظريتها هذه سرعان ما تضعضعت بعد حرب 1967.
وعندما حاولت تأسيس قواعد العمل الفدائي في دول الطوق، وجدت نفسها تدخل في مستنقع حرب الاستنزاف والترويض والتركيع والإلغاء من الأنظمة العربية التي اعتبرت ذلك مساساً بسيادتها، واستنزف العمل الفدائي في الخارج بسبب الأنظمة أو البيئة المعادية أكثر مما استنزف من الإسرائيليين أنفسهم.
في البداية حدث كيّ لوعي الأنظمة العربية بالخسائر الهائلة والأثمان الباهظة التي ستدفعها في حالة السماح للعمل الفدائي على أراضيها، ثم حدث كيّ لوعي القوى الفلسطينية بعدم القدرة على العمل الفدائي من الخارج لما سيسببه ذلك من صراع وإراقة دماء واستنزاف قوتها مع الأنظمة العربية.
الخبرات المتراكمة لدى منظمة التحرير والمسارات الإجبارية التي كانت تجد نفسها مضطرة إليها، جعلتها تتكيف مع الواقع بحجة الحفاظ على المكتسبات والاستفادة من الفرص المتاحة. غير أن هذه الواقعية جعلت منها جسماً قابلاً “للطَّرْق والسَّحب” والانضغاط والتقزيم، وشجعت الأعداء والخصوم على القيام بالمزيد من الضغوط.
وهكذا، فبعدما كان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين حسب الميثاق الوطني الفلسطيني، أصبح بحسب برنامج النقاط العشر عام 1974 إحدى الوسائل والطرق، وأصبح من الممكن إقامة الكيان الفلسطيني على أي جزء يتم تحريره أو الانسحاب الإسرائيلي منه، وهو ما يتيح مشاركة المنظمة في عملية التسوية كإحدى وسائل “النضال”.
وبعد ذلك، تعرضت المنظمة لعمليات تركيع وتطويع من خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وعبر الاجتياحات الإسرائيلية للبنان خصوصاً عام 1982 التي أدت إلى خروج العمل الفدائي الفلسطيني من الأراضي اللبنانية وانتهاء عمليات المقاومة الفلسطينية من الخارج باتجاه فلسطين المحتلة.
وقد شجع ذلك الاتجاهَ البراغماتي السائد في المنظمة اندفاعُها نحو “الوقوع” في المزيد من الواقعية التي كُوي وعيُها، ولا تتحدى الواقع في محاولة تغييره، وإنما تستسلم له للاستفادة مما قد تعطيه الفرص المتاحة، وتتعامل ضمن سقف وحدود المسارات الإجبارية التي حدّدها الخصوم والأعداء.
ولذلك، لم تتعامل قيادة منظمة التحرير مع الانتفاضة المباركة التي اندلعت عام 1987 باعتبارها استثمارا في عملية التحرير، وإنما تعاملت معها كفرصة لإشراكها في عملية التسوية.
وبينما كان الناس منتشين بأجواء الانتفاضة، قدمت المنظمة أحد أكبر التنازلات في تاريخها أثناء انعقاد المجلس الوطني التاسع عشر في نوفمبر/تشرين الثاني 1988 عندما قبلت لأول مرة قرار تقسيم فلسطين، وقبلت الاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يتعامل مع قضية فلسطين باعتبارها قضية لاجئين. وغلّفت ذلك بإعلان يفتقر إلى الجدية وهو إعلان استقلال فلسطين.
ووجد التيار البراغماتي الذي يقود المنظمة في نهاية المطاف نفسه يعلن إيمانه بالتسوية السلمية وينبذ العنف والكفاح المسلح، ويتنازل عن ثوابت وخطوط حمراء موجودة في الميثاق الذي قامت عليه منظمة التحرير، ثم وصل به الأمر إلى إلغاء البنود التي قامت المنظمة على أساسها، في المجلس الوطني الحادي والعشرين عام 1996.
على مستوى قيادة منظمة التحرير، حدث كيّ للوعي في ثلاثة جوانب:
1- التعامل مع إسرائيل كحقيقة لا يمكن تغييرها، وبالتالي التنازل عن معظم أرض فلسطين التاريخية.
2- تبني فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحصيل ما يمكن تحصيله، على اعتبار أن الزمن لا يلعب لصالح الفلسطينيين والعرب، وأن ما يعرض الآن على مائدة التسوية أفضل مما قد يعرض مستقبلا.
3- الشعور بعدم جدوى المقاومة المسلحة والثورات والانتفاضات في تحصيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي تغيير موازين القوى، وفي إجبار الإسرائيليين على تقديم تنازلات.
ويمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه مثالاً لأولئك الذين لا يؤمنون بالمقاومة المسلحة وينظرون إلى الانتفاضة المسلحة باعتبارها عملية عبثية أدت إلى نتائج وخيمة، وهو يؤمن بالتسوية كخيار إستراتيجي، وبأن لا بديل عن مسار التسوية إلا مسار التسوية نفسه.
من جهة أخرى، في مقابل الحالة البئيسة لكيّ الوعي، حدث ارتقاء للوعي الفلسطيني مكّنه من الصمود والاستمرار في مواجهة القوة الطاغية الإسرائيلية، وتمثّل في جوانب من أبرزها:
1- التمسك بالأرض والثبات عليها مهما كانت الظروف، ورفض الهجرة والتهجير، والإصرار على البقاء حتى بعد المجازر وهدم المنازل.. وغيرها.
2- إدراك ضرورة تحمّل الفلسطينيين لمسؤولياتهم النضالية، وعدم انتظار الأنظمة العربية والإسلامية لتحرير أرضهم.
3- إدراك أهمية الداخل الفلسطيني في عملية المقاومة، وانتقال التركيز في العمل المقاوم من الخارج إلى الداخل، بعد إغلاق الحدود في وجوههم.
4- تطور وسائل الإبداع في العمل المقاوم، كما في العمليات الاستشهادية، وتطوير صواريخ المقاومة، وتطور وسائل العمل السياسي والإعلامي والاجتماعي والتعبوي في خدمة العمل المقاوم.
وربما كان على تيارات المقاومة الحالية -خصوصاً حماس وحزب الله- الحذر من الوقوع في بعض مظاهر كيّ الوعي، نتيجة إدراك حجم القوة الطاغية التي يستخدمها العدو، وما يسببه من قتل ودمار واسع.
فرغم فشل الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز 2006 وتحقيق المقاومة إنجازا كبيرا في صدها للعدوان، فإن إسرائيل حققت أحد أهداف الحرب وهو هدوء الجبهة الشمالية، إذ بعدما كان من السهل على المقاومة اتخاذ قرار بشن عملية مقاومة عبر الحدود، أصبح عليها أن تفكر مرات عديدة بعمل كهذا بعد انتهاء الحرب.
وكذلك هو الأمر بالنسبة لحماس التي كانت ترفض عقد الهدنة إلا بشكل مؤقت وضمن شروط محددة. ولذلك عندما انتهت هدنة الأشهر الستة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2008 أطلقت نحو 50-70 صاروخا يومياً من قطاع غزة مطالبة بفك الحصار، ومستخدمة حقها في استمرار المقاومة.
غير أنه منذ فشل العدوان الإسرائيلي على القطاع نهاية 2008 وبداية 2009 وتمكّن المقاومة من إجبار الإسرائيليين على الانسحاب، دخل القطاع في هدنة فعلية غير محددة، ولم تعد حماس وقوى المقاومة تستخدم الصواريخ كأداة من أدوات فك الحصار.
وبالتالي فإن الإسرائيلي حقق عمليا أحد أهدافه وهو هدوء جبهته مع قطاع غزة، وعدم تعرض نحو مليون إسرائيلي لخطر إطلاق الصواريخ، ودون أن يرفع حصاره عن القطاع.
مواجهة كيّ الوعي
ترى ما هي الأمور التي تعين المقاومة على أن لا تقع أسيرة لحالات كي الوعي؟
لعل من أبرز النقاط بعد حسن الاستعانة بالله والتوكل عليه، ما يلي:
– التمسك بالثوابت والحفاظ على الأهداف العليا دونما تنازل أو تغيير.
– إفساح المجال للنقد الذاتي ومراقبة الأداء والمحاسبة على التقصير.
– الالتصاق أكثر بنبض الجماهير ومعاناتها وتطلعاتها.
– عدم الاغترار ببعض المكاسب السريعة ذات الطبيعة المظهرية كالاتصالات والعلاقات السياسية، وبعض أشكال الدعم المادي والاحتضان مدفوعة الثمن.
– التفريق بين الفرص المتاحة والفخاخ القاتلة، كشعارات “الرفاه تحت الاحتلال” والسعي لبناء السلطة قبل التحرير، والاستقواء بالعدو أو القوى الخارجية لتصفية حسابات مع القوى الوطنية المنافسة.
– التعرف على نقاط ضعف العدو، ووضع اليد على الثغرات في بناه السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، واستشعار القدرة على النفاذ من خلال هذه الثغرات لتطوير أدوات المقاومة، وإدراك أن العدو لديه معاناته وأزماته أيضاً، على قاعدة “إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون” (آل عمران: )، وبالتالي بقاء الأمل بإمكانية التغيير والتحرير مع تداول الأيام والأجيال.
وأخيرا.. فالمطلوب أن لا تقع المقاومة في أسر الهزيمة النفسية، وأن تستشعر معاني العزة والكرامة والحق والعدل، وأن لا تسمح للعدو باختراق بناها الفكرية والأيدولوجية، والعبث بثوابتها، ووضع سقف تطلعاتها وآمالها.
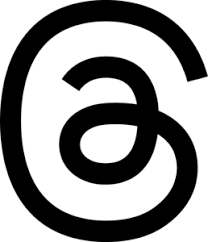

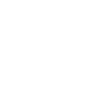
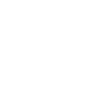
أضف ردا