ولد الشّيخ أحمد ياسين في حزيران 1936، وعايش النكبة؛ وأدرك يومها ضرورة أن يعتمد الشعب الفلسطيني على سواعد أبنائه وأن لا يركن إلى مساعدة أحد؛ حتى ولو كانت الدول العربية. وأيَّد قيادة الحاج أمين الحسيني لمسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب 1948، وبسبب معاناة الفقر والجوع التي ألمّت بأسرته؛ غادر المدرسة في العام الدراسي 1949 –1950؛ ليذهب إلى معسكرات الجيش المصري ويحضر ما يزيد عن حاجة الجنود ليطعم أهله!!
لم يقعده الشلل النصفي الذي أصابه في صيف العام 1952، من متابعة دراسته الثانوية والعمل في مجالي التدريس والدعوة الإسلامية؛ حتى أصبح أشهر خطيب في القطاع، بعد احتلاله من قبل القوات الاسرائيلية.
تشبَّعت شخصيَّته بفكر “حركة الاخوان المسلمين” الذي يدعو إلى “الوسطيَّة” و”الشمولية”، ويتبنى نظرية أنَّ الإسلام “سيف ومصحف”. انتمى إليها في العام 1955، وآل إليه أمر قيادة حركة الإخوان المسلمين في فلسطين في العام 1968. وأسّس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في 1987.
حرّض للاحتجاج على العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ورفض الإشراف الدولي على قطاع غزة وطالب بعودة الإدارة المصرية إليه.
ألقي القبض عليه في سنة 1983 من قبل قوات الاحتلال بتهمة حيازة أسلحة، وحكمت عليه المحكمة 13 عاماً. أفرج عنه في 20 أيار/ مايو 1985، جراء عملية تبادل أسرى مع القيادة العامة. ثم اعتقل في 18 أيار/ مايو 1989، لدوره الكبير في إشعال الانتفاضة وتوجيهها؛ فحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن مدى الحياة إضافة إلى 15 عاماً أخرى بتهمة التحريض على اختطاف وقتل جنود، وتأسيس حركة حماس والجهازين العسكري والأمني. أفرج عنه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 1997، نتيجة عملية تبادل بين المملكة الأردنية والكيان الاسرائيلي، بعد محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” خالد مشعل.
كان “حنوناً”
جُبلت شخصية الشيخ بمشاعر الرحمة والحنان؛ حيث توفي والده وهو في الثانية من عمره، وتحركت في عروقه مشاعر الرأفة منذ نعومة أظافره؛ فطلب من أخيه الأكبر أن يحضر له آلة الفلافل كي يبيع ويصرف على أخواته “البنات”. ولم يمنعه عجز الشلل التام، الذي أصابه وهو في سن السادسة عشرة من عمره، أن يكون “دوماً حنوناً” مع زوجته وأبنائه وبناته.
وبقيت لزوجته مكانة خاصة في برنامج حياته كافة، حتى عندما كان يجتمع مع الشهيد الدكتور الرنتيسي والكتور الزهار، كان ينادي عليها “لتتحدّث عن الآلام التي تشتكي منها” لإراحتها نفسياً ولتقديم العلاج المتاح لها.
وكذلك جعله قلبه المفعم بالحنان “يتعامل مع الآخرين” برفق ورحمة، فلم يتكبر على أحد ولو كان صغيراً؛ فقرّب إليه الصغار، لأنهم شباب الغد، واستمع للكبار واستوعب همومهم ولبّى احتياجاتهم؛ كان يوزّع راتبه الشهري ويقول: “أعطوا نصفه” للمحتاجين، وعندما يحضر محتاج آخر يريد المساعدة؛ يعطيه نصف ما تبقى من المعاش”. شارك الشيخ جميع أبناء شعبه في معاناتهم، ورفض التّميّز عنهم بقليل أو كثير؛ فردّ طلب السلطة بناء بيت له “يليق بمكانته”، لأنه كان يرى بأنَّ “هناك الكثير من الفلسطينيين بحاجة إلى بيوت”، وهناك من “هدّمت منازلهم أو نسفت” ولم يجدوا مأوى لهم لعدم قدرتهم على بناء مسكن يكفي أسرهم.
بنى مجتمعاً
أدرك الشيخ مبكراً بأنَّ مقاومة الاحتلال وإجباره على المغادرة، واستكمال مسيرة التحرير، تستلزم قيام مجتمع متماسك؛ تجمعه قيم إسلامية ووطنية هادفة. وأدرك أيضاً بأنَّ هذه العملية يجب أن تشمل الفرد والأسرة. لذلك، فقد بدأ بإعداد جيل “الكوادر” ليكون “نواة صلبة يعتمد عليها المجتمع”، وسار الشيخ في خطوات متدرّجة لتحقيق رؤيته هذه، فبدأ بـ:
– بناء الفرد: عدَّ الشيخ “الفرد الصالح أساساً في تكوين المجتمع الصالح”، فأعطى اهتماماً كبيراً لمهمة “تربية الأفراد وإعدادهم الإعداد السليم”. وتدرَّج في تربية الفرد فقسّمها إلى ثلاث مراحل (الأولى: الإستيعاب والثانية: التّكوين والثالثة: الإشعاع). وخاطب جيل الشباب موجّهاً إياهم: “حان الوقت يا أبنائي وأحفادي… لتتعلّموا وتتثقّفوا وتخترعوا وتكونوا سبّاقين”، لقناعته بأنَّ “التّغيير الثقافي هو المقدمة الأولى لتغيير الواقع الاجتماعي، ولأنه كان “يرى من خلال هذه النّقلة، إحداث التّغيير المطلوب في المجتمع”، الذي كان يريده مجتمعاً مقاوماً. لذلك نجده كثيراً ما كان يحضّ الشباب قائلاً: “تعلموا كيف تعيشون في ظلام دامس. علّموا أنفسكم كيف تعيشون الأيام بلا أجهزة كهربائية أو الكترونية”.
– وحماية الأسرة: فأعطى الأسرة مكانتها اللائقة في المجتمع؛ فالأسرة محضن الفرد الصالح، ونواة المجتمع الأولى. وبما أنّ المرأة تمثّل “اللبنة الأساسية في تكوين الأسرة”، فقد حرص الشيخ على إبراز شخصيتها في المجتمع الفلسطيني. ومن نفس المنطلق، حارب مظاهر تفكك الأسرة ومسبباتها التي كانت تتبدى من خلال العنوسة والتّرمّل؛ فشجّع إحياء احتفالات الزواج الجماعية، “واعتبر إصلاح الأسرة جزءاً لا يتجزأ من إصلاح المجتمع”.
وبما أن الاحتلال كان يقتل ويعتقل بلا تردد أو هوادة؛ الأمر الذي خلّف مزيداً من العائلات الثكلى فاقدة المُعيل. أدرك أنَّه لو استمرّ الحال كذلك فإنَّ اليأس والفساد قد يتسرّب إلى الأسرة الفلسطينية ومنها إلى الفرد والمجتمع. لذلك، فقد اهتمَّ “بأسر الشهداء والمعتقلين والجرحى”. وأسس لذلك مشاريع “كفالة اليتيم ودعم الأسر الفقيرة”.
– وتكوين المؤسسات المجتمعيَّة: واقتنع الشيخ بأنَّ مشروع الإصلاح الذي كان يحمله لا بد أن يمرّ عبر كافة مكونات المجتمع إذ كان يرى أن التغيير الناجح يجب “أن يكون اجتماعياً” بالدرجة الأولى. لذلك، فقد باشر بتأسيس المجمع الإسلامي عام 1979، الذي يهتم بالمجالات “التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية”؛ جاعلاً منه النواة الأولى للمجتمع. وأسهم في تأسيس الجامعة الإسلامية بغزة ومدارس دار الارقم وغيرها… .
وقد لجأ إلى أسلوب بناء المسجد ضمن المؤسسات الاجتماعية، اقتداءً بالأسلوب النبوي؛ حيث كان أول ما أشيد في المجتمع الإسلامي الأول هو المسجد. وجعل إلى جانبه “حضانة أطفال ومدرسة ونادياً رياضياً وداراً للمناسبات العامة وموقعاً للنشاطات النسوية”.
وواكب الشيخ نمو المجتمع الفلسطيني وتطوّره، فشجّع أبناء الحركة الإسلامية على تأسيس النقابات والمشاركة فيها؛ لما لهذه المؤسسات من دور في تماسك النّخب وأصحاب التّخصصات المتشابهة من أبناء الشّعب، ولما لها من تأثير في المجال المطلبي، ودعم الحركة الوطنية في الضغط على الاحتلال ومواجهته. وكذلك، فقد شارك الشيخ في “لجان تنسيق العمل الوطني” حيث كانت المواجهة السياسية ضد الاحتلال قد بدأت تّتخذ أشكالاً أكثر حدة ووضوحاً، وباتت القوى الفلسطينية بحاجة إلى التّعاون والتّنسيق أكثر من أي وقت مضى.
– وتوحيد الصّف الداخلي: واجه محاولات الاحتلال لتفتيت الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونسف الروابط العائلية والاجتماعية..، فحذر أبناء الشعب الفلسطيني من “التفرقة والانقسامات لأن ذلك يؤدي إلى العنف والضياع”.
وبثّ في أوساط الناس مصطلحات جديدةً للاختلاف، فكان طالما يردّد مقولة الإمام الشهيد حسن البنا: “سنقاتل الناس بالحب”؛ حيث لا مجال لاستخدام السلاح في الداخل الفلسطيني. ولازمه هم الوحدة حتى داخل المعتقل، فأنشد لها أبيات قال فيها:
هي الأوطان نحميها بسـيف ولا عزَّ لـها دون اتّفاق
توحَّــد صفّنـا أبـداً بعزم ولا صف يوجد بالشقاق
وحصر استخدام “السلاح في وجه العدو الصهيوني فقط”، وأما مع الشعب الفلسطيني؛ فالدعوة إلى الوحدة فقط.
وشهدت فترات الانتفاضتين (الأولى عام1987، والثانية عام 2000) “تكثيفاً في نشاط الشيخ في مجال الإصلاح الاجتماعي، وذلك سعياً منه للحفاظ على “تماسك النّسيج الاجتماعي الفلسطيني”.
– وتطبيَق احترام القانون: وما دام الاحتلال حريصاً على بث الفرقة داخل المجتمع الفلسطيني، فإنَّ غياب تطبيق القانون سيكون واحداً من أهم الميادين التي تنشر الشقاق بين أبناء المجتمع الواحد، وخصوصاً عندما تشتد المواجهة مع الاحتلال. لذلك، سارع الشيخ إلى “تأسيس لجان الإصلاح”. وقد استطاعت هذه اللجان فض النزاعات وتمكنت من إعادة الحقوق إلى أصحابها في ظل أحلك الظروف، وخصوصاً بعد بدء الانتفاضة الأولى؛ عندما “غاب القانون”، و”سحب كثيرون قضاياهم من المحاكم”. توجهوا إلى الشيخ ولجان الإصلاح، وكانوا مطمئنين بأنّ الشيخ سوف ينصفهم؛ بما فيهم المسيحي كان مقتنعاً بأنَّ الشيخ سوف يتمكن “من إنصافه من خصمه” المسلم.
وهذا ما جعل عدد من المراقبين يتوقّعون “أن تشهد المحاكم المدنية الفلسطينية حركة نشطة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بعد استشهاد الشيخ”.
صحح مسار القضية
بدأ مسارالقضية الفلسطينية يتخذ منحىً جديداً منذ خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان سنة 1982، وانطلاق انتفاضة 1987؛ حيث بدأت تتراجع أولوية المقاومة في القاموس الوطني إلى أن حلت محلها المفاوضات. وتحول هدف الحركة الوطنية الفلسطينية من التحرير إلى الاستقلال، وبعد ذلك من الدولة إلى السلطة.
فكان لابد من تصحيح هذا التبدّل؛ من أجل إعادة الاعتبار إلى ثوابت القضية وأهدافها وأدواتها النضالية ومفاهيمها الفكرية والسياسية. فأبدى الشيخ رأيه في السلطة، وحدد مكانة المقاومة، ورسم معالم وحدود العلاقة مع العدو المحتل.
1) السلطة: ميّز الشيخ، منذ البداية بين مؤسسة السلطة وبيّن مهمتها ووظيفتها، فآمن بأنّ “قيام السلطة”التي تقوم على مصالح الناس، جزء من المنهج الرباني. من هذا المنطلق قال: “نحن رفضنا الاتفاقية (أوسلو) وسنقاومها “بالطرق الحضارية”؛ لأنه كان مقتنعاً بأنَّ فلسطين لا تصلح ” “للمفاهيم والأعمال الانقلابية”. في الوقت الذي كان يرى عبثيّة “الانشغال بعمليات الترقيع”، لكونها تتعارض مع منهج الإخوان ودعوتهم الكلية الشاملة للتغيير. وبيَّن الشيخ أهم وظيفتين “للسلطة”؛ تمثّلت الأولى في المرجعيَّة السياسيَّة؛ لذلك شاركت حماس بفاعلية في “مرجعيَّة القوى الوطنية والإسلامية”. وظهرت الثانية عبر دعوته لتشكيل “الجيش الشعبي”، على أن تكون مهمّته “المراقبة والمرابطة على الثغور، والمشاركة في المواجهات إذا تمّ الاجتياح” من قبل قوات الاحتلال. وكان لذلك دوره الفاعل في صد اجتياحات جيش الاحتلال المتكررة. وأصبح الجيش الاسرائيلي يخشى التّوغل في قطاع غزة، لأنه يشعر بأنّ القطاع ملئ بالعبوات الناسفة وصواريخ القسام.
وأدرك الشيخ بواقعيّته، محاذير أن يقع الشّعب الفلسطيني بفراغ في القيادة والمرجعيَّة، فأكَّد في أكثر من موقف بأنَّ “المنظمة تمثّل الشّعب الفلسطيني، لكن مع بعض التحفظات على خطها السياسي”. وتعامل بكثير من المرونة مع الخط الذي سارت عليه المنظمة، من خلال مسيرة التسوية؛ فلم يعترض على مبدأ التّفاوض مع سلطات العدو “إذا ما أقرّت بحقوقنا الكاملة، واعترفت بحق الشّعب الفلسطيني في العيش داخل وطنه حراً مستقلاً”، مع قناعته التامة بأنَّ (إسرائيل) لا تريد أن تعطي الفلسطينيين شيئاً من حقوقهم الوطنية، بما فيها تلك التي أقرّتها لهم القرارات الدولية. وأكّد بأنَّ “الحركة (حماس) لن تتفاوض كبديل عن منظمة التحريير الفلسطينية”، باعتبار أنَّ المنظمة قد اكتسبت الشرعية في تمثيلها للشعب الفلسطيني، وهي التي بدأت مسيرة التسوية السلمية مع الاحتلال. هذا إضافة إلى أنَّ الشيخ كان يرفض ازدواجية القيادة والقرار؛ وإنَّما ضمن الثّوابت الوطنية.
وعلّق موافقته بالمشاركة في السلطة لحين تحديد طبيعة مرجعيتها؛ ففي الوقت الذي أعلن رفضه المشاركة “لأنّ الاحتلال هو المسيطر على الأرض”، ويفرض على السلطة كل شروطه. قال الشيخ “نريد مرجعيّة للحكومة”، وبين ضرورة أن تكون هذه المرجعية “مرجعية جماهير وليس مرجعية أفراد”. وحدّد أكثر عندما قال: “يجب أن يكون هناك مجلس وطني منتخب” يكون بمثابة المرجعية الوطنية العليا لهذه الحكومة.
ودعا إلى مرحلية بناء السلطة؛ حيث تقوم قناعة الشيخ على أساس أنّ الرؤية الكليّة الشاملة لا تتعارض مع مبدأ التدرّج والمرحلية في إحداث التغيير والوصول إلى الهدف المنشود. انطلاقاً من هذا الفهم، فقد رأى أن “الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أي شبر من فلسطين نحرره” ما دام هذا التّدرّج يسير باتّجاه الكليات عن وعي، “وبمرجعية فلسطينية”.
2) المقاومة: مارس الشيخ فهماً للمقاومة أوسع وأشمل من مجرد مقارعة العدو بالحجر والبندقية. فعبّر عن المقاومة على أنّها جزء من الجهاد في سبيل الله، الذي يتمركز حول “محاربة الشهوات ومحاربة النّفس الأمارة بالسوء وتحسين السلوك الانساني نحو طاعة الله ورسوله”، كما عدّ “الصدع بكلمة الحق جهاداً في سبيل الله”. وهذا ما دفعه للجهر بالمواقف المناهضة للاحتلال منذ بداية احتلاله الضّفة الغربية وقطاع غزة في سنة 1967، وتحريض الناس على عصيان أوامر سلطات الاحتلال.
وفيما يتعلّق بمقاومة العدو بالقتال، فقد كان يتساءل: “أليس من حقّنا أن نقاوم المحتل، ونقاتله، ونبقى صفاً واحداً؟”؛ في إشارة منه إلى أنَّ الحفاظ على وحدة الصف الداخلي ونبذ الاقتتال، دليل مضاء المقاومة وصحة اتجاهها. وكان كثيراً ما يردد: “رفعت شعاراً لا زلت أتمسّك به (لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين): هذا شعارنا وسنبقى كذلك حتى يتحرّر وطننا وينتصر شعبنا، ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إن شاء الله”.
ظهر حب الشيخ للمقاومة من خلال قوله “إنَّ أسعد يوم في حياتي يوم انتزعت قراراً بحمل السلاح للدفاع عن هذا الوطن”، إلا أنّ ميزاته القيادية جعلته ينظر في طبيعة المقاومة ومستقبلها والعمل على توفير الظروف الملائمة لاستمرارها وتأثيرها في فتّ عضد الاحتلال. فشخّص ثلاث عوامل رأى ضرورة توفيرها للإيذان بانطلاق المقاومة؛ جعل منها “إعداد جيل يملك المؤهلات الروحية والثقافية والفكرية لكي يكون قادراً على خوض المعركة” و”تقوية أواصر التماسك الاجتماعي” بين أبناء الشعب الفلسطيني، و”التّعاطف الخارجي والاستعداد لتوفير المال اللازم لذلك”.
وبعد البدء بتشكيل المجموعات العسكرية، اهتمّ بتطوير قدرات كتائب عزالدين القسام القتاليّة. وكان اهتمامه بتطوير صاروخ القسّام كبيراً؛ لدرجة أنه تابع مجموعات التصنيع في البحث عن “الكرودايت”؛ القوة الدافعة لصاروخ الكتف”. وكلَّف الكتائب بإيجاد “مجموعات خاصة مهمتها الترتيب لاختطاف جنود ليتم التبادل والافراج عن المعتقلين”. ودعم توجّه كتائب القسام للقيام بعمليات عسكرية مشتركة” مع أجنحة الفصائل العسكرية. وأسس الجهاز الأمني لمواجهة “الدور التخريبي الذي تقوم به المخابرات (الاسرائيلية)عند بعض الشباب” سواء كان ذلك في الجانب الأخلاقي أم الأمني.
3) العلاقة مع العدو الاسرائيلي: وبما أن الشيخ كان يحمل الفهم الإسلامي “الوسطي”، فقد كوَّن تصوّراً واضحاً ومتوازناً عن كيفية تحديد الموقف من العلاقة مع اليهود المحتلين؛ فصحح الفهم السائد حول طبيعة العلاقة مع الهود، بقوله: “نحن لا نعادي اليهود لأنهم يهود”. وبيَّن حكم العلاقة مع المعتدين والمحتلين، سواء كانوا يهوداً أم غير يهود؛ فكان دائماً يردّد “نحن أناس نريد الحق” و”نعادي دولة فقط لأنها “قامت على أرضنا ]وسلبت[ حقنا”. ثم تصدّى لأكثر قضيتين استحقاقاً والتباساً على الساحة الفلسطينية؛ التفاوض والهدنة.
أ) التفاوض: ميّز التعامل مع العدو إلى ثلاثة مستويات: الأول: المقابلة مع إحدى وسائل العدو الإعلامية: رأى فيها وسيلة تساعدنا في إظهار حقنا أمام الرأي العام عموماّ والاسرائيلي خصوصاً، ولذلك وافق على إجراء مقابلات صحفية أو إذاعية مع وسائل الإعلام الاسرائيلية: كي لا يحرم الفلسطينيّون أنفسهم “من هذا المنبر”.
الثاني: الاستدعاء والاعتقال: فاعتبر بما أنّنا “نعيش تحت ظل حكم عسكري” يستدعي أي فرد منّا ولا يستطيع أن يرفض؛ ففي مثل هذه الحالة قال الشيخ رداً على سؤال إحدى وسائل الإعلام الاسرائيلية “إذا استدعيت من قبلكم فأنا مستعد لمقابلة أي شخص تريدونه “في حالة الاستدعاء”، وكذلك في حالة الاعتقال.
الثالث: التفاوض: ناقش الشيخ فكرة التفاوض منطقياً، قائلاً: “فقد الفلسطيني كل شيء” و”لم تعلن (إسرائيل) ماذا تريد أن تعطي للشعب الفلسطيني”، لذلك رأى أنَّه من “الأجدر أن تتكلّم الآن (إسرائيل)”، “لا أن يتكلّم الفلسطينيون”. فأثّرت هذه القناعة على موقفه من مبدأ التّفاوض؛ حيث رفض المبدأ “قبل أن يبين العدو أنه مستعد للتنازل عمّا اغتصبه من أرضنا؛ ولو الأرض المحتلة سنة 1967”.
يكتسب موقف الشيخ هذا، قوة نتيجة انسجامه من المقررات الدولية والإجماع الوطني الفلسطيني. وبهذا يكون قد صحح مسار القضية، وأعاد زمام المبادرة إلى الطرف الفلسطيني؛ فبدل أن يسعى الفلسطينيون خلف السّراب الاسرائيلي الذي لن يصلوه، يصبح باستطاعة الفلسطينيين في موقع الإجماع الوطني المدعوم بالمقررات الدولية؛ مطالبة العدو الاسرائيلي بالإعلان عن نواياه تجاه القضية الفلسطينية، وبتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه، وأقلّها الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة. جاء هذا التصور تحت عنوان “المرحليّة” التي دعى الشيخ إلى تبنيها كاستراتيجية وطنية، تأخذ بنظر الاعتبار ميزان القوة الدولي. كما جعل الشيخ هذا الالتزام الاسرائيلي مقابل هدنة، وليس مقابل الاعتراف.
ب) الهدنة: يعدّ الحديث عن الهدنة من أكثر المواضيع دقة وحرجاً، خصوصاً أنَّه جاء في ظل البحث عن (السلام الدائم) و(الاعتراف) بشرعيَّة الاحتلال و(تصدع الوحدة الوطنية الفلسطينية ونشوب حرب أهلية) داخلية. فكان من الطبيعي أن ينبري قائد فلسطيني بوزن الشيخ أحمد ياسين، للتصدي لمثل هذا الاستحقاق؛ فهو يمثّل قيادة أكبر فصيل فلسطيني يتبنى استراتيجية المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، وشيخاً يلتزم الفتوى الشرعية وفق القواعد الإسلامية.
فجاء طرح الشيخ للهدنة لكي يضيف مساحة تفاهم سياسي على الساحة الفلسطينية الداخلية، ولكي يقدم زاوية نظر جديدة يستطيع العالم من خلالها إدراك “أننا نريد السلام”. فقدّم الشيخ مبادرة الهدنة ضمن تصوّر تفصيلي شامل، عرّف فيه الهدنة على أنّها “إيقاف القتال بين طرفين متقاتلين”. وحدّد لها مدة لاعتباره بأنَّها يجب أن تكون “هدنة مؤقتة” لأنَّ الشيخ بيَّن أنَّه “لا يوجد عندنا سلام دائم شامل” مع العدو الاسرائيلي؛ فهو يرى بأنَّ القضية الفلسطينية هي “قضية تاريخية نتركها للتاريخ يقضي فيها”. وأشار إلى أنَّ هذه الهدنة يمكن أن تستمر “لعشر سنين أو عشرين سنة”، وإذا انتهت الفترة دون مشاكل يمكن أن ” تتجدد تلقائياً”.
عرض الشيخ هذا التّصوّر في حال أعلن العدو “أنَّه مستعد لإزالة الاحتلال” عن أرضنا المحتلة بعد 67″ و”كل آثار الاحتلال”؛ المستوطنات والسجون، و”ألا تتدخل (إسرائيل) في شؤوننا”، لكي نتمكن من “إقامة دولة مستقلة، ومجلس تشريعي ينتخبه شعبنا في الداخل والخارج، وحكومة يرتضيها مجلسنا التشريعي”.
وفي حال ظهرت مشاكل بيننا وبين الاسرائيليين، فلا بد من حلّها قبل تجديد الهدنة. وفي حال التزمت (إسرائيل) بهذا العرض، أكَّد على مرجعيّة “السلطة الفلسطينية” قائلاً: “ندخل معها”. ليكون قد أعاد للسلطة اعتبارها في مرجعية القرار الوطني وصحح مسارها؛ من أجل استعادة الحقوق الوطنية، وحمى الوحدة الوطنية من خلال استرضاء التيار الفلسطيني الذي يعد نفسه صاحب مشروع السّلطة والتّسوية.
وأعاد للقضية هويتها
يدرك الشيخ بأنّ القضية الفلسطينية هي “قضية وطن وقضية مبدأ وعقيدة” لها في نفوس جميع العرب والمسلمين مكانة مميزة، كما يدرك بأنَّ الصراع مع الصهاينة له طبيعة حضارية؛ أي أنَّ (إسرائيل) جاءت ثمرة “مشروع استعماري صليبي صهيوني يستهدف فلسطين والعرب والمسلمين”. وبالتالي فإنَّ ارتباط القضية الفلسطينية بعمقها العربي والإسلامي سوف يوفر لها مزيداً من الموارد والدعم ويقرّب معادلة المواجهة من التّكافؤ. لذلك كان كثيراً ما يؤكّد على أنَّ الاحتلال الاسرائيلي “ليس عدواناً على الجغرافيا وحقوق الأفراد المادية بل هو عدوان على دين الأمة”.
فواجه محاولات عزل هذه القضية عن عمقها العربي والإسلامي، حتى ولو كان ذلك تحت شعار الخصوصية القطرية والقرار الوطني المستقل، فتوجّه إلى أنظمة الأمة وهيئاتها وجماهيرها بتأكيد حقيقة “أنَّ أرض فلسطين، أرض عربية إسلامية، اغتصبت بقوة السلاح من قبل الصهاينة ولن تعود إلاّ بقوة السلاح”. لذلك، كان يشدّد على ضرورة “ربط القضية بالأمة”. وعندما لمس تقصيراً في دعم الشعب الفلسطيني وجّه اللّوم إلى “دول هذه الأمة” وإلى “قواها وأحزابها وهيئاتها وأشخاصها” لأنهم: يغضون الطرف عن المجرمين الصهاينة، ولم يسهموا بمسح دمعتنا ولم يغضبوا غضبة حقه. وحاكم تقصير الأمة من منظور شرعي واعتبر أنَّ “الأمة كلها تؤاخذ وينالها العقاب الرباني في الدنيا والاخرة اذا سكتت”.
– الأنظمة والحكومات: تفهّم الشيخ واقع الأمة بعد ظهور الدولة القطرية الحديثة؛ الأمر الذي أدى إلى مغايرته عن تنظيرات الفقهاء الذين ينظرون إلى “وحدة العالم العربي والإسلامي” ويسعون لـ”إعادة الخلافة الإسلامية إلى الوجود”. وأدرك بأنّ “كل بلد له همومه وله مشاكله”، واستشهد لذلك بأننا “نواجه واقعاً فلسطينياً ونتصرّف بحسب واقعنا”. ودعا للأنظمة كي “تتغلّب على مشاكلها وأن تتوجّه للوقوف إلى جانب قضايا الأمة” وبالتّأكيد في مقدّمتها القضية الفلسطينية، ولم يسمح بالتدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد عربي، حفاظاً على الوحدة القوميّة، وضمان استمرار التأييد أو الدعم، ولو على مستوى الهيئات والجماهير، في ظل التسامح الرسمي.
– حاز رضا الأمة واحترامها: إنّ ما تقدم من سيرة الشيخ ونهجه بوّأه مقعداً متقدماً الأمة وأنظمتها؛ فسّر ذلك نجاح جولته في العام 1998 على كثير من الدول العربية حيث التقى بالجهات “الرسمية وغير الرسمية والتقى بقيادات إسلامية كثيرة”. وتفاعل جماهير الأمة بشكل لافت مع كل موافه ودعواته.
ويوم استشهاده في 22/3/2004، تحرّكت جميع أطياف الأمة من طنجة إلى جاكرتا وفي بلاد الغرب والشرق عموماً، لتشييع الشيخ المجاهد، فكرّسته إماماً، لتثير سؤالاً، من يرفع الراية في الأمة وفي القضية بعد أحمد ياسين؟
المعادلة الدولية
وشكّل التَّداخل الحاصل بين الواقع الاسرائيلي والنظام الدولي محفزاً لتفكير الشيخ واهتمامه، فتوجّه للرأي العام الدولي بالخطاب الإنساني مذكّراً إياه بالقرارات والمواثيق الدولية، التي أقرها هو، التي تحضّ على احترام حقوق الإنسان وفي مقدمها مقاومة الاحتلال وتقرير المصير.
فذكّر بحقيقة حال الفلسطيني قائلاً: “أنا الفلسطيني الذي قُتل أبوه وأخوه وأخته وأمه وأطفاله، أنا الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال”، واستنكر على الموقف الدولي الذي يصنّف الفلسطيني على أنَّه “ارهابي، والقاتل المحتل المستوطن الذي يشرّد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني والذي يحتل بيوت ملايين الفلسطينيين إنسان شريف وطيب”!!.
ثمّ اتّخذ موقفاً حاسماً من هذه المعايير الدولية الظالمة، باعتباره “اذا كانت المعادلة الدولية مقلوبة نحن لا نقبل المعادلات المقلوبة واطلاقاً”. ولكن في نفس الوقت رفض حرف المقاومة الفلسطينية عن مسارها، بهذه الذريعة، وأن تضيّع اتجاهها، لانّ “قضية فلسطين هي مشكلة شعب احتلّت أرضه ولاشأن له فيما عدا المحتلين الذين أخرجوه من أرضه”، فيكون الشيخ بذلك ركّز جهد المقاومين في مواجهة العدو المحتل، وأبقى مجال التّواصل وشرح حقيقة المظلمة الفلسطينية مفتوحاً مع الرأي العام الدولي، والجهات الرسميّة والشعبيّة ونخبه، صاحبة الوازع الإنساني الحي.
خاتمة
عاش الشيخ أحمد ياسين حياةً مفعمة بالمعاني الإنسانية، واستأنف منهج الدعاة إلى الله على بصيرة، وعدّ لمقاومة الظلم والعدوان عدتها الإجتماعية والفكرية والعسكرية، وحرّض أمته وشعبه للقيام بواجباتهم الوطنية والقومية، وحمى وحدة الصف الوطني، وعزز التمساك القومي.
وقارب إشكالية (السياسة والفتوى) بطريقة تفرد بها، وخاطب الغرب بالحق والمنطق وذكره بالتزاماته الإنسانية.
فتربع على كرسيه إماماً لأمته العربية والإسلامية، وقائداً وطنياً في شعبه الفلسطيني، ومؤسساً فذاً لحركته حماس.
فشكل في حياته تحدياّ، وباستشهاده استحقاقاّ برسم (أمته) و(شعبه) و(حركته)، فمن ينبري لهذه المهمة ويقول: أنا لها؟ سؤال ينتظره التغيير الكبير. يسالونك متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا.
بقلم: معين منّاع: باحث فلسطيني، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارت.
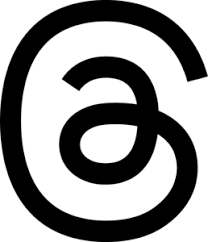

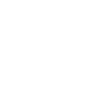
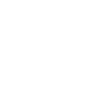
أضف ردا