الصفحات الأولى من “ورقة عمل: المواقف الغربية والدولية تجاه المقاومة الفلسطينية واتجاهاتها المستقبلية المحتملة … أ. د. مجدي حماد” (نسخة نصيّة HTML)
النص المعروض هو للصفحات الأولى من ورقة العمل … للاطلاع على ورقة العمل كاملةً اضغط هنا ![]() (21 صفحة، 722KB)
(21 صفحة، 722KB)
ورقة عمل: المواقف الغربية والدولية تجاه المقاومة الفلسطينية واتجاهاتها المستقبلية المحتملة [1] … أ. د. مجدي حماد [2]
لا شكّ في أن أيّ تطور جدي في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، بغض النظر عن الموقف من منهج التسوية، يتوقف على تغيير جوهري في “الطبيعة الاستيطانية” لتكوين “إسرائيل”. في ضوء ذلك؛ ليس من المرجح، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، وفي ضوء توازنات القوى، أن يأتي التغير في “الطبيعة الاستيطانية” تبعاً لتغير داخلي، إنما تبعاً لتغير “إقليمي” إلى حدّ ما، وتبعاً لتغير عالمي إلى حدّ كبير، على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا. أساس ذلك أن القوى الغربية الاستعمارية تشعر أن صيانة مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة العربية أصبحت تستلزم تحول دولة الاستعمار الاستيطاني إلى “دولة عادية”، وفقاً لما يمكن أن يطلق عليه اصطلاح: “الاستعمار الاستيطاني الحديث”، وخلع رداء الاستعمار الاستيطاني التقليدي عنها، بحيث يسهل في النهاية دمجها، ودمج المنطقة التي تسيطر عليها، في النظام الدولي الجديد للهيمنة. من هذا المنطلق يحدث اللقاء بين أهداف “إسرائيل” وأهداف الدول الغربية.
في هذا السياق ينبغي مناقشة أهمية الوضع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، بشكل عام، وتجاه المقاومة، بشكل خاص، مع تأكيد أنهما وجهان لعملة واحدة، وإن كان التناسب بينهما ليس طردياً في كل الأحوال، بخاصة مواقف كل من الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمم المتحدة. وسيجرى التركيز في المعالجة على جانبين: أولهما التفاعلات الدولية، بمعنى المواقف الدولية المتعددة في حال الحركة والتأثير والتأثر، وثانيهما المواقف الدولية، التي تعبر عنها كل دولة أو مجوعة من الدول.
أولاً: التفاعلات الدولية:
لم يكن ثمة فصم، صاحب مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي، بين أبرز مفاصل تلك المسيرة الممتدة على مدار أكثر من ستين عاماً، وبين المقاومة الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني، بل إن الأخيرة بدت تأصيلاً لرد فعل طبيعي، يجابه الجحافل الاستعمارية بشتى صنوف وأساليب المقاومة المتاحة. إن تقييم دور المقاومة في التأثير في معادلة الصراع، في ضوء معطيات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، يقتضي إدراج عدد من الملاحظات والمؤشرات:
1. أن خبرات التحرر الوطني، والنماذج التاريخية السابقة، تظهر أن الاختلال في التوازن القائم بين قوى الاستعمار وبين الشعوب المناضلة لمصلحة الأولى، لم يحل دون مآل المحصلة النهائية إلى مصلحة الشعوب التي ناضلت من أجل التحرر الوطني وتقرير المصير. كما تبين الخبرات التاريخية ذاتها أن الجيوب الاستيطانية الإحلالية التي قدر لها البقاء (مثل الولايات المتحدة وأستراليا)، نجحت بعد إبادتها السكان الأصليين، فيما أخفقت تجربة نظيرات لها في تحقيق ذلك، مثل جنوب إفريقيا، بفعل المقاومة التي واجهتها، ما أدى إلى تصفيتها.
لا تستثنى “إسرائيل” من هذه القاعدة التاريخية، باعتبارها جيباً استيطانياً إحلالياً. وقد تجلى ذلك بوضوح في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، كحرب سنة 1973، حين تمكن العرب من تحدي الخلل الفادح في التوازن السياسي والعسكري مع الجانب الإسرائيلي، بمجابهة عربية مشتركة. كما برز عبر نجاح المقاومة اللبنانية في دحر الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بانسحاب منفرد من دون قيد أو شرط سنة 2000، مثلما تجسد في صمود المقاومة اللبنانية أمام ترسانة الحرب الأمريكية – الإسرائيلية سنة 2006.
كما يتضح على الجبهة الفلسطينية من خلال ما حققته انتفاضة الأقصى من إنجازات، لم تتمكن “عملية التسوية” من إحرازها طوال مسيرتها التي ابتدأت في مؤتمر مدريد سنة 1991، وأيضاً عبر نجاحها في حمل المحتل الإسرائيلي على الانسحاب من قطاع غزة في سنة 2005، على الرغم من أن الانسحاب كان صورياً؛ حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحكم سيطرتها على القطاع، الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبار خطوة الانسحاب محاولة تكتيكية إسرائيلية بغية إحكام السيطرة على أراضي الضفة الغربية، التي تشكل بالنسبة إليها أهمية تفوق بكثير تلك التي يحتلها القطاع، وذلك استناداً إلى المعايير العسكرية، وموازين القوى الداخلية، والمصالح المتأتية وحجم المقاومة، وليس إلى المزاعم التوراتية.
إلى جانب الانتصارات البطولية التي حققتها المقاومة الفلسطينية في “معارك غزة” المتوالية منذ سنة 2008. بيد أن ذلك كله من شأنه أن يدلل على حقيقة أن المقاومة، التي ترفع رايات حقّ تقرير المصير، وتلجأ إلى صنوف مختلفة من النضال، باستطاعتها أن توقع خسائر ضخمة في صفوف العدو وفي جيشه النظامي، ما يلقى بتأثيراته المؤكدة على المواقف الدولية.
2. أن النموذج العام لتطور حركات التحرر الوطني يؤشر إلى نجاحها في تحقيق هدف الاستقلال السياسي نتيجة نضالها، سواء أكان ذلك من خلال تسوية مع الدول المستعمرة، حينما تدرك الأخيرة تآكل مشروعها الاستعماري، وعدم جدوى استمراريته، بفعل الخسائر الفادحة التي يتكبدها من المقاومة، أم عن طريق الكفاح المسلح ضدّها في أغلب الأحيان. ويعدّ نضال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، في سبيل مباشرة حقها في تقرير المصير، نضالاً مشروعاً يتفق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي من أبرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1965، والقرار 2625 في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1974.
بيد أن “إسرائيل” تتجاهل حقّ تقرير المصير، وحقّ المقاومة في النضال من أجل التحرر، مستندة في ذلك إلى ادعاءات تاريخية أسطورية، ترتكز على ما يسمى “النزعة التاريخية”؛ القائمة على الزعم بحتمية حدوث تطورات ومراحل معينة، وبمسار محتوم للتاريخ يمكن التنبؤ به مسبقاً، وهي رؤية تندرج في المجتمع الإسرائيلي المغلق. وتواري “إسرائيل” نزعة إنكار حقّ أهل البلاد الأصليين في تقرير مصيرهم، عن طريق تحويل نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر إلى مجرد “نزاع في الشرق الأوسط”، لا يحل عن طريق الاعتراف بحقّ تقرير المصير للفلسطينيين، بل من خلال الموافقة على “شروط السلام”.
وفي ظلّ غياب لغة العدل وسيادة المعايير المزدوجة، فإن إملاء الطرف الأقوى هو الذي يضبط حل هذا الصراع، كما يغلب عنصر القوة في المفاوضات، التي يكون هدفها في المحصلة كبت إرادة الأمة نحو التحرر من الاحتلال.
إن دوافع اللجوء إلى الكفاح المسلح والمقاومة لا يسهل فهمها بمعزل عن سياق الصراع، وفشل مسار التسوية، وتنامي نزعة التطرف والعنف اليميني الديني في “إسرائيل”. فقد أدت الممارسات العدوانية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً، والتي تستند إلى مفاهيم القوة والعنف باعتبارها سبيلاً لفرض الأمر الواقع، إلى نسف “عملية السلام” التي تعاني أصلاً من وهن وهشاشة الركائز المستندة إليها، ما أسفر عن تعثر مسيرتها إلى حدّ الجمود على الصعيد الفلسطيني، بينما اقتصر تداول مصطلحاتها على المستوى الرسمي لدى الدول التي أبرمت معاهدات مع “إسرائيل”. بخلاف الإنجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حروبها الإقليمية منذ سنة 1948، فإنها فشلت في تحقيق أيّ من أهدافها في التعامل مع لبنان وفلسطين أمام المقاومة.
3. إن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” لا يخرج عن المسار ذاته، على الرغم من تواتر إخفاق محاولاته السابقة، التي كان آخرها مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي أعلنته الولايات المتحدة بهدف تحقيق ثالوث “الإصلاح”: الديمقراطية، والمعرفة، والازدهار الاقتصادي في المنطقة، باعتبار أن أوضاعها السياسية والاجتماعية المتدهورة تشكل، وفقاً لمنظورها، مرتعاً خصباً لنمو التطرف و”الإرهاب”، وهو المسوغ الذي اتخذته واشنطن ذريعة للتدخل في شؤون المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب، بخاصة بعد إحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 التي كان من أبرز تجلياتها مرادفة المقاومة بـ”الإرهاب”.
وقد عمدت الإدارة الأمريكية، بغرض تنفيذ مخططاتها في المنطقة، إلى الضغط على حكومات دولها لإحداث إصلاح في النظام التعليمي، والسياسي لديها، بما يسهم في إشاعة مفاهيم الحريات والديمقراطية، ويفسح المجال أمام توسيع المشاركة السياسية فيها.
بيد أن عدم تقبل منظومة النسيج العربي المجتمعي السياسي والمدني، وتنبهها لمكامن ومقاصد هذا المشروع، ومن جراء الفشل الذريع للمشروع الأمريكي في العراق، أدى إلى التسبب في عرقلة تنفيذه حتى الآن، ما دفع واشنطن إلى إعادة صياغة إطاره مجدداً بما يتواكب مع مصلحتها في المنطقة، وبما يأخذ في الاعتبار تطورات الأحداث، بهدف القضاء على البنية التحتية للمقاومة الإسلامية، وبالتالي، طمس مفاهيم الكفاح المسلح، واستئصال ثقافة المقاومة، وإقحام الجسم الإسرائيلي الغريب في هيكلية الدول العربية والإسلامية، توطئة لتبوئه سدّة الزعامة في المنطقة.
4. أن هذا المقصد الأمريكي لا يُعدّ جديداً؛ إذ أنه يندرج في جزء منه ضمن إطار الاهتمام المبكر بالحركات الإسلامية وبالمقاومة، تكثف منذ ما بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، حيث نشطت حينها مراكز الدراسات والأبحاث الغربية، المرتبطة بمراكز صنع القرار، لتشخيص ودراسة دوافع المقاومة والحركات الإسلامية وتطورها في المنطقة، وحجم قاعدتها الجماهيرية، ومدى تأثيرها في وضعية المنظومة المجتمعية البنيوية المتكاملة، ومن بينها دراسة رائدة أصدرتها مؤسسة “كارنيجي” البحثية، التي خلصت إلى تنامي دور حركات المقاومة الإسلامية خلال السنوات العشر الأخيرة، بحيث باتت تلعب دوراً سياسياً أساسياً ومهماً في المنطقة. في حين توقعت دراسات أخرى حدوث استقطاب ثنائي في حركة العلاقات الدولية، بخاصة على صعيد الساحة السياسية العربية بين الأنظمة والتيارات المختلفة للإسلام السياسي.
وقد نظرت الحكومات الأمريكية والغربية بعين القلق والتوجس إلى تنامي نفوذ التيار الإسلامي، فضلاً عن تداعيات الثورة الإسلامية في إيران، من خلال تصاعد دور حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، والتطورات المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين في مصر، عدا عن تصاعد دور حزب الله في لبنان وسورية، والعجز الأمريكي الإسرائيلي عن إلحاق الهزيمة به، إضافة إلى العجز الأمريكي العام في المنطقة، حيث شكل كل ذلك محركاً مهماً من دوافع المساعي الأمريكية لضرب البنية التحتية للمقاومة، بخاصة في فلسطين ولبنان.
[1] قدم أ. د. مجدي حماد هذه الورقة في مؤتمر “مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضوء الحرب على قطاع غزة في صيف 2014″، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت في 27/11/2014.
[2] أستاذ العلوم السياسية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية.
النص المعروض هو للصفحات الأولى من ورقة العمل … للاطلاع على ورقة العمل كاملةً اضغط هنا ![]() (21 صفحة، 722KB)
(21 صفحة، 722KB)
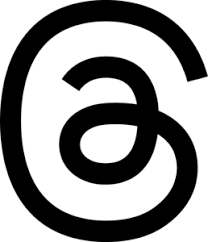

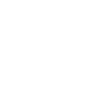
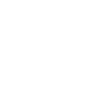
أضف ردا