تقدير استراتيجي (48) – أيلول/ سبتمبر 2012.
ملخص:
يشكل ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر حكومة سلام فياض في دفع الرواتب فتيل الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ثورة الشارع في الضفة الغربية؛ والذي طالب بحل الحكومة وإقالة رئيسها، كما ظهرت مطالبات أخرى دعت إلى إلغاء أو تعديل “بروتوكول باريس”.
غير أن أزمة السلطة الفلسطينية المالية أعمق وأخطرمن ذلك بكثير، إذ تظهر في خمسة مستويات، هي:
1. أزمة خسارة سنوية في الناتج المحلي.
2. أزمة مديونية متراكمة مع فوائدها
3. أزمة العجز الجاري في موازنة السلطة.
4.“الأزمة بالعدوى”؛ فما يصيب الاقتصاد الإسرائيلي، ينسحب على الاقتصاد الفلسطيني.
5. “الأزمة الاحتياط”، المتأتية عن تحكَّم “إسرائيل” بالاقتصاد الفلسطيني.
جاءت المعالجات على شكل إجراءات تكتيكية تهدف إلى الحيلولة دون انفجار الأزمة، وانهيار السلطة، لتداوي بعض أعراض الأزمة، مع إبقاء جوهرها المتمثل في الاحتلال وسياساته، وهو ما يعني أن الأزمة ستعود للانفجار إن عاجلاً أو آجلاً.
ماذا حدث؟
شهدت الضفة الغربية احتجاجات شعبية واسعة بسبب الأزمة لاقتصادية، التي كان من مظاهرها تأخر حكومة سلام فياض في صرف الرواتب، وارتفاع أسعار المحروقات. وقد حاول البعض تحميل بروتوكول باريس الذي عقدته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال سنة 1994 مسؤولية الأزمة، مما يعني أن الاحتلال هو نبع أزمات كان ارتفاع الأسعار أبسطها. أما الأزمة الأعمق، فهي أزمة المالية العامة التي لم يحس المواطن بها، لأن السلطة وفَّرت مسكنات لها وحولتها قنبلة مؤجلة، مع أنها سبب الحديث عن “أزمة غير مسبوقة”، في وقت لم تكن الأسعار قد ارتفعت فيه بعد.
والحال هذه، بدا تأخر الحكومة في دفع راتب شهر واحد، غير كافٍ لوصف الأزمة بغير المسبوقة، لأنها مسبوقة، بدليل أن تأخر دفع الرواتب كان قد تكرر سابقاً أكثر من مرّة، ولأزيد من شهر واحد، مما يسمح بالحديث عن غير أزمة تراكمية، استحقت وصف غير المسبوقة. وعليه، يصير السؤال: إذا لم تعد الأزمة تقتصر على تأخر الرواتب أو ارتفاع الأسعار، على أهمية ذلك، فما طبيعتها وما حجمها وحلولها الممكنة؟
ليس ما شهدناه خلال شهري آب وأيلول 2012، إلا تكراراً لما صار في شهري آب وأيلول 2011 من حصار مالي قبل الذهاب للأمم المتحدة وبعده، مما أوجد حصاراً فعجزاً في الميزانية. حاول فياض تعويض ذلك جزئياً من خلال سياسة ضريبية وتقشفية، قُرِعت لها الطناجر احتجاجاً وتوحد الجميع ضدها فسقطت.
كانت أزمة 2012 تكراراً لأزمة شبيهة ترافقت مع الذهاب للأمم المتحدة عام 2011! أما الفرق بينهما فهو أن احتجاج 2011 كان موجهاً ضد السلطة، التي تراجعت فهدأت الطناجر والحناجر، بينما كانت أزمة 2012 مستوردة من “إسرائيل”، التي لو نوت التراجع لفعلته أمام احتجاج مواطنيها على ارتفاع الأسعار.
أزمة متجددة:
ثمة “غير مسبوق” آخر سنة 2012 بالقياس لسنة 2011، هو أن السلطة الفلسطينية حين جفت بعض مواردها أواخر 2011، اضطرت إلى مزيد من الاستدانة من البنوك والقطاع الخاص! إذاً، ثمة فارق نوعي هو تآكل قدرة السلطة الفلسطينية عام 2012 على الاستدانة، قياساً بوضعها الائتماني عام 2011.
مارست السلطة سياسة “لحس المبرد”، خلال السنوات القليلة المنصرمة، لأن توازن ماليتها كان يقوم على وعود المانحين، وحين يقصّر هؤلاء كانت تلجأ إلى الاستدانة مؤقتاً من البنوك بغطاء الأموال المنتظرة من المانحين، التي حين لم تصل أصبحت ديون السلطة دائمة، وهو ما يعني كلفة إضافية تتمثل بالفوائد المركبة عليها.
إن تدني صدقية الدول المانحة تجاه السلطة، يعني تدنياً موازياً في صدقية السلطة وتآكل قدرتها على الاستدانة بضمانة أموال المانحين. من جانب آخر، حتى ولو أبدت البنوك تفهماً لظروف السلطة، لكن ثمة معايير فنية لا مجال لتجاهلها، ناهيك عن أن قدرات البنوك المحلية لا تسمح لها بتلبية كل طلبات السلطة.
حين يتم الحديث عن أزمة مالية غير مسبوقة، لا نكون أمام أزمة تخص 2012 حصراً، بل أزمات مرحَّلة تراكمياً منذ 2008 وصولاً لسنة 2012، التي بدأت مع دين يبلغ 1.5 مليار دولار، وفق أرقام رئيس الوزراء، و2.2 مليار وفق معطيات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار”. وبذلك، يمكن الحديث عن مديونية في سنة 2012 تتراوح من 2.5 – 3 مليارات دولار، باعتبار أن العجز المتوقع يبلغ حوالي مليار دولار وفق تقديرات فياض.
هذا الواقع هو من طبيعة تراكمية سلبية، لأن اضطراب المالية العامة والعيش تحت شعور أن السلطة مُفلسة، لابد وأن يؤثر سلباً في كل اتجاه، بدءاً من خفض الائتمان والأمان إلى تدني الإنتاجية والصدقية. نختم النقطة بالقول إن وضعية الإفلاس المالي أكثر بنيوية من رفع الأسعار، الذي سنعود إليه، بعد كشف كارثة اقتصادية أخرى، لولاها لما كانت أزمة مالية أو حاجة لأموال مانحين أو دين أو رفع أسعار بالعدوى.
تحت قرع الطناجر بداية 2012، وزمامير السيارات في أيلول/ سبتمبر 2012 بسبب سعر الوقود، طُمِست كارثة حقيقية هي أزمة المالية العامة، التي يخطط خارجياً أن تؤول إلى إفلاس مالي فإفلاس سياسي، هي حصيلة كارثة أكبر، عنينا الأثر الاقتصادي التراكمي السلبي منذ 1967 للاحتلال، الذي نجح في إحلال سبب زائف للأزمة المالية ونتيجة زائفة للاحتلال، بدلاً من السبب الحقيقي للأزمة والنتيجة الحقيقية للاحتلال.
تتطرق التعليقات حول الأزمة عادة إلى أمور ثانوية، من نوع سوء تطبيق الاتفاقات الاقتصادية مع الاحتلال، دون التطرق لأثر الاحتلال نفسه، أو سبب حاجة السلطة للمساعدة، ربطاً بأن ضآلة حجم الناتج الفلسطيني لا يسمح باقتطاع ضريبي يتناسب ونفقات السلطة. نشير هنا إلى إلصاق البعض صفة “الشِحدة” بالفلسطينيين، ناسياً أنه ما كانت لتكون شِحدة فلسطينية لولا سرقة إسرائيلية للموارد الفلسطينية.
الكلفة التي يدفعها الاقتصاد الفلسطيني سنوياً جراء الاحتلال:
ثمة رقم متداول يقول أن خسارة الاقتصاد الفلسطيني سنوياً بسبب الاحتلال، تبلغ 6.8 مليارات دولار، أي أكبر من الناتج المحلي سنة 2012، المقدَّر بحوالي 6 مليارات، أي أنه مقابل كل قرش ينتجه الفلسطيني يخسر ما يساويه جراء الاحتلال. إن توفير الناتج المحلي المهدور، يعني توفير دخل وطني مساوٍ تقريباً، مما يعني أيضاً توفير ضريبة دخل للسلطة تبلغ حوالي مليار دولار سنوياً، تعادل المساعدات الخارجية الموعودة.
يمكن لأي كان أن يقدر كما يشاء حجم خسارة الاقتصاد الفلسطيني سنوياً، لكن صحة التقدير هي من صحة المعيار الذي استُخرجت بناء عليه الخسارة، مما يقتضي استخراج الرقم الافتراضي الصحيح للناتج الفلسطيني، وبناءً عليه يمكن استخراج الفرق بينه وبين الناتج الفعلي، فنكون أمام تقدير الخسارة السنوية.
ثمة قاعدة منهجية هي أخذ عدد السكان أساساً لتقويم الناتج المحلي لبلد ما مقارنة بـ”إسرائيل” مثلاً، التي بلغ عدد سكانها عام 2011 نحو 7.8 ملايين نسمة، مع ناتج محلي يتجاوز 244 مليار دولار. لو تعادلت الإنتاجيتان الفلسطينية والإسرائيلية، فإن 4.17 مليون فلسطيني، يساوون 53.2% من سكان “إسرائيل”؛ يجب أن ينتجوا 130 مليار دولار، التي هي قيمة 53.2% من ناتج “إسرائيل”، لأن الضفة وغزة مدارة منذ 45 سنة من قبلها، مما يفترض تقارب إنتاجية كل منهما لو تعرضتا للتطور الإيجابي نفسه.
بناء عليه، يمكن القول إن الناتج المحلي الفلسطيني الافتراضي يبلغ 130 مليار دولار، أي 22 ضعف الناتج المحلي الواقعي البالغ حوالي ستة مليارات، أي 4.6% من حجمه الافتراضي. يعني ما تقدم أن خسارة الناتج المحلي الفلسطيني، نتيجة تدني الإنتاجية، تعادل 124 مليار دولار سنوياً.
كي نتلافى اختلاف شروط الإنتاج في “إسرائيل”، وافتراض صعوبة توفرها للفلسطينيين، نسوق مثلاً ثانياً هو لبنان مع عدد سكان شبيه بعدد سكان أراضي السلطة، وناتج محلي يبلغ حوالي 45 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف الناتج الفلسطيني، الذي يحقق خسارة سنوية تُقدَّر والحال هذه بحوالي 40 مليار دولار.
الأزمات الخمس للاقتصاد الفلسطيني:
إذاً، نحن أمام خمسة مستويات للأزمة مرتبة حسب خطورتها؛ أولاً: أزمة بنيوية تترتب عليها خسارة سنوية في الناتج المحلي. ثانياً: أزمة مديونية متراكمة مع فوائدها. ثالثاً: أزمة العجز الجاري في موازنة السلطة. رابعاً: “الأزمة بالعدوى”؛ أي أن كل تغير سلبي يصيب الاقتصاد الإسرائيلي ينعكس على الفلسطيني. خامساً: “الأزمة الاحتياط”، المتأتية عن تحكَّم “إسرائيل” بصنابير الاقتصاد الفلسطيني ليخدم سياستها العليا.
يقع ما جرى أخيراً في نطاق الأزمتين الأخف؛ العجز الجاري والأزمة بالعدوى، أي ارتفاع الأسعار، مما طمس الكارثتين البنيويتين الأهم؛ وهما تدني الإنتاجية وضآلة حجم الناتج المحلي، وضخامة المديونية العامة.
إذاً، تركزت الأنظار حول أزمة ارتفاع الأسعار، وبشكل أدق، أسعار الوقود، فضلاً عن نفس السلع الكمالية التي رفعت “إسرائيل” أسعارها لتمويل بعض نفقاتها المستجدة، دون أن تمد يدها أبداً لمصروفات الأمن والاستيطان، أو تمس لقمة الفئات الأقل حظاً، لأنها غير معنية بأسعار البنزين والسيارات والسلع الكمالية.
يفسر ما تقدم محدودية عدد المشاركين في الاحتجاجات الإسرائيلية، والمـُقدَّر ببضعة آلاف، كمِثل الفلسطينيين، حيث الدور البارز لأصحاب سيارات الأجرة، والحافز السياسي لبعض المحتجين، الذين رأوها مناسبة لتصفية الحساب مع فياض، لكن البوصلة عادت إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو “بروتوكول باريس”، الذي ربط مستويات أسعار السلع عموماً، والوقود خصوصاً، في أراضي السلطة مع مثيلتها في “إسرائيل”.
الإجماع الوطني الفلسطيني الذي كاد يتشكل:
بدت الأمور للحظة وكأن أزمة الأسعار تفتح باب “بروتوكول باريس”، بدليل طلب السلطة من “إسرائيل” إعادة البحث فيه، مما فتح الباب واسعاً على أن الاحتلال هو سبب الأزمة الاقتصادية البنيوية، ليس على ما يقول معارضو السلطة فقط، بل على ما تقوله أيضاً النخبة الاقتصادية للسلطة ممثلة بالدكاترة: فياض رئيس مجلس الوزراء، ومحمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي “بكدار”؛ ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار.
في لحظة تاريخية مشرقة، كاد أن يتشكل إجماع وطني فلسطيني يضع المسألة برمتها ومن جذورها على بساط البحث. غير أن البعض أدرك دقة اللحظة، وأن الغيوم التي تتجمع في الأفق لن تمطر ركوعاً سياسياً، بل قد تطلق عاصفة كرامة وطنية ونهوضاً عارماً مجيداً، ما دفعه للملمة الوضع من خلال تدابير صارت معروفة!
أصبح ممكناً خلال أيام ما كان قبل شهور مستحيلاً، فانفتحت الأبواب الموصدة!
تقول جريدة “الحياة” الصادرة في 13/9/2012: “تبدي “إسرائيل” قلقاً شديداً من تطور الأزمة المالية للسلطة إلى حد انهيارها أو لجوئها إلى تحركات أحادية، أو اندلاع انتفاضة ثالثة، أو حصول فوضى. بسبب هذه المخاوف، توجهت بطلب عاجل إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى السلطة لإنقاذها من الانهيار”!
إذاً، تؤكد الوقائع ثانية أن لدى “إسرائيل” قرار فتح وإغلاق صنابير المساعدات الخارجية على السلطة، لمنع الانفجار وليس لحل المشكلة، أي تقديم مُسكِّن لمشكلة جارية وترك أربعة مشاكل بنيوية قاتلة عالقة.
كانت التجربة الأخيرة فرصة باهرة لتظهير المشكلة، مما يقتضي من النخبة الاقتصادية الفلسطينية استثمارها فكرياً باتجاه تشكيل رؤية تحظى بإجماع وطني يدعو إلى مسار سياسي جديد، هو وضع إنهاء الاحتلال عنواناً وحيداً للحل. غير ذلك، ليس إلا “لحس المبرد” والعيش المؤقت بانتظار الانهيار والانفجار.
السيناريو المحتمل:
في ختام هذا التقدير، وكمحاولة منا لاستشراف وتوقع السيناريوهات المحتملة، نشير إلى التوقعات التالية:
– إن رد الفعل الطبيعي للسلطة الفلسطينية وأطراف الرباعية، عجماً وعرباً، محاولة الحؤول دون انفجار الأزمة من خلال إجراءات تكتيكية تسكينية، تعالج العرَض دون مداواة المـرَض، وهو ما ضمَّناه في عنوان التقدير: مداواة العرَض وإبقاء المرَض! تقاطعت مختلف الأطراف على ضرورة الإسعاف، لكن ماذا عن المرض نفسه والمتمثل بأكثر من مستوى للأزمة الاقتصادية الفلسطينية؟ بما في ذلك شبه إفلاس المالية العامة، وتدني إنتاجية المجتمع على نحو باهظ جداً كما بينّا.
– على خلاف المرات السابقة، بدأ يتشكل إجماع فلسطيني، بما في ذلك رجالات السلطة، والنخبة الاقتصادية الرسمية، ممثلة بالدكاترة فياض واشتية ومصطفى، على أن سبب الأزمة سياسي، مع ما يقوده ذلك من إحالات على بروتوكول باريس، فاتفاق أوسلو، فالاحتلال. وكان مترتبات ذلك بدء الحديث عن إلغاء بروتوكول باريس أو تعديله، وصولاً إلى أتفاق أوسلو، وما راج أخيراً عن تفكير السلطة بإلغائه.
– يقتضي ذلك توفير الاشتراطات الواجبة من خلال بلورة “رؤية – سياسة إلغاء أوسلو”، وما تحتاج إليه هذه الخطوة بالغة الأهمية، التي ترتقي إلى حدِّ إعادة تصحيح التاريخ، من توليد إجماع وطني حولها، بوصفها قضية وطنية من طبيعة وجودية. إذا ما امتلك الفلسطينيون سلاح الموقف هذا، فإن المترتبات العملية تبقى ممكنة، خصوصاً وأن الفلسطينيين لا يستعيدون بذلك وحدتهم الداخلية فقط، بل أيضاً وضعيتهم الطبيعية وقرارهم في تحديد ماذا يريدون من الآخرين، بدل ترك الآخرين يقررون للفلسطينيين أن لا يفعلوا شيئاً إلاّ ضمن سقف الرباعية الذي هو ضمن السقف الأمريكي، الذي كان دائماً متطابقاً مع ما تريده “إسرائيل”.
المقترحات:
حين نشدد على توليد رؤية محل إجماع وطني على سياسة خروج من أوسلو، فإن ذلك يقتضي حسم أربعة مسائل متلازمة بحيث تصبح محل إجماع، وهي:
1. أن الوضع القائم هو إنهاء متدرج ومتسارع لما تبقى من أرض الضفة والقدس.
2. استحالة حمل أعباء المرحلة التاريخية الراهنة ومسؤولية إلغاء أوسلو إلا من خلال إجماع وطني فلسطيني.
3. وجود سياسة حل، بمعنى الربط المحكم بين الرؤية – القناعة بقرار الإلغاء، وآليات التنفيذ وإمكاناته.
4. توفر إرادة سياسية وإدراك عميق يصل حدَّ اليقين، بضرورة مغادرة موقع المتلقي إلى موقع المبادر، ليس فيما يخص الأعداء بل الأصدقاء أيضاً، الذين آن لهم أن يعطوا فلسطين حسب حاجتها وكحق لها، لا أن يأخذوا منها بالسياسة ما يعطونه لها بالمال، الذي يبدو “مِنةً” منهم عليها. أي أن تقرر فلسطين ما تريده منهم لا أن يقرروا هم لها، وأن تكون وظيفتهم خدمة فلسطين لا أن تكون في خدمتهم!
* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور حسين أبو النمل بخالص الشكر على كتابته النص الأساسي الذي اعتمد عليه هذا التقدير.
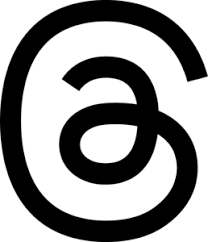

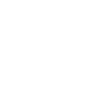
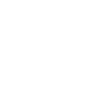
أضف ردا